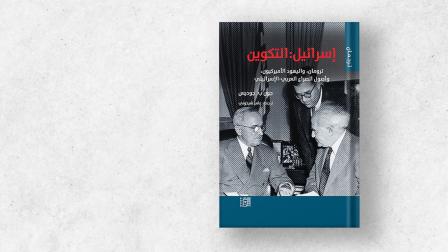استمع إلى الملخص
- **الحياة اليومية في المخيمات:** سكان غزة يعيشون في حالة ترقب دائم منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر، يقضون وقتهم في طوابير لتعبئة المياه المالحة ويتأقلمون مع الحياة في الخيام التي تفتقر للخصوصية والأمان.
- **التأقلم والأمل في ظل الحرب:** سكان غزة تأقلموا على واقع مرير، حيث انتشرت بسطات المعلبات والمساعدات الغذائية، وأونروا كانت العمود الفقري لإغاثة النازحين. الأخبار عن الهدنة تثير الأمل، لكن الحرب شملت الضفة الغربية أيضاً.
رغد فتاةٌ جميلة الملامح تبلغ من العمر أربعة عشر عاماً، تقف في طابورٍ من الفتيات، حاملة بيدها آنية لتعبئة الطعام، الذي يطبخه عمال "التكية" في مخيم للاجئين. لم تعتد رغد أن تذهب إلى هناك، إلا أن أخاها الأصغر ذهَب مع والده لإحضار كابونة من مقر فرعي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين المعروفة بـ "أونروا"، والآخرون مشغولون في بيع بعض المعلبات وأكياس الأندومي وعصائر. في لحظةٍ مباغتة، فُتح باب المطبخ وتدافع الجمع، ليأخذوا وجبتهم المطبوخة من المعلبات أو المعكرونة أو العدس، أرادت رغد أن تكون في طابور منتظم، لكن في تدافعٍ كهذا لا يمكن ذلك، وفي لحظة أخرى توقفت، وأزيح جسدها إلى خارج الطابور، أغمضت عينيها، تفجرت دمعة، أحسّت بفداحة خطأها بوقوفها في الطابور منذ البداية، ورجعت إلى خيمة عائلتها.
مطأطئة رأسها، وعلامات الحسرة بائنةٌ على وجهها، نظرت إليها أمها قائلة: ما بك يا رغد، وأين الطعام؟ أجابت بصوت متحشرج: لم آتِ بشيء، لكني امتلكت شيئاً آخر أهمّ من الطعام؟ أشارت أمها بيدها بحركةٍ كمن يفتح صنبور ماء، أجابتها رغد: عدتُ ومعي كرامتي.
لعل هذا المشهد المتكرّر يختزل شيئاً من معاناة الشعب الفلسطيني في غزّة، الذي يعاني من حربٍ أكلت الأخضر واليابس، وسرقت أحلام مليوني نسمة من سكان قطاع غزّة، وأزهقت أرواح الأكرم منا جميعاً، هو مشهد يلوّح بالمعضلة الرئيسية بيننا نحن الفلسطينيين وبين الكيان الصهيوني، فلولا الكرامة لما صار الصراع منذ عشرات السنين، ولما حدث ما حدث، ولكان يمكن حل القضية بما يسمى "السلام الاقتصادي" وانتهى إلى تعايش مذل بين الجلّاد والضحية.
■ ■ ■
الناس في غزة لم يذوقوا طعم النوم المعتاد منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، في غزة حال الترقب هو الحال العام في خلد كل غزّي، ترقب منذ الاستيقاظ من النوم المتقطع، يبدأ هذا الترقب على صوت بائع المياه: (ميه حلواااااا) بمدّ الكلمة بشكل متعمدٍ مع نداء صارخ، غير آبه لقربه من خيم النازحين أو بعده عنها، ينفجر صوته، فيهرع أحد النائمين المكلفين ملء غالون ماء للشرب ليوم واحد، وتكلفته أربعة شواقل، ينتهي ترقب أول ليظهر ترقب آخر بالانتظار في طابور لتعبئة المياه المالحة وتستعمل لحاجيات كثيرة إلا شربها. طابورٌ طويل كأن الواقف يمشي كسلحفاة، وعليه الانتظار فقط.
يمارس الناس في الصباح عادة لم تكن منتشرة قبل الحرب، فتحية الصباح مثلاً كانت مقتصرة على المعارف والأصدقاء أو زملاء العمل، أما في المخيم، فالتحية واجبة، ليس لأنها نوع من أنواع البرستيج، بل لكونها مادة حياة، وتبثّ بعض الأمل في شيء لا يعرفون متى سيأتي، وتختلف وتتعدد الصباحات من جمع لجمع، فهناك من يقولها: "صباح الخير" وآخر "يسعد صباحك" وآخر "ع العافية" وهكذا...
وجود إنسان في خيمة، فهذا يعني الكثير، الكثير المرهق المثقل المتزامن مع أعباء الحرب
هل نحن هنا حقاً؟ هل ما حدث هو حقيقة أم مجرد فيلم أكشن؟ كيف يحدث هذا في عام 2023 وما زال مستمراً في عام 2024؟ وهل يستحق ما حدث في السابع من أكتوبر أن يحدث ما بعده؟
أسئلة تتدافعها ألسن الناس بعد التخفف من أعباء اليوم المرهق جسدياً ونفسياً، فحياة الغزّي في الحرب مثقلة بأعباء جمّة، ما بين تأمين احتياجات اليوم وما بين التخطيط لاحتياجات اليوم التالي، والمفارقة أن لا أحد يضمن أن يعيش ليوم تالٍ!
إلى أين؟ سؤال يطرح مرّات عديدة على مسامع اللاجئ، والإجابة متعددة، لكنها تصبّ في حياة اللّاجئ، إلى مندوب الوكالة، إلى "التكية"، إلى شحن الجوالات، إلى السوق، إلى.. إلخ، أصبحت الـ"إلى" تعني الجري وراء أي شيء يعين اللّاجئ الذي ما زال حيًّا منذ أشهر طوال، ولم يدخل جيبه شيء من المال، لقد تُرك وحيداً دون معين، تعصره الأيام والليالي عصراً دون رحمة.
لم نكن نرى قبل الحرب عجوزاً تحمل غالوناً وتقف في طابور المياه، بات كل إنسان يحمل غالوناً واقفاً في دوره في الطابور، وكأن حياة الغزّي أصبحت عبارة عن طوابير تتفنن في إرهاقه الجسدي والنفسي.
■ ■ ■
أجلس خارج الخيمة التي تتحول إلى جهنم مصغرة عندما تلوّح حرارة الجو بالارتفاع، مستظلاً بمكان لا يكفي جسدي الضئيل، ممسكاً بكتاب، أمارس معه حياة القراءة، ينظر الناس إليّ، منقسمين إلى فريقين: فريق مستغرب وكأنه يقول: أهو وقته في ظلّ الموت أن تقرأ؟ وفريق آخر يستغرب بطريقة أخرى بالقول بصوت مسموع: يبدو أنك بعت الدنيا، واشتريت عقلك! وبين هذا وذاك، أعترفُ بأن القراءة في فوهة الموت فعل حياة وأمل وهروب مستحب؛ فعل حياة، لأنه يحاول مساعدة النفس في تمضية وقت مفيد، ويحرك العقل الذي أثقلته الواجبات، وفعل أمل لأنني به أحسّ أنني ما زلت حيّاً، وأما فعل الهروب، فإنني أهرب مما أرى من تهافت الناس إلى سد احتياجاتهم بأية طريقة، مشروعة أو غير مشروعة، وهذا يضع علامة استفهام كبرى عما وصل إليه الحال منذ بدء الحرب على غزة، الحرب التي بعثرت حياتها وصرنا أسارى للترقب وكثير من المنغصات المعتادة والمفاجئة والمستحدثة!
بين البيت والخيمة.. صراع وجودي. وجود الإنسان في بيت يعني الأمان بالدرجة الأولى، جدران ومساحة رحبة، ومناظر جميلة، طريق ممهد، وغيرها من مميزات مسمى "البيت".
وأما وجود إنسان في خيمة، فهذا يعني الكثير، وليس معنى "الكثير" أنه الكثير من المميزات، بل هو الكثير المرهق المثقل المتزامن مع أعباء الحرب، أن يلف النايلون مكاناً لتربية الدواجن أو المنتجات الزراعية، فهذا أمر تتطلبه الزراعة مثلاً، لكن أن يكون من بداخل النايلون أناس، فهذا يعني أن الحالة أبشع من أن توصف، خيمة يلفها النايلون شتاءً وصيفاً! فضلاً عن انعدام الخصوصية، فيحسّ النازح أنه يتحدث في مايكروفون، فهو واقعياً يتحدث في العراء، لا حاجز للصوت سوى نايلون! ولا مسافة بين كل خيمة وخيمة إلا متران على أقصى تقدير، وهناك مسافة تصل إلى متر، لم تعد المناطق المسماة "آمنة" تتسع لأعداد ضخمة، أين يذهب الناس! وهل ينتهي الأمر عند هذا الحد؟ لا بالطبع، فمنذ أيام قصف مكان تجمع اللاجئين في منطقة "البركسات" في مدينة رفح، لم تقصف مبانٍ أو حوائط، قصف بشر يسكنون الخيام! صواريخ أميركية التهمت لحم النازحين، وهتكت ستر الصمت ليلاً، فأحالت المنطقة إلى نار ملتهبة!
يجلس يوسف وهو شاب يحكّ أظفاره بأسنانه، يفكر في الذهاب إلى بيتهم الذي قصف مرتين، لكنه ما زال واقفاً، يفكر في الذهاب للاطمئنان إلى محتوياته، ضوء يشجعه على زيارته، فحجز مقعداً في سيارة نقل لتقله إلى بيتهم، فيما عتمة تحاصره بظنون الخطر، وغلبة الوضع الأمني الصعب، وما يمكن أن يحدث من مفاجآت غير سارة. يمكن أن يدفع حياته وبيته ثمناً لزيارة عابرة لبيتهم.
التأقلم، حاجة ملحّة أم إبداع طارئ؟
■ ■ ■
منذ بداية الحرب، وتحديداً بعد هدنة الأسبوع، لم يكن أمام الناس إلا التأقلم على واقع مرير، لمقتضيات العيش، كان هذا الأمر بديهياً، فغريزة البقاء هي الغريزة الأقوى لدى الإنسان العادي، فما بالكم بإنسان يتعرّض لأبشع أنواع التقتيل والتنكيل؟ بدأت بسطات المعلبات والبسكوتات تنتشر في الشوارع، وبسطات الفلافل ومختلف المُنتَجات التي أساسها المساعدات الغذائية عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، وخلال تدفق المساعدات، كانت "أونروا" العمود الفقري لإغاثة النازحين، لكل شخص متزوج موجود في قطاع غزة، وهذا استدعى تقسيم العمل الإغاثي على شكل تقسيمات مناطقية ومن طريق مندوبين لتسهيل المهام وسرعة التوزيع.
أرجوحة الهدنة... واقع وأمنيات؟ "بقولوا"... هي الكلمة الأكثر شيوعاً، يتداولها سكان قطاع غزة في ظلّ صعوبة الاتصال وانعدامها أحياناً أخرى، وتعطل شبكة الإنترنت، أصبحت "بقولوا" محرك غوغل الشعبي عند أهل غزة، تساهم هذه الكلمة في انتشار أخبار صحيحة وأخرى كاذبة، وأخرى منقوصة.
"بقولوا" هي الكلمة الأكثر شيوعاً، يتداولها سكان قطاع غزة في ظلّ صعوبة الاتصال وانعدامها
وأكثر تلك الأخبار التي تهمّ الناس، أخبار الهدنة بين غزة وإسرائيل، عشرات المحاولات مقترنة بأمنيات التحقق على الأرض وانتهاء الحرب، وهو الخبر الأكثر سخونة وانتظاراً للتحقق، الألسن في كل مرة تلهج بالدعاء أن يتم ذلك، حتى تنقضي أقسى صفحة من تاريخ الشعب الفلسطيني. لم تقتصر الحرب على غزة فقط، فقد كان للضفة الغربية نصيب كبير من القتل والتنكيل بالمواطنين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حتى باتت المشاهد المؤلمة والأخبار المفجعة، عيناً على غزة وأخرى على الضفة الغربية، والعدو واحد يمارس القتل والتدمير في مختلف مناطق فلسطين.
■ ■ ■
أفتح شبكة الإنترنت بعد قطع مسافات للوصول إلى ملقم الشبكة، يحدث صوت الماسنجر رنيناً متصلاً، دليلاً على كثرة الرسائل الإلكترونية، أفتح المحادثة مع ابني الأكبر المهاجر إلى بلجيكا، وأكثر تلك الكلمات: أين أنتم؟ ماذا حدث لبيتنا؟ لماذا لا تردون عليّ؟ أين أمي؟ أين جدي؟
هل باتت الإنترنت التقنية الوحيدة التي تجعلنا نحسّ بأننا لم نرجع للوراء خمسين عاماً، كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت منذ اليوم الأول للحرب؟ ربما بتنا أسارى لهذا القول، لكننا في غزّة ما زلنا نمتحن أنفسنا، بأننا أصحاب حق وطلّاب حرية، ومهما عاند المخرز في الإمعان في لحمنا، متقصداً زيادة الآلام والأوجاع، إلا أن اللحم يشد بعضه بعضاً حتى يلتهم المخرز.
هذا الألم المتجدد يجعلنا نقف مكتوفي الأيدي، ماذا نفعل؟ وكيف سينتهي؟ ودعوات إلى الخروج من الجحيم قبل إغلاق المعبر، وهذا يحيلنا على نقاش احتدم بين فريقين من الشباب، وأنا بينهم، ففريق يقول: يجب التشبث بالأرض، والاحتلال إلى زوال، وفريق يقول: نحن الوطن، والوطن حفاظ على الأرواح، سنهاجر لنعيش حياة كريمة، ولسان حالهم؛ سنخرج من الجحيم بأي ثمن.
وأنا مطرق رأسي نحو الأرض، وسؤال أحدهم: ما رأيك في ما قلنا؟ أجبت متنهداً: هل على هذه الأرض ما يستحق الحياة؟
* كاتب من غزّة