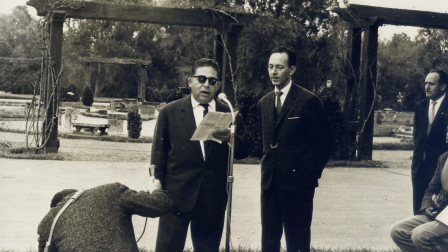ننشر على حلقات رواية "نصّ اللاجئ"، والتي لم تُنشر في كتاب، وهي من أهم أعمال الشاعر والروائي والناقد الراحل محمد الأسعد الذي غادر عالمنا في أيلول سبتمبر 2021، وكان من طليعة كتّاب القسم الثقافي في "العربي الجديد"، وأحد أبرز كتّاب فلسطين والعالم العربي.
في أوائل العام 1948، وكانت قد مرّت بضعة شهور على سقوط حيفا، أكملت عصابات "الهاغاناه" اجتياحَ قرى الكرمل وتدميرها. وتوزّع أهالي هذه القرى، ومنها عين حوض، وإجزم، وعين غزال، وأم الزينات، وأم الفحم، على بقية القُرى الفلسطينية متنقّلين من قريةٍ إلى قريةٍ، وصولاً إلى فلسطين الشرقية، وكان نصيب معظمهم التدفّق على جنين وما يحيط بها.
حكاية هؤلاء القرويّين هي حكاية فلسطين كلّها، حكاية مجتمع مجزَّأ لا تنظّمه دولة، ولا تقوم بشؤونه أبسط البلديات. وكان سقوط هذا المجتمع في براثن احتلال دولي منظَّم يبني دولته شيئاً فشيئاً أمراً منطقياً، ولا يحتاج تفسيره إلى أطنانٍ من الحبر الذي سُفح بحثاً عن الذين خانوا والذين باعوا أو الجيوش المسلوبة الإرادة، وأسطورة الافتقار إلى السلاح، وكلّ هذا الهراء.
إنّ مجتمعاً قروياً مثل المجتمع الفلسطيني لم يعرف طَعماً للدولة منذ أقدم عصوره، وعاش في تجمّعاتٍ ضئيلة بين المرتفعات والهضاب، ضيقةٍ تربطها إما روابط القرية أو العشيرة، كان يحمل مقوّمات سقوطه أمام هذه الهجمة الدولية أو الحرب العالمية التي تُخاض على رقعة ضيّقة - على حدّ تعبير الكاتب الأميريكي ستيفن غرين. فتساقطت قراهُ قريةً قريةً، ومنفردةً لا تكاد إحداها تشعر بالأُخرى. والمفارقة هي أن من سيعرّفني بمصيرِ خربة خزعة أو قرية الدوايمة التي أحرق البلغار والبولونيون والروس أهلها في مغارةٍ كبيرة ليس ثقافتي الفلسطينية التي تجهل كلّ هذا، بل كتّابٌ "إسرائيليون".
ومن سيعرّفني في ما بعد بجمال الفدائي الفلسطيني ليس الشاعر والروائي الفلسطيني، بل الفرنسي جان جينيه الذي قضى أربع ساعات في مخيّم شاتيلا عقب المذبحة،ليعرف فقط ما هو الفلسطيني في الوقت الذي كان فيه شعراءٌ وكتابٌ فلسطينيون ينشرون هذراً بلا معنى إلى جانب مقالة جينيه في "مجلّة الكرمل".
لم يكن سكّان قُرى الكرمل، حين إعلان دولة "إسرائيل"، يعرفون أنهم معزولون عملياً عن بقية الأراضي الفلسطينية، وأنّ ذئاب الصهيونية خلّفتهم وراءها في اندفاعها؛ لتصدّ ذئاباً من نوع آخر بدأت تتصارع على الغنيمة السهلة. فظلّ قرويو هذه المنطقة من العالم مُمسكين ببنادقهم العُثمانية يواصلون إطلاقَ النار على خُطوط مواصلات الجيش الصهيوني. ولم يتجاوز فعلُ هذه البنادق الساذجة سوى إزعاج المواصلات فترةً من الزمن، قبل أن يتَّخذ هذا الجيش قرارَ الخلاص من هذا الإزعاج فيجتاح قراهم ليلاً، واحدةً بعد أُخرى، ويفتح الطريق لقوافلهم لتلتحق بالعرب.
في هذا الجوّ وصل سكّان الكرمل عبر الخطوط الإسرائيلية إلى جنين، بعد أن تسلّى الجنودُ بسَلب القرويّين شيئاً من ذهبهم وعفّوا عن أدوات الطبخِ النحاسية التي كان بعضهم يحملها في أكياس ٍعلى ظهره. وتوزّعَ هؤلاء بين بساتين اللوز الذي كان مثمراً آنذاك، وكان نصيب أهلي بستانَ لوز، كانت الأمُّ تحظر على أطفالها التقاطه. هذه القروية حرصت على جمع ما تساقط منه، ووضعته جانباً لتأتي من ثم صاحبةُ البستان فتأخذه من دون أن تكلّف نفسها الالتفات إلى شبهِ الكائنات البشرية التي تلتحفُ السماء في بستانها.
في هذا المكان بالذات وُلدت كلمةُ "اللاجئ"؛ أطلقها سكانُ جنين وطولكرم وعانين وبقية سكّان فلسطين الشرقية على هؤلاء القرويين القادمين من الساحل. وسيحظى هؤلاء بدورهم بعد بضعة أشهر باسم "سكان الضفة الغربية" نسبةً إلى قطعة جرداءَ من الأرضِ اسمها "شرق الأردن" ستعلن نفسها بعد ذلك "مملكة هاشمية".
ليس الشاعر ولا الروائي الفلسطيني من سيعرّفني بجمال الفدائي، بل الفرنسي جان جينيه
عبثٌ ألسُني وجغرافي، يُجرَّد فيه الإنسانُ من هويتهِ، ويُعطى المفهوم الجغرافي هويةً. وسيتردَّدُ في هذه المنطقة اسم "اللاجئ" طويلاً كصفةٍ محقِّرةٍ وتعبيراً عن الازدراء والاستهانة. فيقول أحدهم شاتماً حمارَه : "امشِ.. وجهك مثل وجه اللاجئ". وتقول امرأةٌ فلسطينية تصف فتاةً: "هي فتاة جميلة ومؤدّبة.. ولكن يا للخسارة.. هي لاجئة". وستُبدي شاعرةُ نابلس فدوى طوقان في ما بعد تعاطفها مع "اللّاجئة" المسكينة، لا مع الفلسطينية التي تشترك معها في الهوية.
ذكرَ أحدُ الكتّاب السوريين، ولا يحضرني اسمه الآن، في مقالٍ نشره في "مجلة الآداب" في الخمسينيات، أنه كان يرى مصيرَه ومصيرَ أولادهِ في وجه اللاجئ الفلسطيني الذي يأتيهم بالحليب صباحاً في أحد أزقّة دمشق. أما هؤلاء الذين يُفترض أنهم أبناء فلسطين واحدة، فقد ألقَوا بالقرويِّ المشرَّد خارج صفة الفلسطيني، وعزلوه في لفظة "اللاجئ"، بالضبط كما سيحدث بعد سنوات طويلة حين يطلق فلسطينيو الأردن على الفلسطينيين المشرَّدين من الكويت لقبَ "الكويتيين" لإبقائهم خارج السور، وإحاطتهم بما يكفي من الكراهية والنبذ، والمجهول يبرّر لهم اقتراح شتّى التخيّلات عنهم. وستكون لهذه المفارقة الاجتماعية تبعاتُها السياسية؛ في قبول "اتفاقيات أوسلو" السرية (1993)، ونفي صفة الفلسطيني بالمفهوم السياسي والاجتماعي عن جزءٍ كبيرٍ من الشعب الفلسطيني، والاعتراف بأنّ أرضه (الساحل الفلسطيني والجليل والنقب) تُدعى "أرض إسرائيل" الخرافية.
إن شرط الانقسام الفلسطيني هذا، أو الخيانة الوطنية بالأحرى، موجودٌ قبل قيام "إسرائيل" واستمرارها، ودخل في ثقافة مثقّفي المنظّمات الفلسطينية. فلم يعُد حدثُ احتلالِ فلسطين بالنسبة لهم يتجاوز العام 1967. وفي هذا أبلغ دليلٍ على فشل الفكر الفلسطيني وثقافته في تكوين أو إعادة تكوين وجدان شعب واحد، أو على الأقل؛ فشل الجانب المهرّج منه الذي شاع في السنوات الأخيرة. وقد صادفتُ مهرّجين فلسطينيين يحتجّون بحرارةٍ وعنفٍ إن استبدلتَ اسم فلسطين الشرقية باسم الضفة الغربية، أو تجرّأتَ وقلتَ "فلسطين المحتلّة" بدل "الأرض المحتلّة".
ويمضي محمد علي طه في تهريجه إلى مدى أبعد، فيطالب الكتّاب الفلسطينيين أن يُعيدوا النظرَ في ما يكتبون وفي ما يفعلون بعد "اتفاق أوسلو" وبعد الواقع الجديد. والطريف أنّ هذا يرأس ما يسمونه "الاتحاد العام للكُتّاب العرب الفلسطينيين في إسرائيل". وكأن الكاتب كما يعرّفه هذا، مجرّدَ موظّف علاقاتٍ عامّة أو أداة جهازٍ إعلامي.
لقد أخمد هذا الانقسامُ الانتفاضة الفلسطينية العظيمة، وهي انتفاضة مخيّمات فلسطين الساحل أساساً، لأنها أعادت إلى الصراع وجهه الحقيقي المتواصل بين محتلّين وأصحاب وطن منذ ما يقارب القرن، أي منذ إقامة أوّل مستعمرة صهيونية في العام 1882، وليس "مستوطنة" كما دأب على القول إعلام المهرّجين.
هنا في هذا المكان وُلدت لفظة "اللاجئ"، وهنا خطرت للفلسطيني الذي هو أبي، وقد طُرد بالقوّة من قريتهِ على السفح الجنوبي للكرمل وبعيداً عن قبورِ أجداده وبساتينهم، فكرةُ أن يرحل عن هذا الجحيم. لقد أخرجته "الهاغاناه" من معناه، ولم تفعل جنين سوى أن ألصقت به اللّا معنى نفسه: "اللاجئ". وسيأتي بعد ذلك رجالُ "اتفاق أوسلو"، وكلّهم من رجال البزنس فعلاً لا مجازاً، ليطردوا ابنه من اسم الفلسطيني ويعيدوه إلى اللامعنى مرّة أُخرى.
قال والدي يخاطب الأم: دعينا نمضي إلى العراق.
- وماذا سنفعل هناك؟
- سنلتقط التمر... ونبيعه... وهذا أشرف لنا من هذا الإذلال.
كانت كلّ البيوت والوجوه موصدة، ولم يكن هذا القرويُّ يعرف عن العراق سوى اسمه، وأنّه مصدر التمر والبلَح. أمّا التفاصيل الأُخرى، فلم يكُن لها وجود، وهذا هو وضع غالبية الفلسطينيّين، أعني الفلّاحين، آنذاك. أولئك الذين لا يعرفون شيئاً ممّا يدور حولهم. أو أولئك الذين يُطلق عليهم مالكو الأراضي وورثةُ الامتيازات العثمانية الاسم الذي يتمطّقون به متأفّفين: "سواد الناس" أو "الرَّعاع"، ويطلق عليهم ساكن المدينة الفلسطيني اسم "الفلاحين" استهجاناً وازدراءً. وسيقول والدي متحسّراً وهو يجلس في مقهى في أعماق الجنوب العراقي في ما بعد. "ليتنا.. متنا هناك". وستعلّق سلمى الجيوسي، من موقعها الطبقي، على مذابح صبرا وشاتيلا بقولها "فلّاحو بلادنا مساكين... تعذّبوا كثيراً".
حكاية هؤلاء القرويّين هي حكاية فلسطين كلّها، حكاية مجتمع مجزَّأ لا تنظّمه دولة
إذن في شاحنات الجيش العراقي المنسحب من جنين، أُخذت قبيلة فلسطينية يُقال إن تعدادها آنذاك كان 20 ألفاً ما بين امرأة وشيخ وشاب وطفل. ويقال بين الناس إنّ العراق أخذ هذا العدد بعد تعهّدٍ من قبل الحكومة العراقية، بإعاشته مقابل إعفائها من المُساهمة في ميزانية وكالة الغوث التي كانت الأُمم المتّحدة في الطريق نحو إنشائها.
وفي مكانٍ آخر نجد وثيقةً محفوظة في وزارة الخارجية الإسرائيلية تقول إن حسني الزعيم بعد مضي زمن قصير على استيلائه على الحُكم في سورية اقترح لقاءً مع ديفيد بن غوريون وجهاً لوجه من أجل التوصّل إلى "اتفاق سلام". وقال في اتصالاته مع الإسرائيليين إنه "يوافق على استيعاب ما بين 300 ألف إلى 350 ألف لاجئ فلسطيني في بلده وتوطينهم بصورة دائمة". وفي 16 نيسان/ أبريل 1949، كتب بن غوريون في مذكّراته: "اقترح السوريون سِلماً منفرداً مع إسرائيل وجيشاً مشتركاً، غير أنّهم يريدون تغيير الحدود ويريدون نصف طبريا".
وليس معروفاً ما إذا كان التعهّد العراقي يتضمّن شيئاً يماثل تعهّد حسني الزعيم، إلّا أن ما سيحدث للقبيلة الفلسطينية من إبادةٍ ألسُنية ونبذٍ في البداية في العهد الملكي، ثم إعادة تأهيل وتربية "قومية" على حدّ تعبير أحد أقطاب البعث، المطرود من منصبه في ما بعد مع تعهّدٍ بإغلاق فمه، لا يبتعد في مفهومه عن هذا.
جُمِع اللّاجئون في البداية، وهذا هو اسمهم الرسمي والشعبي في الأربعينيات والخمسينيات، في مدارس يهودية ضخمة أشهرها مدرسة خضّوري في الشورجة والشبيهة بقصر من قصور تجّار البندقية الإيطالية. وسيأتي على هذه المدرسة حريق هائل بعد بضعة أشهر من تسلّم العسكريّين السلطة في العراق عام 1958.
كان التجميع عشوائياً بحيث تجاورت طبقتان: طبقة مالكي الأراضي، وهم شيوخ عائلات بدوية الأصل وباشوات من العصر العثماني، وطبقة الفلاحين في مكان واحد. إلّا أن هذا "الخطأ" تم إصلاحه فوراً، إذ تقدّم أقطاب العائلات بالتِماسٍ، وتم تبنّيه مـن قبل الحكومة العراقية، طلبوا فيه إعطاءهم وضعاً خاصاً، إذ ليس من المعقول حسب تعبيرهم أن يُحشروا مع "فلاحيهم" في مكان واحد.
واستجابت الحكومة العراقية لهذا الالتماس، فأفردت لهذه العائلات "الكريمة" أو المقدّسة مساكن خاصة وأعطتها الجنسية العراقية في ما بعد، وبعضها حظي بالجنسية الأردنية واللبنانية... وهكذا.
وجاء إصلاح "الخطأ" الثاني أيضاً، خطأ تجميع اللاجئين في مكان واحد، فتم تشتيتُهم أكثر، فأُرسل جزءٌ منهم إلى المُوصل في أقصى الشمال، وجزء إلى البصرة في أقصى الجنوب، وظلّ جزءٌ في بغداد. وترافق هذا التشتيت مع أوامر مشدّدة للسلطات الأمنية بعدم السماح للّاجئين بالتنقُّل، أو تغيير أماكن سكنهم.
وكان سقوط هذا المجتمع في براثن احتلال دولي لا يحتاج تفسيره إلى أطنانٍ من الحبر
تجربةُ الموصل لم تصل أخبارُها، لأن شهودها لم يتحدّثوا بعد، أو ربما لم يبق منهم من يستطيع الإدلاء بشهادته. ولكنهم تعرّضوا هناك على الأرجح لكلّ ما تعرّضت له بقية اللاجئين في العراق؛ أعني العواصف التي اجتاحت الحياة العراقية بعد العام 1958. أما بالنسبة لتجربة بغداد التي لم يظهر روائي فلسطيني أو كاتب ذو قيمة استطاع التقاطها، فقد طُمست هي الأُخرى، ليس بسبب عدم توفّر الصحافي أو الكاتب الفلسطيني، بل بسبب أن هؤلاء أُعطيت لهم موضوعات أُخرى لتداولها وسقطت تجربتهم وتجربة قبيلتهم في النسيان.
فإضافةً إلى تداول الموضوع العراقي وُلدت فيما بعد ظاهرة تداول الموضوع الفلسطيني الذي لم يكن يتجلّى إلّا حيث تدور دائرة ضوء السياسي، فكلّ فلسطيني في أي مكان اتجهت بوصلته إلى الساحة النضالية بعيداً عن يومياته كفلسطيني في هذا المكان أو ذاك. وفرضت هذه الظاهرة، التي كانت من علائم الثورية، الغيابَ المطلق لكلّ ما هو فلسطيني خارج النموذج اللفظي الجاهز الذي كرّسه كتبَةُ المنظّمات ومن ظلّ مأخوذاً بأضوائهم.
في أواخر الخمسينيات، وحين قرأتُ مقالاً كتبه طالبٌ جامعي فلسطيني في صحيفة عراقية يشكو فيه من لا إنسانية مسكن الفلسطيني في مدرسة "خضوري" (التوراة)، سخرتُ أنا نفسي من هذا الذي يفكّر بقضية خاصة "تاركاً فلسطين جانباً".
كان الإيهام بأن ما يعيشه الفلسطيني على الأرض ليس جديراً بالتفكير الشائع. المهم أن يعيش القضية، أي أن يتوهّم له حياة أُخرى.
لم يؤثّث الفلاح الفلسطيني حياته، وظلّت فقيرة بائسة. ولكن أكان إسقاط الملموس والمعاش اليومي واعتلاء أوهام الثوري، قادراً على إمداده بموضوعه؟ أوَليس هذا هرباً وتجاهلاً للحقيقة الثورية دائماً.
في أواخر الخمسينيات شهدتْ بغداد ميلاد منظّمة فلسطينية كانت تُدعَى "جبهة التحرير الفلسطينية"، وعلمتُ في ما بعد أن مؤسّسها كان صالح سرّية بالتعاون مع الحاج أمين الحسيني الذي أعطى لهيئته العليا مكتباً في بغداد.
وتذكّرت اسم صالح سرية؛ لم يكن صالح سوى اسم كاتب ذلك المقال التوراتي الذي أثار سخريتي. وصادفتُ صالح مرّة في أيّام دراستي الجامعية. كنّا طلَبة حول طاولة، وكان أحدهم يجلس على الطرف البعيد يُقلّب كتاباً بين يديه. وكان هو صالح في أيام إعداده لرسالة الدكتوراه. وغاب عني الاسم طويلاً، إلى أن أوردته وكالات الأنباء بوصفه زعيمَ تنظيم إسلامي في القاهرة اقتحم كلية الشرطة العسكرية، كان ذلك في منتصف السبعينيات. وأُعدم الرجل الذي وصفته الصحف المصرية بالغامض وذي التأثير الساحر على مريديه.
منذ العام 1949 تنبّأ موظّفو الخارجية الإسرائيلية بأنّ اللّاجئين سيتدبّرون أمورهم. فأولئك الذين يتمتّعون بأعلى مستويات القدرة على البقاء سيتدبّرون أمورهم عن طريق خيار طبيعي. أما الباقون فسيُسحقون: سيموت قسم منهم، وسيتحوّل معظمهم إلى أشباه بشر وحثالة مجتمع، وينضمّ إلى أكثر الطبقات فقراً في الدول العربية.
وفي العام 1959 كانت جبهة الغامض صالح سرّية، فتى المقال التوراتي، تطلق مقولة بين اللاجئين مفادها "أن رصاصة واحدة تُطلق في فلسطين تعادلُ كلّ العمل السياسي خارج فلسطين".
ويبدو أنّ الأميركيّين كانوا أكثر خبرةً ومعرفةً من موظّفي الخارجية الإسرائيلية الذين عكست نبوءتُهم خبراتهم فـي بلدانهم الأوروبية الشرقية، فجاءت نبوءتهم تعبيراً عن التفكير الرغبوي لا الاستقراء الموضوعي.
تحذّر تقديرات الخارجية الأميركية في الخمسينيات من "خطر اللاجئين" الذين هم وفق التعبير الأميريكي "مجموعة متذمّرة يعادل تعدادها عدد الجيوش العربية مجتمعة، وإنها تشكّل بؤرةً خصبة للدعاية الشيوعية". وسيأخذ رئيس وزراء العراق نوري السعيد، الذي سيجرّ العراقيون جثّته في شوارع بغداد مبتهجين بعد أيام من ثورة تموز/ يوليو 1958، بهذا التقرير الأميريكي ويلخّصه في أحد خطاباته، فيشير إلى اللاجئين كسلاحٍ مدمر في الشرق الأوسط وقد تستغلهم الشيوعية.
كنتُ صغيراً يوم ذاك، وسألتُ زميلاً عما تعنيه لفظة الشيوعية وكيف يكون اللّاجئون سلاحاً مدمّراً، فأفهمني أن الشيوعية هي دولة تأخذ الأطفال إلى المدارس وتربّيهم بعيداً عن أهاليهم، أمّا عن السلاح المدمّر فلم يكن يعرف شيئاً.
ألهذا السبب بدأت تتكاثر في أواخر الخمسينيات المنظّمات الفلسطينية، وكأن الأمر أمرُ استعجال إعداد مساربٍ تضمَن تدفّقاً محسوباً للغضب الفلسطيني؟ ألهذا السبب عُزل جزء من القبيلة الفلسطينية في البصرة طوال عامين وراء الأسلاك الشائكة في معسكر بريطاني مهجور يقع على بعد 40 كيلو متراً بعيداً عن البصرة جنوباً في الصحراء؟ ألهذا السبب وُضعت مخيمات الفلسطينيين في لبنان والأردن وسورية تحت رقابة أمنية مشدّدة، ومُنِع سكّانها من العمل والتنقّل؟ ألهذا السبب، كما علمتُ في ما بعد، كانت الإدارة المصرية تمنع انتقال فلسطيني قطاع غزة إلى مصر، فكان الشبّان يعبرون الصحراء معلّقين أسفل عربات القطار؟ ألهذا السبب وأسبابٍ أخرى معاصرة، مُنع "اللاجئ" من الاختفاء وراء أي جنسية حتى يظلّ في دائرة ضوء أبراجِ حراسةِ المعسكرات والقلاع العربية؟