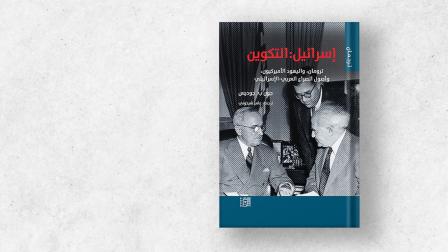تقف هذه الزاوية مع الكتّاب العرب في يومياتهم أثناء فترة الوباء، وما يودّون مشاركته مع القرّاء في زمن العزلة الإجبارية.
محنةٌ لم تكُن متوقَّعة. لعلّ لا أحد يُصدِّق ما يحدث اليوم؛ أن يُجبرك فيروسٌ مِجهري على البقاء في البيت، أو أن يحدَّ من حركتك، أو يتحكّم في نشاطك ومواعيدك. إنّه لأمرٌ رهيب وقاسٍ! قلتُ لأبي: أخيراً "طحنا" (وقعنا)، وأجبرنا كورونا على البقاء في البيوت، ضحك وقال: معك حقّ، "طحنا" صح، حتى المرض لم يفعلها.
كان مفهوم التباعد الاجتماعي، الطارئ على مجتمعاتنا، فرصةً ليكتشف المواطنون التباعد الحقيقي، بعد انهيار سُلَّم القيَم. سألني خضّار: كيف ترى الأمور أستاذ؟ فقلتُ مبتسماً: كما تراها أنت. ابتسم بدوره وقال: أنتم المتعلّمون ترون أفضل منّا. قلت له: الله يجيب الخير. شعرتُ بالراحة. عادةً لا نحفل بالمتعلّمين في مجتمعنا. مع الوباء، ارتفعت أسهم الأطبّاء وتصدّروا الواجهة، وقد كنّا نتبجّح: "سل مجرّباً ولا تسل طبيباً". أخرست الأزمة الكثير من الجهلة والمتعالمين المتنطّعين والمتطاولين.
لسنوات، ظللتُ أنعم بالحرية، وأشتغل دون كللٍ ودون عطل، لقرابة 14 ساعة يومياً. أستيقظُ قبل الطيور أحياناً، وأعود إلى البيت بعد منتصف الليل... بعد أن تنام كثير من الكائنات. لا أشعر بالتعب، ولا بالقرف، فقط أشعرُ بالراحة والاطمئنان بعد إنجاز عملي بنجاح. لكن بعد تطبيق الحجر الصحّي، تعقّدت الأمور. من الصعب أنْ يجد كائنٌ حرٌّ نفسَه في القفص، يتبع الإرشادات والإملاءات، يخرج من البيت ويعود إليه في وقت محدَّدٍ، ليس من اختياره.
مع ذلك، شعرتُ ببعض الرضا لأنّي أنجزتُ الكثير من الأفكار التي كانت تراودني وتؤرقني وتفتح شهية أحلامي، فرحتُ لأنّني لم أؤجّل يوماً فكرةً خطرت ببالي، طالما كنتُ مولَعاً بالتجريب. وحده الواقع يثبت قيمة الأفكار، لذلك لا "شيءَ من حتى" بقي عالقاً في نفسي كما يُقال.
أيامُ الحجر فرصةٌ للراحة، وفرصةٌ للعزلة، وفرصةٌ لتصفُّح الكتب، وفرصة للاستفادة من الإنترنت، وفرصةٌ لاقتناص ساعات من النوم المريح كنت محروماً منها، وهي فرصةٌ لأكون في البيت في ساعات معيَّنة لم تكن تسمح بها ظروف العمل... فرصةٌ لتناول وجبات ساخنة بدل الوجبات السريعة الباردة، فرصة لتناول قهوة العصر، وفرصة للقاء تاريخي مع الأُسرة؛ إذ نادراً ما كنّا نلتقي.
إنها، أيضاً، فرصةٌ ثمينة لترى سلوك ومشاغبات كلّ واحد من أبنائك، لتعرف اهتماماتهم وتباغتهم بأسئلة ما... فرصةٌ ليكتشف الجميع الطفلَ الذي بداخل والدهم وهو يلعب مع الصغيرة، ويقلّد أصوات الحيوانات وحركات المهرّجين، وكأنه ليس ذلك الأب الجاد الصارم الذي تعوّدوا على رؤيته.
بالطبع، أخرج أحياناً لقضاء بعض الحاجيات، محترماً مسافة الأمان، ومتوخّياً الحذر، دون أن أضع الكمّامة والقفازات، فأنا لا أطيقُهُما. الحياة في الخارج والمحلّات تميل إلى العبث. المواطنون لا يتبعون الإرشادات الصحية المطلوبة. ينقصنا الوعيُ والثقافة الصحية المطلوبان في مثل هذه الظروف الخطرة.
كانت صدمتي الأولى لما تهافت المواطنون على تخزين السميد (الدقيق) وتسبّبوا في الندرة والفوضى. لكن سرعان ما أفقتُ منها بعد أن شاهدتُ الأميركيّين يتهافتون على الأسلحة، وكل مجتمع بلا وعيه يُفضَح.
في البيت، قلَّ التواصل الفيسبوكي مع الأصدقاء، وقلّت التعليقات، ولم يعُد الهاتف يرنّ كالعادة. أتعوّد على حياة جديدة، أرقب العالم وأتابع تطوّرات فيروس كورونا عبر الفضائيات، أصبحت أُتابع الأفلام، وخصوصاً الوثائقية منها. أرحل مع "غوغل" إلى القارات والحضارات والأوبئة والحروب والحروب الأهلية، أتنقّل بشغفٍ بين العلوم والتاريخ والفلسفة والأدب والاقتصاد، أتأمّل خطابات نوابغ البشرية.
لأوّل مرّةٍ واجهتُ المحنة بهدوء ودون جزع. لم أفكّر في الخسائر المتوقَّعة بقدر ما كنتُ أفكّر في ضرورة التكيُّف مع الوضع وتحمُّل تبعاته برزانة، وفي ما يمكن أن نتعلمه من التجربة.
أنا منشغل، أكثر بضرورة تجاوز الوباء من أجل غدٍ أفضل، بقيمٍ إنسانية جديدة ومتجدّدة.
كشف الوباء أنّ البشرية انتقلت من القرية الصغيرة الواحدة إلى الغرفة الصغيرة الواحدة.
* روائي من الجزائر