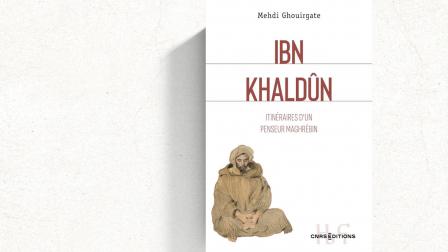نؤجّر سيارة، مع سائق شاب. يركب معنا أحد المرافقين بعد أن ترك زوجته وحيدة، ليعود. شنطه كثيرة، فهو تاجر. لا بأس. يحدّثنا، أثناء الطريق، عن غربته وعمله القديم في المملكة السعودية. أخي أيضاً كان هناك في "الباحة" بالقرب من "جيزان". وجدا حديثاً مشتركاً ذا شجون. أتركهم لذكرياتهم، وأركّز في ما أرى: الجبال ذاتها التي رأيناها في رحلة القدوم. الطريق ذاتها. فقط كلام السائق المقدسي، ووجهة نظره، وزاوية رؤيته، تختلف: تختلف عن السائق السبعاوي الأول.
أخذ منّا 250 شيكلا ثمن الرحلة.
نصل أخيراً إلى معبر إيرز. ننزل بشنطنا، على حاجز، يقوم عليه مجنّد شاب. أكلّمه بالعبرية اختصاراً للوقت. يراجع هوّياتنا ويدقّق في ملامحنا، ثم يسمح لنا بالدخول.
على مقربة منه، ثمّة جنود يتابعوننا بانتباه من برج مرتفع. نأخذ العربات ذات العجلات، وندخل بهو المعبر.
لا موظّفة في الغرفة الزجاجية الصغيرة.
ننتظر مع رجل مريض وزوجته قدما من رام الله. أنتبه لشنطهم. أكيد أنهم يتاجرون. فشنطهم ضخمة وكثيرة. ما أشطر الغزازوة! علّمتهم الضائقة استغلال أي شيء.
ننتظر ساعة، ثم تجيء الموظّفة، وندخل دون تفتيش الشنط.
لم تلق نظرة حتى! بخلاف ما قيل لي من مرضى سابقين، حذّروني من مغبة مصادرة خمسة كروزات "إمبريال"، كنت أنوي شراءها، لترافقني في فترة الكتابة عن "الرحلة". إنهم يدقّقون في الداخلين إلى "إسرائيل" فقط، أما الداخل إلى غزة، فلا تثريب عليه: ليحمل ما يشاء، فليس ثمّة من مشكلة!
يأتي الحمّالون الغزازوة العاملون هنا. نعطيهم 20 شيكلاً، فيحملون شنطنا على عربات صاج بدائية، عابرين فقط الممرّات.
نقطع المسافة الصلعاء الباقية، حاملين شنطنا بأيدينا. جيد أنها ليست ثقيلة، وإلا لعجزنا عن حملها.
أخيراً نصل الأرض الغزية، حيث موقف صغير لسيارات الأجرة الصفراء.
يحملنا السائق مقابل 20 شيكلاً أيضاً. ننتظر وتمتلئ السيارة. يركب معنا الرجل وزوجته ذاتهما. طوال الطريق يُعنّفها ويشتم أهلها. لم يكفّ عن التعنيف والتهديد، منذ جلسنا معهما في القاعة الزجاجية، وحتى ركوبنا هذه السيارة. واضح أنه جاهل وقليل أصل. لا بأس. أرقب زوجته الجميلة الغلبانة، وهي تماشيه وتداري حالها معه.
اللعنة!
نصل غزّة المدينة، ومن موقف التاكسيات، بالقرب من المكتبة العلمية، نركب سيارة لخان يونس.
نصلها بعد الظهيرة. في الطريق تتعطّل السيارة، ونبدّلها بسيارة ثانية.
أضحك مع أخي، حمداً لله على سلامة وصولك للعالم العاشر!
- يا رجل. إنها مسقط الرأس!
- ومسقط الرجْل كمان.
- وأرض الرباط!
- ومربط حمير فلسطين!
نفرقع بالضحك.
- اللهم اجعله خيراً. يعقّب أخي.
إنه لا يثق حتى بدقيقة ضحك.
فهل يكون، مثل ذلك الشاعر، الذي يعتبر إقامته على الأرض، إقامةً في "مكانٍ خَطِر"؟
شتّان! فذلك الشاعر، "يقول" فحسب، بينما أخي "يعيش" ما يقول.
نصل عمارة جاسر. نفترق. هو إلى منطقة "البطن السمين"، حيث بيته، وأنا إلى "حيّ الأمل" حيث بيتي.
أصل ويهجم الأولاد: أتيت لهم بكل ما وعدتهم، سوى الخبز!
- اعذروني. كان الكثير من أنواعه، تحت الفندق، في حوانيت المقادسة، لكنّ أخي آثر الشراء من سوبر ماركت بالمجدل. وحين وصلنا المجدل، دلف بنا السائق لقرى في الطريق، فلم نجد خبزاً، فاشترينا كوكاكولا وشامبو للرأس، وخلافه.
أتذكّر الآن وأنا أكتب، ما حدث معي حين نزلت في محطّة بنزين، يديرها رجل يهودي.
سألته عن الخبز، ولمّا لم أجده، اشتريت الكولا والشامبو، وتحدّثنا بعض الوقت عن الحال في غزّة. ولكي يطمئن، فهو لا يرى غزّاويين هنا منذ سنوات، أعلمته بأنّني صحافي، وقريب من الشيوعيّين.
قال: انتهى زمن ذلك. أفضل لك القول: ليبرالي.
ماشيته: ليبرالي ولكن إلى اليسار أكثر.
هزّ رأسه، وصار في مزاج طيب لإطالة الحديث.
شرع يطرح عليَّ عدّة أسئلة عن غزّة، عن حماس، عن الخلاف بينها وبين فتح. تكلّمنا طويلاً، حتى استاء السائق المنتظر بسيارته، وصار ينادي عليّ.
أخذت البضاعة، عبوتا شامبو بسعة لتر، وست زجاجات كولا سعة لتر ونصف، ونقدته مئة شيكل ورقية.
وهنا مربط الفرس! أخذ الورقة، وصار يدعكها بالإبهام والسبابة، خوفاً من أن تكون مزيّفة!
- واضح أنك لا تثق بي، رغم حديثنا.
خجلَ، ولم ينبس. فغادرته، وركبت السيارة بغضب.
- على كل حال، لستُ مزوّر نقود!
ابتسم بخذلان، وبعد ثوان، غاب عن ناظري.
لم يعد أحد منهم يثق بغزّاوي. كلنا إرهابيّون في نظرهم. مع أننا عشنا معهم، كعمّال، طوال عقود من الزمن.
لم أستغرب وإن كنت غضبت. على الأقل أفهم لمَ صاروا هيك. فهم، أقصد "المواطن" العادي، ضحية نموذجية لوسائل إعلامه.
"كريتي زيه بعيتون" (قرأت هذا في الجريدة)، يقول لك حاسماً إذا اختلفت معه في شيء. فالجريدة مقدّسة، ولا تكذب!
اللعنة!
ملاحظة: وأنا أكتب هذه الكلمات، على مدار أيام وليال، انقطع التيار الكهربائي عشرات المرات. ومع أني "مقروص"، فما إن أندمج في الكتابة، حتى أنسى أن أحفظ المخطوط، بين الفينة والأخرى. لذا، فثمّة مقاطع بل صفحات كثيرة في هذا العمل، أُعيدت كتابتها مرتين، وأحياناً ثلاثاً. مما أفرغ تلك المقاطع والصفحات من "خيرها". فالكتابة، كما تعرفون، كنهر هيراقليطس: لا يمكن أن يعبره المرء مرتين.
لذا اقتضى التنويه.
ملاحظة ثانية وأخيرة: نسينا طيلة فترة إقامتنا في ربوع القدس، موضوع انقطاع التيار الكهربائي. حتى لكأنّ الدنيا لا تعرف هذا المرض. فالكهرباء هناك لم تنقطع سوى دقائق، واتضح بعد ذلك أنّ أحد المرافقين الجدد منّا، دخل مطبخ الفندق، لأمر ما، فأنزلت يده أمّان الفندق الكهربائي! مما أغاظ رب الفندق، وجعله يفكّر في عدم تأجير طابقين من عقاره لمرضى غزّة. ومعه حق: فهنا كل خطأ تذهب الهواجس به نحو المؤامرة. ربما ثمة عملية قتل أو سرقة للسيّاح! غير أنّ صاحب الفندق، عرف القصة فاطمأن، راجياً منا جميعاً ومُشدّداً على عامله، بحظر دخولنا للمطبخ، مهما يكن السبب!
يا للهول! فحتى العتمة التي لا يعرفها المقدسيون، ولا يعرفها قاموس الليل عندهم، جئنا بها نحن إليهم... نحن ما غيرنا! أضحك الآن، في غمرة هذه الصفحات، قرابة الرابعة فجراً، وأضع القلم. متذكّراً وجوه كل من رافقوني، من مرضى ومرافقين وأصدقاء وعابري سبيل، وسياح، وأطباء وممرضات، وشجر وحجر وجبل وسماء وطير. كتبت عنهم شيئاً وغابت أشياء، كما هو شأنها الكتابة. فأهمس للكتب من حولي: شكراً لهذه الحياة العظيمة. شكراً لدرب آلامها الذي امتدّ هذه المرة، من خان يونس إلى غزة، إلى المجدل إلى دير ياسين، وصولاً إلى جبل الزيتون، ليتصل بدرب آلام السيد، وليكون أطول منه بما لا يُقاس. إنها حقاً حياة ثمينة، رغم قبحهم، وعنجهيتهم، واستعلائهم، وعنصريتهم. حياة تبدو لي من الآن، كأنها حلم في حلم. رؤيا لم أعشها، وإنما فقط حلمتها.
... ياه يا عزيزي، لن يذكر أحد خطواتك هناك، سوى الأصدقاء الذين تركتهم خلفك، وحتى هؤلاء ربما ينسون. فـ"اختلاف النهار والليل يُنسي"، تماماً كما تنسى أنت. بيد أنّ "هذه الكلمات"، ربما تحفظها من آفة النسيان. فاكتب.. اكتب كلماتك، على نقصها وقلة حيلتها، ودعْها...
[دع هذه الكلمات تتحمّل تبعة ما صُنع، حتى لا يُصنَع ثانيةً].
* شاعر فلسطيني مقيم في برشلونة، والنص حول تجربته في عام 2009