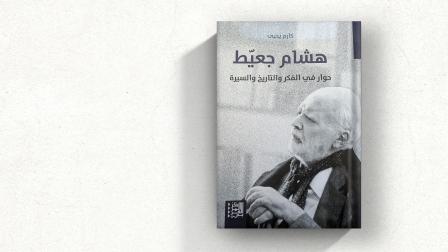في أواخِر عصر النهضة العربيّة، شُنّتْ ضدَّ السّجع معاركُ ضارية، لعلّ أشهرها تلك التي قادَها عبّاس محمود العقّاد ضدّ مصطفى الرافعي. كان محور السّجال العنيف بينهما الاستخدام المُبالَغ فيه لهذا المُحسِّن البديعيّ وتَكَلُّفه في الكِتابة والخطابة، مع اعتباره عنوانَ الفَصاحة. والظاهر أنّ التيّار المعادي للسجع هو الذي انتصرَ، ولكنْ إلى حين؛ إذ ظنّ الملاحظون أنَّ هذا الأسلوبَ البلاغيّ، ذا الطبيعة الصوتيّة، قد انقرضَ إلى الأبد وأهْمِلَ، شأنَ المتقادِم من كلمات الضاد. ثمّ ما راعنا إلا وقد تسلّل السجع، في أيامنا، إلى بعض دوائر الخطاب التي لم يكن أحدٌ يتوقَّع ظهورَه فيها.
وأوّل هذه الدّوائر التي شهدت عودته هي الشّعارات السياسيّة التي تُصاغ إمّا في الحملات الانتخابيّة أو في سياق الاحتجاج؛ إذ يعمَد صانعو الخِطابات إلى جُمل وجيزةٍ، ذات بنيَة سجعيّة، يَسهل حفظُها وتكرارها، مع غلبة إحصائيّة واضحة لفاصلة: "ية"، وهي لاحقةُ المصادر الصناعيّة، في مثل شعار: "لا شيوعية ولا اشتراكيّة، تحيا الوحدة الوطنية" أو "كرامة حرّية، عدالَة اجتماعيّة"، أشهر شعارات ثورة تونس. والملاحظ أيضًا أنّ السجع اخترقَ السجلّ الدارجَ وصار فاعلاً فيه، ليكون أقربَ إلى الإدراك العام والتوظيف الشاسع بين المستخدمين.
يعزف السجع على الوتَر العاطفي ويُعطّل البُعدَ العقلاني
ومن الواضح أنّ هذا البناء السجعيّ يهدف، كما أشار باتريك شارودو وهو من المُتخصّصين في الخطاب السياسي، إلى الضرب على وتر الإيثوس والباثوس، أي الوتَر الأخْلاقي والعاطفي، لدى المتقبّل. بل لعلّه ممّا يُعطّل لديه البعدَ العقلاني، بحكم أنّ الملتقّي يخضع لتأثير التعاود الصوتي وتكرار نفس الحروف فيُغيِّب، ولو للحظات، قدرتَه على التحليل، وهذا ما أكّده كلٌّ من رومان جاكسبون في كتاب: "الصّوت والمعنى"، وجون كوهان في "بنية اللغة الإنشائيّة".
وهكذا، فإن تعطيل العقل وتغليب البعد الأيديولوجي، بالمعنى الماركسي للكلمة، هي نفس المآخذ التي شدّد عليها مفكّرو النهضة في مهاجمتهم للسجع، ولكن دون أن يربطوها، صراحةً، بتوظيفه في الخطاب السياسي.
من جهة ثانية، نَشطَ السَّجعُ في مَجال الإشهار والإعلانات التجاريّة التي تشيع في اللافتات المرئيّة وفي وسائل الإعلام المسموعة والبصريّة. وهو يهدف، كقرينه الخطاب السياسي، إلى تعطيل التحليل وحمل المتلقّي على الانصياع للإثارة الإشهارية التي تَسمح بها بنية السجع كقوّة تأثير انفعالي، لا تُقاوَم. والملاحظ أنّ السجع الإشهاري يُنتَج أكثر عبر السجلّ الدارج، بحكم أنه يتوجّه إلى أوسع عددٍ من الجماهير، بمن فيهم الأطفال الصغار، وهو ما جعل بعض هذه الجمل تُلحَّن وتُنشد، كما لو كانت أغانيَ قصيرةً.
يحضر في الشعارات السياسية والإعلانات والتعليق الرياضي
وهكذا، أُدْمِج السجعُ ضمن دواليب الإشهار للنظام الرأسمالي وآليات مجتمعات الاستهلاك، بل صار أحد المُكوّنات التي تُأخذ بعين الاعتبار، لتمرير خطاب التسويق وتيْسير حفظه لدى جمهور المُستهلكين. بل وصار إحدى آليات الأفعال الإنجازية التي، حسب نظرية أوستين، تؤثّر في الواقع وتَدفع المخاطَبين إلى تغيير سلوكهم التجاريّ، وهو ما حمل صنّاع الخطاب على استثمار التسجيع في تنشيط الشراء. ومن المفارقات أن يستثمر رأس المال وعقلُه التسويقي محسّنًا بلاغيًّا عتيقًا، هَجرتْه النّخب منذ عقود.
ثم من الطّريف أن ينشط السجع في دائرة ثالثة، ما كان لأحدٍ أن يتصوّرَ حضوره فيها، وهي التعليق الرّياضيّ. ذلك أنّ أشهر المعلّقين، مثل رؤوف خليف وعصام الشوالي وحفيظ دراجي وغيرهم، يلجأون إلى السجع في التعليق على المشاهد الكرويّة ومرافقتها بجُمل مَوزونة مقفّاة، تزيد من بَهجة الحركات في المَلاعب وتقوّي البعد الفرجوي فيها. فالمعلّق يوظّف آليةَ الوصف وينساق، تحت تأثير الحماسة التي يريد خلقَها لدى المشاهدين، إلى إمطارِهم بتوصيفاتٍ عن اللاعبين ومَجرى اللعبة، عبرَ مقاطع توقِف، هي الأخرى، القدرة على التحليل وتغذّي متعةَ الفرجة.
تحتاج عودةُ السجع، عبر قنوات السياسة والإشهار والرياضة، إلى وقفة من الباحث اللغويّ حتى يربطَها بتاريخ الضاد البعيد، حيث كان السّجع، لزمن طويل، آيةَ الاقتدار اللغوي، وهو لدى العرب من أعلى مراتب الإبداع، بما يعنيه التقاط كلمتَيْن بفاصِلَتَيْن (الفاصلة هي القافية في النثر) مشتركتَيْن، من تملّك أسرار اللغة، فيركز السامع على هذا التشابه، متناسيًا أهمَّ ما في الخطاب وهو تماسكه المنطقي وقوة حُججه.
وحين نعود إلى تاريخ الحضارة العربية، نجد أنّ عصور الاهتمام بالعلوم العقلية، كالمنطق والفلسفة وبالمعارف العلمية والعمليّة كالطب والزراعة، لم يتقاطع، إلّا نادرًا، مع ظاهرة السجع التي لم تَرُج إلّا بعدَ انحدار الاهتمام بتلك المعارف في نهايات العصر العباسي، ثم تحوّلت إلى قانون ثابت بفعل التكريس وصولاً إلى القرن التاسع عشر. ولذا يَجدر الانتباه إلى ما يمكن أن يكون وراء عودة السجع في ثقافتنا. فليس ظهوره الصّاخب سوى إشارة إلى رغبة ما في تسريب ما لا يُراد للعقل أن يَنخَلَه.