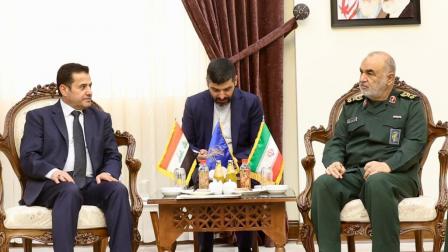هذه لم تكن المرّة الأولى التي تدفع فيها أميركا وإسرائيل نحو قتل اللاجئين الفلسطينيين جماعيًا، على التوازي مع إبادتهم المستمرة في غزّة وكلّ فلسطين، عبر استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، المقصود بالطبع هو اللاجئ الذي يمثّل إثباتًا على لاشرعية الاحتلال، ونقيضًا واقعيًّا للرواية الصهيونية، التي هيمنت طويلاً على العالم.
قد يصح اعتبار قرار حصار أونروا، وصولًا إلى إغلاقها، ضمن توصيف جريمة الإبادة الجماعية قانونيًا، إذ يستكمل هذا القرار نهج الاحتلال في قطع كلّ مصادر الغذاء والدواء، وتدمير المنظومة الصحيّة، واستباحة المدنيين والجرحى بغرض قتلهم، كما ينضم إلى جملةٍ من الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل بحقّ الشعب الفلسطيني، أمام أعين المجتمع الدولي، وغالباً بمباركته، الأمر الذي يضع المنظومة الدولية برمّتها أمام سؤال الجدوى.
إذ يعني العمل على إنهاء دور أونروا إغلاق جميع المنافذ التي تؤكّد على إنسانية الفلسطيني، وعلى حقوقه التاريخية كلاجئٍ، لأن سياق الخلاص من ديمغرافيا اللجوء، على اعتبارها تهديدًا لمستقبل دولة الاحتلال، لم يكن نتاج 7 أكتوبر/تشرين الأول، بقدر ما يعبر عن هزيمة الآلة العسكرية الأميركية الصهيونية اليوم أمام بطولة الشعب الفلسطيني ومقاومته، التي جعلت العدو يذهب إلى أبعد حدٍّ في مشاريعه القديمة الجديدة، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها قضية اللاجئين، الذين تمثّل الأونروا لهم حاجةً ملحةً، لأنّها شاهدٌ تاريخيٌ أمميٌ على نكبتهم وشتاتهم، ولأنّها تساهم في إسناد الفلسطينيين معيشيًّا، ولو بالحدّ الأدنى، رغم الاستمرار في تقليص خدمات الوكالة تدريجًا، خلال المراحل التي أعقبت توقيع اتّفاق "اوسلو"، ورغم فسادها الإداري والمالي، الذي أسهم في تهالكها. إضافةً إلى الوظائف التي توفرها الوكالة للاجئين الفلسطينيين، التي يعتمدون عليها كثيرًا، إلى جانب وظائف منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسساتٍ وجمعياتٍ مدنيّةٍ أخرى، في مخيمات غزّة والأردن وسورية ولبنان.
تلعب أعداد اللاجئين دورًا بالغ الأهمّية في الصراع مع الكيان الصهيوني، لذا عملت إسرائيل والإدارة الأميركية على تقليص عدد اللاجئين الفلسطينيين
هنا لا بدّ من النظر إلى طبيعة دور الأونروا، منذ تفويضها عام 1949 من قبل الجمعية العامة للأمم المتّحدة، بعد فشل مؤتمر لوزان في حلّ قضية اللاجئين، إذ يُناط بها دوران أحدهما خدمي (إنساني وإغاثي يتعلق بالصحة والتعليم والخدمات)، والآخر اقتصادي يتعلق بالتشغيل، والمشاريع التنموية بهدف تأهيل اللاجئ في الحياة العملية والعامّة، من خلال التعليم وفرص العمل والمشاريع التنموية، وهو دورٌ سرعان ما اخضَعته السياسة الأميركية، التي تحكم النظام الدولي، لاستراتيجية "التوطين" أو اللاعودة للاجئين.
أمام ما سلف، تعيش أونروا مأزق التمويل والإغلاق عند كلّ استحقاقٍ إقليميٍ ودوليٍ، تخضع فيه المساهمات المالية لها للاشتراطات السياسية، وقد مورسَ هذا الابتزاز السياسي على الأونروا عشية مشروع ما سمي بـ "صفقة القرن"، إذ تسبّبَ تجميد إدارة دونالد ترامب للتمويل الأميركي للوكالة بعجزٍ ماليٍ كبيرٍ، لم تفلح الدول المانحة في مؤتمر روما، ربيع 2018، في سدّه، ما أدى إلى تقليص الخدمات كثيرًا. ما أضاف مزيدًا من الحرمان على واقع اللاجئين.
كما بدأت لجنة الموازنات في الكونغرس الأميركي، منذ عام 2013، بشنّ حملاتٍ ضدّ أونروا، لإنهاء الوكالة ودمجها في المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين، ما يعني فعليًّا إلغاء القرار 194، عبر التشكّيك في مبرّر وجودها، واتهامها بأنّها عقبةٌ أمام عملية السلام، كما اتهمت مناهجها الدراسية، التي تتبع الدول المضيفة، بـ "شيطنة إسرائيل".
يعكس الاستغلال السياسي الذي تمارسه أميركا وإسرائيل على برامج الدمج، فهي ليست توطينًا أو تخليًا عن حقّ العودة، إنما حقٌ للاجئين في البلدان التي يعيشون فيها. لذا أضحت مشاريع أونروا للتنمية والدمج ووصول اللاجئ للاكتفاء الذاتي حمّالة أوجه بالنسبة للنظرة الإسرائيلية الأميركية، التي تبتغي الاستفادة من مهمة أونروا كمنظّمةٍ إنسانيةٍ لربط "تحسين حياة الفلسطينيين" والانتقال من الإغاثة كمرحلةٍ قصيرةٍ المدى وصولاً إلى مشاريع أشغال وتشغيل اللاجئين بغرض تخلّيهم عن حقّ العودة، علمًا أن أونروا تؤكد على عدم مساس خدماتها المقدمة للاجئين بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة والتعويض.
هذا الأمر ينطبق أيضًا على تحويل مهمة الإغاثة للحكومات المضيفة، على افتراض تقدّم عملية السلام نحو قضايا الحلّ النهائي، ومنها قضية اللاجئين. الأمر الذي لم يتحقّق بعد ثلاثة عقود على اتّفاق "أوسلو".
بهذا الصدد، درجت السياسية الأميركية على ممارسة الضغط بغرض تصفير اللجوء، واستبدال حقّ العودة ببرامج التشغيل، والمشاريع التنموية الاقتصادية التي وضع مداميكها منسّق قضايا اللاجئين في الخارجية الأميركية جورج ماكفي عام 1949، التي تهدف إلى دمج اللاجئين في الحياة السياسية والاقتصادية في بلدان لجوئهم، وصولاً الى تقليص أعدادهم. في تلك المرحلة تراجعت الحكومات العربية عن موافقتها على تقرير بعثة "clapp"، إذ اشترطت لتعاونها مع أونروا عدم تضارب المشاريع مع أحكام القرار 194، لحماية حقّ اللاجئين في العودة والتعويض، الأمر الذي تكفله قوانين الوكالة، لكن بالتأكيد لا تكفله السياسة الأميركية، وقد تعرقلت كلّ هذه المشاريع، وفي مقدمتها مشروع الليطاني في لبنان، ومشروع وادي الزرقا في الأردن، ومشروع تنمية وادي الغاب في سورية، وكذلك مشاريع من بينها استخدام مياه نهر النيل ونهر اليرموك لأغراض التنمية الزراعية في سيناء.
تشترك كلّ مبادرات التسوية الأميركية في شرعنة دولة الاحتلال، وتحقيق أمنه تحت عنوان السلام العربي الإسرائيلي، إلاّ أنّ وضع اللاجئ بين خياريّ العودة أو التعويض قد ورد صراحةً في مشروع جوزيف جونسون 1961، وتعزّز في فكرة اعتبار اللاجئ مواطنًا في بلد لجوئه مع اتّفاقية كامب ديفيد، وصولًا إلى التسوية التي باتت تلوح في الأفق أوائل التسعينيات، ومنها الخيار البديل لحقّ العودة عبر التعويض المالي، وإغلاق ملف اللجوء، ومعه وكالة أونروا، ومشروع "القريعة" في منطقة الشوف اللبنانية، التي كان رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري على أعتاب شرائها بغرض بناء مساكن حديثة لاستيعاب لاجئي مخيّمات لبنان، الأمر الذي لم يتحقق بسبب نزاعٍ عقاريٍ بين مالكي المنطقة، حال دون بيعها، ليؤجل المشروع إلى حين.
لكن، وبعكس مفهوم العودة أو التعويض، الذي نجح المسرح السياسي، في ما بعد، بترويجه للرأي العام، فإنّ حقّ العودة الذي كفلته القوانين الدولية مقرونٌ بالتعويض، ما يعني "حقّ العودة والتعويض"، وليس الاختيار ما بينهما (إما العودة أو التعويض). وجدت إسرائيل في نصّ القرار 194 التباساتٍ تسمح لها بالمناورة والتأويل، مثل جملة "وجوب السماح بعودة اللاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم"، أو أن القرار يذكر "اللاجئين"، ولا يذكر "اللاجئين الفلسطينيين"، وغيرهم.
سياق الخلاص من ديمغرافيا اللجوء، على اعتبارها تهديدًا لمستقبل دولة الاحتلال، لم يكن نتاج 7 أكتوبر/تشرين الأول
بعد فشل مشاريع التوطين سعت إسرائيل، ومن خلفها الإدارة الأميركية، إلى تقليص أعداد اللاجئين في البلدان العربية المضيفة لهم، نظرًا لارتباط أعداد اللاجئين بالصراع العربي الصهيوني، وحجم مساهمات الدول المانحة أيضًا، إذ اتهمت وكالة الأونروا بالكذب بشأن أعداد اللاجئين في مناطق عملها عمومًا، وفي لبنان خصوصًا، بعد أن أعلن لبنان عن إحصاءٍ رسميٍ للاجئين الفلسطينيين في لبنان في ديسمبر/كانون الأول عام 2017، إذ مثّل مفاجأةً وآثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، حيث بلغ عدد اللاجئين وفق الاحصاء 174,422 فلسطينيٍ فقط، وقد نفّذ بالشراكة بين الاحصاء المركزي اللبناني، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بإشراف لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني. بينما أثار الإحصاء تشكيكًا بدقته، استغلّت أميركا الإحصاء ذا العدد المنخفض في حملتها ضدّ أونروا، على أساس التشكيك بمدى صحة الأرقام المسجّلة لديها، وذلك بهدف تقليل مساهمات الدول المانحة في الموازنة الإجمالية للوكالة من ضمن الحصار الأميركي عليها، وتقليص عدد اللاجئين الفلسطينيين المحتمل عودتهم إلى أرضهم التي هجروا منها.
تلعب أعداد اللاجئين دورًا بالغ الأهمّية في الصراع مع الكيان الصهيوني، لذا عملت إسرائيل والإدارة الأميركية على تقليص عدد اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، وأبرزهم لبنان، فسعت إلى تعديل تعريف اللاجئ الفلسطيني وفق قوانين الوكالة، إذ تصنّف هذه القوانين اللاجئ والمنحدرين منه كلاجئين، كان السعي إلى حصر صفة اللجوء قانونيًا بالجيل الأول فقط، الذي خرج من فلسطين، وإسقاط صفة اللجوء عن المنحدّرين منه من أبناء وأحفاد، وبالتالي شطب ثلاثة أجيالٍ عن قوائم الأونروا ، بهدف تقليص عدد اللاجئين إلى بضعة آلافٍ من جيل النكبة، الذين غيّب الموت معظمهم.
لأنّ الفلسطينيين ليسوا مجرّد أرقامٍ، فقد كسبوا بصمودهم ونضالهم معركة الوجود والدفاع عن هويّتهم، مع ذلك لم تتبدّل السياسة الأميركية في محاولة وأد فلسطين والفلسطينيين، وذهبت لعقاب وكالة أونروا، إذ أوقعتها بين حدّي سيف التوطين أو التجويع، لكي تبقى إنسانية الفلسطيني مُنتَهكةً تحت الاحتلال، وفي بقاع اللجوء. أما أن يحظى اللاجئ بالحقوق الإنسانية والحماية التي تكفلها القوانين الدولية، فلا ينبغي أن يعني إحلالاً أو توطيناً، وهي المعادلة التي لم تتحقّق حتى الآن.