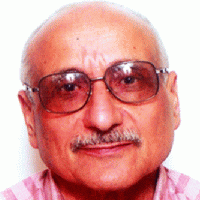02 أكتوبر 2024
لنتعلم الحكمة من ترامب
لم أكن قد شاهدت فيلم "الحارس الوحيد" (أو لون رانجر) الذي أنتج قبل ثلاث سنوات، لكنني رغبت بمشاهدته، بعد أن قرأت، في مقابلة صحافية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قوله إنه يرى في نفسه أسطورة تشبه أسطورة لون رانجر، وأن هذا ما جعله يفهم الحياة وكيف تدور. وأعترف أنني اكتفيت بمشاهدة مقاطع من الفيلم على "النت"، قبل أن أكتشف أنه من أفلام الأكشن والمغامرات التي لم تعد تشبع فضول عجوز مثلي.
يعرض الفيلم حكاية رجل قانون من ولاية تكساس، هو لون رانجر، الحارس الذي تودي به إحدى مغامراته إلى السقوط جريحاً في منطقة صحراوية، يتركه رفاقه فيها، حتى يوشك أن يموت من الإعياء والظمأ، إلى أن يعثر عليه مصادفةً رجل من هنود أميركا. هنا، ندخل في سلسلة أحداثٍ تسير في خطوط متعرّجة، سطو وقتل وموت، ومكائد ومؤامرات، حتى لا يكاد يخرج المشاهد بعد خروجه من العرض بشيءٍ ذي قيمة، لكن الشخصية المسيطرة التي تظل في الذهن هي شخصية "لون رانجر" الذي يسعى إلى تطبيق العدل، والذي يظل مقيماً في الصحراء، من أجل تحقيق هذا الهدف، مع رفيقه الهندي الذي أنقذه من موتٍ محقق.
ما يهمنا من الفيلم أن دونالد ترامب يضع نفسه مكان لون رانجر الذي فهم الحياة وكيف تدور. يريد من ذلك أن يوحي أن سعيه إلى الدخول في ميدان السياسة، بعد نجاحه في عالم الأعمال، هو من أجل تحقيق العدل، وإرساء سلطة القانون بالطريقة التي يراها بوصفه رجل أعمال ناجحاً، ومغامراً مهووساً. ومن هنا، جاءت دعوته إلى جعل أميركا من جديد قوية، ثرية، وآمنة، وقبل ذلك وبعده "أميركا فقط أولاً". لكنه، على ما يبدو، على الرغم من طموحه هذا، لا يريد التخلي عن شخصيته الشعبوية المتهورة، والمثيرة للجدل، أو شعوره المفرط بالتفوّق والعظمة، ولا يتطلع للحصول على ما يحقّق له دراية بالسياسة الخارجية وبالعلاقات بين الدول، أو فهماً بأمور الحكم، وهذا ما يجعل كثيرين، وبينهم رجال حكم وقادة رأي عام، يتخوّفون من نياته التي لم يستطع أحد التنبؤ بها بدقة.
والسؤال الذي ربما يظل مفتوحاً إلى حين: إلى أي حدٍّ يمكن أن يترجم ترامب خطاباته وسلوكه في حملته الانتخابية في عمله رئيساً للولايات المتحدة. هل يستطيع حقاً أن يكون صنوا للون رانجر الذي جعله مثله الأعلى، وأن يؤسّس لعالمٍ جديدٍ بعيدٍ عن الحروب والمؤامرات والمكائد والأحقاد؟ وهل تكفي لتحقيق هذا الهدف شعاراته "الشعبوية" وحدها التي تبدو كما لو كانت نسخةً من الشعارات التي سمعناها مراراً في عالمنا العربي من أفواه قادتنا الذين صنعوا لنا عالماً سحرياً متخيلاً، اكتشفنا خواءه. ولكن، بعد فوات الأوان، ولعل أصدقاءنا الأميركيين يكتشفون خواء عالمه السحري أيضاً. ولكن قبل فوات الأوان.
يعنينا، في هذه العجالة، موقفه من قضايانا نحن الذين وضعنا كل بيضنا في سلة أميركا من زمان، وتنازلنا لها عن ثرواتنا طوال عقود. تُرى، ماذا سيكون تأثير سياساتها وتوجهاتها الجديدة علينا؟
لن نلقي اللوم، كما فعل بعضنا، على أوباما الذي لم يعالج قضايا إقليمنا الملتهب، فلسطين وسورية والعراق وإيران والنفط، لسبب واحد هو أننا لا ننسى أن للولايات المتحدة مصالحها وأهدافها الاستراتيجية التي قد لا تتفق مع مصالحنا وأهدافنا، بل ربما تتعارض معها على نحوٍ مطلق، ولا ننسى أننا، نحن وليس غيرنا، من سلمنا أمرنا لكل الإدارات الجمهورية والديمقراطية التي تعاقبت من دون مقابل، وحوّلناها إلى مشجبٍ علّقنا عليه أخطاءنا وخطايانا بحق شعوبنا وأبناء جلدتنا. وكلما جاء رئيس جديد إلى البيت الأبيض، كنا نريد منه أن يرأف بنا، وأن يحمي قلاعنا، ويحارب أعداءنا، ويجتثّ خصومنا، فيما نحن عاجزون حتى عن تلمّس مواقع أقدامنا.
وهذا ما نطلبه اليوم من ترامب الذي أخذنا فوزه على حين غفلة، نستجدي عطفه في أن يلتفت إلينا، وأن ينشغل بقضايانا، ويبلغ بنا الأمر أن نمنّي أنفسنا بالزعم أن لديه رؤية تفصيلية لمشكلاتنا، ومشاريع متكاملة لخدمتنا، فيما نحن في حال عجزٍ وقصور، وقد صدمنا عندما أدركنا أنه ربما يتخلى عنا، ويتركنا وحدنا في العراء.
لا أظن أن ثمة سبيلاً لخلاصنا سوى أن نتعلم الحكمة التي أطلقها ترامب نفسه: "انتهى وقت الكلام الفارغ، ودقت ساعة العمل"، وإن كنا للأسف لا نحسن سوى الكلام الفارغ، ولا نملك القدرة على العمل.
يعرض الفيلم حكاية رجل قانون من ولاية تكساس، هو لون رانجر، الحارس الذي تودي به إحدى مغامراته إلى السقوط جريحاً في منطقة صحراوية، يتركه رفاقه فيها، حتى يوشك أن يموت من الإعياء والظمأ، إلى أن يعثر عليه مصادفةً رجل من هنود أميركا. هنا، ندخل في سلسلة أحداثٍ تسير في خطوط متعرّجة، سطو وقتل وموت، ومكائد ومؤامرات، حتى لا يكاد يخرج المشاهد بعد خروجه من العرض بشيءٍ ذي قيمة، لكن الشخصية المسيطرة التي تظل في الذهن هي شخصية "لون رانجر" الذي يسعى إلى تطبيق العدل، والذي يظل مقيماً في الصحراء، من أجل تحقيق هذا الهدف، مع رفيقه الهندي الذي أنقذه من موتٍ محقق.
ما يهمنا من الفيلم أن دونالد ترامب يضع نفسه مكان لون رانجر الذي فهم الحياة وكيف تدور. يريد من ذلك أن يوحي أن سعيه إلى الدخول في ميدان السياسة، بعد نجاحه في عالم الأعمال، هو من أجل تحقيق العدل، وإرساء سلطة القانون بالطريقة التي يراها بوصفه رجل أعمال ناجحاً، ومغامراً مهووساً. ومن هنا، جاءت دعوته إلى جعل أميركا من جديد قوية، ثرية، وآمنة، وقبل ذلك وبعده "أميركا فقط أولاً". لكنه، على ما يبدو، على الرغم من طموحه هذا، لا يريد التخلي عن شخصيته الشعبوية المتهورة، والمثيرة للجدل، أو شعوره المفرط بالتفوّق والعظمة، ولا يتطلع للحصول على ما يحقّق له دراية بالسياسة الخارجية وبالعلاقات بين الدول، أو فهماً بأمور الحكم، وهذا ما يجعل كثيرين، وبينهم رجال حكم وقادة رأي عام، يتخوّفون من نياته التي لم يستطع أحد التنبؤ بها بدقة.
والسؤال الذي ربما يظل مفتوحاً إلى حين: إلى أي حدٍّ يمكن أن يترجم ترامب خطاباته وسلوكه في حملته الانتخابية في عمله رئيساً للولايات المتحدة. هل يستطيع حقاً أن يكون صنوا للون رانجر الذي جعله مثله الأعلى، وأن يؤسّس لعالمٍ جديدٍ بعيدٍ عن الحروب والمؤامرات والمكائد والأحقاد؟ وهل تكفي لتحقيق هذا الهدف شعاراته "الشعبوية" وحدها التي تبدو كما لو كانت نسخةً من الشعارات التي سمعناها مراراً في عالمنا العربي من أفواه قادتنا الذين صنعوا لنا عالماً سحرياً متخيلاً، اكتشفنا خواءه. ولكن، بعد فوات الأوان، ولعل أصدقاءنا الأميركيين يكتشفون خواء عالمه السحري أيضاً. ولكن قبل فوات الأوان.
يعنينا، في هذه العجالة، موقفه من قضايانا نحن الذين وضعنا كل بيضنا في سلة أميركا من زمان، وتنازلنا لها عن ثرواتنا طوال عقود. تُرى، ماذا سيكون تأثير سياساتها وتوجهاتها الجديدة علينا؟
لن نلقي اللوم، كما فعل بعضنا، على أوباما الذي لم يعالج قضايا إقليمنا الملتهب، فلسطين وسورية والعراق وإيران والنفط، لسبب واحد هو أننا لا ننسى أن للولايات المتحدة مصالحها وأهدافها الاستراتيجية التي قد لا تتفق مع مصالحنا وأهدافنا، بل ربما تتعارض معها على نحوٍ مطلق، ولا ننسى أننا، نحن وليس غيرنا، من سلمنا أمرنا لكل الإدارات الجمهورية والديمقراطية التي تعاقبت من دون مقابل، وحوّلناها إلى مشجبٍ علّقنا عليه أخطاءنا وخطايانا بحق شعوبنا وأبناء جلدتنا. وكلما جاء رئيس جديد إلى البيت الأبيض، كنا نريد منه أن يرأف بنا، وأن يحمي قلاعنا، ويحارب أعداءنا، ويجتثّ خصومنا، فيما نحن عاجزون حتى عن تلمّس مواقع أقدامنا.
وهذا ما نطلبه اليوم من ترامب الذي أخذنا فوزه على حين غفلة، نستجدي عطفه في أن يلتفت إلينا، وأن ينشغل بقضايانا، ويبلغ بنا الأمر أن نمنّي أنفسنا بالزعم أن لديه رؤية تفصيلية لمشكلاتنا، ومشاريع متكاملة لخدمتنا، فيما نحن في حال عجزٍ وقصور، وقد صدمنا عندما أدركنا أنه ربما يتخلى عنا، ويتركنا وحدنا في العراء.
لا أظن أن ثمة سبيلاً لخلاصنا سوى أن نتعلم الحكمة التي أطلقها ترامب نفسه: "انتهى وقت الكلام الفارغ، ودقت ساعة العمل"، وإن كنا للأسف لا نحسن سوى الكلام الفارغ، ولا نملك القدرة على العمل.