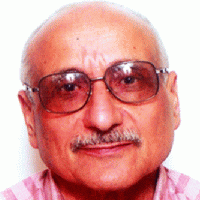سؤال الفساد الحاضر دائماً في العراق
لا يكاد يمرّ يوم في العراق من دون أن يحضر سؤال "الفساد"، ليس في الصحف ووسائل التواصل فحسب، وإنما في الإدارات الحكومية، وفي الشارع العراقي، وحتى في مكاتب كبار المسؤولين الذين يضعون خططا على الورق، ويشكّلون لجانا تلد لجانا، ويدبّجون تقارير عن منجزاتهم، سرعان ما يظهر زيفها، وينهمك رجال القضاء في إصدار أحكامٍ لا تجرّم السارق، ولا تعيد ما سرق. وعلى امتداد الأعوام العشرين، كلما ولدت حكومة لعنت سابقتها، وتعهّدت بمراجعة ملفات الفساد ومعاقبة الفاسدين، لكن لا شيء يحدُث، ولا أحد يتجرّأ ويرفع الصوت. ويظل الفاسدون، بالأخص الحيتان الكبار منهم، في مأمن، وفي حرز حريز. ولا تقوى الدولة (هل هناك دولة حقّا؟) على رفع الأصابع بوجوههم مع أنهم معروفون، وبعضهم بلغت به الوقاحة حد التصريح، جهارا نهارا، أنهم شاركوا في اقتسام "الكعكة"، لأن الكل يفعل هكذا، وإذا كان أمرهم كذلك فكيف يمكن، إذن، محاسبتهم على ما اقترفوه؟
هكذا تدحرج سؤال الفساد هذا، ليصبح ظاهرة لم تتردّد ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، في اعتبارها "سمة أساسية في الاقتصاد السياسي في العراق، وجزءا من المعاملات اليومية، ولا يوجد أي قائد (سياسي) في منأى عنها". وكان رئيس الجمهورية السابق، برهم صالح، قدّر حجم الأموال المنهوبة بنحو 150 مليار دولار، فيما قال خبراء اقتصاديون إنها بلغت في سنوات العقد الأخير ما يتراوح بين 350 و600 مليار دولار، ووثقت تقارير رسمية بلوغ عائدات النفط في الأعوام العشرين الأخيرة تريليونا وثلاثمائة مليار دولار، لكن لا أحد يعرف إلى أين ذهبت، واتهمت هيئة النزاهة المعنية برصد حالات الفساد في المؤسّسات والإدارات الحكومية 11 ألف مسؤول حكومي رفيع، بينهم 54 وزيرا، بالتورّط في جرائم الفساد، لكنها لم توفق في محاسبتهم، باستثناء عدد قليل جدا منهم؛ حوكموا غيابيا بعد هروبهم إلى خارج البلاد، ثم صدرت قرارات بالعفو عنهم نتيجة تدخّل جهات عليا متورّطة معهم أو لأغراض انتخابية وسياسية، وعادوا بعد ذلك سالمين غانمين، واقتحموا المعترك السياسي من جديد، وكأن شيئا لم يكن. ولم يعد المواطن العراقي في وارد الثقة بما يقال له، وهو يعرف تماما أن حصوله على خدمةٍ يفترض أن توفرها الدولة له ينبغي أن يقترن بدفع "المقسوم" كي يضمن تلبية طلبه أو إنجاز معاملته، وإلا ليس له سوى الوقوف في طابور الانتظار إلى أن يزهق ويعود خائبا وهو يلعن الساعة التي قرّر فيها البقاء في البلاد التي أذلّته وأرهقته وتحكّمت فيه، وسلبته أبسط حقوق المواطنة التي يحصل عليها الآخرون في بلاد الله.
لقد "اتّسع الخرق على الراتق"، ولم تعد الحلول المطروحة لمكافحة الفساد مجدية، بل ربما ساعدت على نمو تطلّعات غير مشروعة لدى كثيرين من صغار العاملين في الدولة للدخول في نادي "الحيتان الكبار"، ولو عن طريق إرغام المواطنين على دفع "الإتاوات" و"الرشوات" مقابل تطمين حقوقهم، أو التواطؤ مع شركات ورجال أعمال وتجار لإرساء قاعدة منافع متبادلة، أو تزوير وثائق ومستندات لإكساب معاملات معينة شكلا قانونيا يضمن الحصول على منافع شخصية.
يظل الفاسدون، بالأخص الحيتان الكبار منهم، في مأمن، وفي حرز حريز، ولا تقوى الدولة على رفع الأصابع بوجوههم مع أنهم معروفون
وفي واقعة واحدة من مجموعة وقائع، أعلمتنا "هيئة النزاهة" أنها قبضت على موظف صغير يعمل في دائرة الجمارك في منفذ حدودي تضخّمت ثروته إلى 38 مليار دينار، وأصبح مالكا مستشفى خاصا وعقارات، وأرصدة في بنوك خارجية بالمليارات، لكن "الهيئة" لم تقل لنا كيف تسنّى لهذا الموظف الصغير الذي لا يتجاوز مرتبه أكثر من بضعة آلاف من الدنانير أن يقبض على هذه الثروة، ويتسلّل إلى نادي "الحيتان الكبار" من دون أن يكون له سند من "حوت" كبير ضمن له التسلّل بأمان، ومن دون خشيةٍ من عقاب؟
وقد لا تعرف "الهيئة" أيضا أن فعل القضاء في هذه الحالة لن يكون أكثر مما فعله في قضية الأمانات الضريبية التي عُرفت باسم "سرقة القرن" التي وعدنا رئيس الوزراء، محمد شيّاع السوداني، في حينه، بأن بطلها نور زهير سيعيد المبلغ المسروق كاملا (3.7 تريليونات دينار) خلال أسبوعين مقابل إطلاق سراحه، ثم مرّت سبعة أشهر على هذا الوعد، لكن المبلغ المستردّ لم يتجاوز بضعة ملايين من الدنانير، فيما سافر "البطل" إلى الخارج، ليقيم هناك آمنا مطمئنا، حتى من دون أن يكشف عن أسماء "الحيتان" المتورّطة معه، وعفا الله عما سلف!
وقد يبدو كل هذا الكلام أشبه بمزحة الروائي الفرنسي، ميلان كونديرا، التي تحوّلت إلى مصيبة، لكن حالنا الماثل يعدنا بمصائب أدهى وأمرّ.