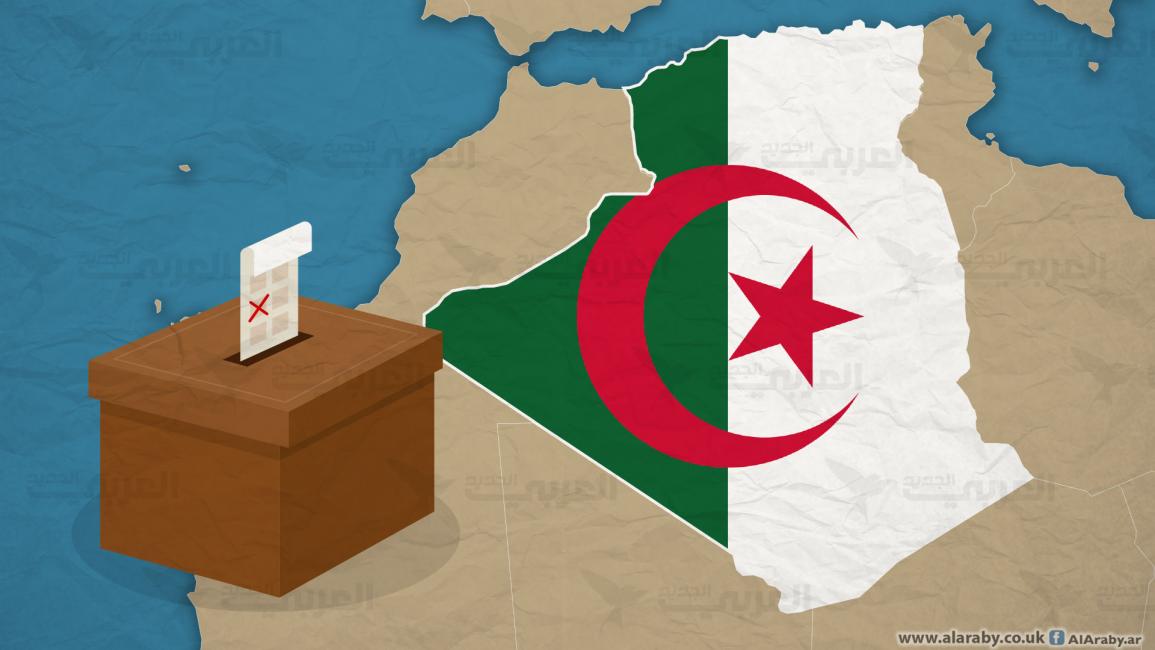التشريعيات الجزائرية تحت المجهر
لا يمكن البرلمان المقبل في الجزائر إلا أن يكون مغايراً لسابقه الذي حُلَّ، ولا يمكن إلا أن يكون ممثّلاً للجزائريين، حقّ التّمثيل، على عكس ما كان عليه السّابق. ولكن، وهنا مربط الفرس، تلك أفكار في مخيّلة النّاخبين في الجزائر، بل واحدٌ من أحلامهم لتجسيد التّغيير المأمول، وبناء مؤسّسة تشريعية تمثيلية، حقّاً لا مجازاً. لفهم ما سيجري في الجزائر، في 12 يونيو/ حزيران الحالي، يجب العودة إلى البرلمان، المؤسّسة التّشريعية، فرضاً، كما أرادته السّلطة، على الأقلّ بين أعوام 1997 و2017، وهي خمسة اقتراعات جرت بمقاربة عجيبة، انتهت، دائماً، إلى حقيقتين: عزوف من النّاخبين، ووصول نوابٍ إلى قبّة البرلمان بطرق لا يمكن وصفها بالانتخاب، بل، حيناً، بالكوتا (النّسبة المختارة سلفاً وفق اعتبارات بعيدة عن الانتخاب الديمقراطي)، وأحياناً أخرى، بدرجة القرب من دائرة الموالاة، قلب النّظام وهوامشه، أو البعد عنها، أي الاصطفاف مع المعارضة.
بالنتيجة، لم تكن المؤسّسة، منذ استقلال الجزائر، ألبتّة، نتاج انتخابات حرّة ونزيهة، حيث اعتادت السّلطة اتخاذها واجهةً للتشريع، بل وصل الأمر إلى وصفها بالمؤسّسة التي يجري شراء المقاعد فيها بأكياس النقود، وانتشرت أخبار عن مستوى النواب، مروراً بفضائح شهدنا فصولاً عنها في عهدات الرّئيس السّابق، عبد العزيز بوتفليقة، من أنها مؤسّسة لرفع الأيدي، خصوصاً لتعديل الدّستور، مرّة بعد مرّة، قصد السّماح بإطالة العهدات الرئاسية من عهدتين إلى أكثر من ثلاث، أربع ثم، لولا حراك 2019، إلى خامسة، أي حكم مدى الحياة. إذا كان الأمر كذلك، فثمّة حاجة ماسّة، في إطار الإصلاح الذي تريد السُّلطة إدخاله على النّظام السّياسي، تركيبة ومؤسّسياً، لتحقيق فعّالية أكبر، في إطار الشّفافية والنّزاهة الكاملتين، إلى برلمان يكون قويّاً من مسار اختيار المرشّحين، إلى الحملة الدّعائية، وصولاً إلى قبول الجزائريين بالانخراط في العملية الانتخابية، عن اقتناع، وانتهاءً بتغيير الصُّورة النّمطية للمؤسّسة، ثم الوصول، حقّاً، إلى إنتاج مؤسّسة تشريعية فعّالة، ناجعة وناجحة.
سمح قانون الانتخابات الجديد ببعض المدخلات، سعياً منه إلى تغيير واقع استخدام آلية الانتخاب للوصول إلى تبوّء المسؤوليات
ننطلق من قانون الانتخابات الذي أُقرّ، أخيراً، حيث إنه قد يستجيب، نسبياً، للمطلوب، أي إنتاج برلمان قوي، لكن المشكلة أنه يبقى قانوناً شكلياً يحتاج إلى إصلاح يرافقه، بالتوازي، حتى يتم معه، وهو لبّ الإشكالية في العملية الإصلاحية للنظام السياسي الجزائري، تجديد النخبة السياسية بعد إقرار النّظام أنّ الطّبقة السّياسية التي كانت تعمل في ظلّ النّظام السّابق هي المشكلة، من حيث فسادها، شكل خطابها السّياسي ومضمونه، إضافة إلى لعبها دور الواجهة لنظامٍ لم يكن فعالاً ولا ناجعاً، البتّة، منذ انتخاب البرلمان في 1997 ثمّ، تباعاً، أربع مرّات، منذ 1999، العام الذي وصل فيه بوتفليقة إلى سُدّة الحكم، رئيساً للبلاد.
سمح القانون الجديد ببعض المدخلات، سعياً منه إلى تغيير واقع استخدام آلية الانتخاب للوصول إلى تبوّء المسؤوليات، لكنّه لم يكن مصحوباً، في الوقت نفسه، بالتجديد المطلوب للنخبة بإصرار النظام على اعتبار خريطته السياسية الوحيدة التي يجب الاعتماد عليها، إضافة إلى أن قرارها إقصاء النّخبة السّياسية السّابقة تمّ بمقاربة انتقائية، في بعض الأحيان، بالسماح لبعض الوجوه بالبقاء في قلب النظام السياسي وهامشه، وبإقصائية، أحياناً أخرى، بالإبعاد، من خلال منع الترشّح لأكثر من عهدتين في البرلمان المقبل، أو بالمتابعات القضائية لمن ثبت، في حقّهم، الانخراط في قضايا فساد. هنا، وجدت تلك النّخبة السياسية مخرجاً باللّجوء إلى الأبناء، مثلاً، لبعضهم، لضمان استمرار الوجود السياسي، أو تضمين القوائم الحزبية أسماءً لا تُنبئ بأنّها ستكون ذات تمثيل سياسي ثقيل، أو صوت سياسي يسائل، يراقب ويشرّع، وفق ما تحدّد، في القانون، من مهام للبرلماني. لم تتدخّل السّلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات، وهو ما يخوّله لها القانون، عبر المراقبة القَبْلية للقوائم، قبولاً ورفضاً، لمنع حصول هذا الأمر، ليقوم الإعلام، عوضاً عنها، بإبلاغ الرّأي العام بهذا التّلاعب بقانون الانتخابات، وهو ما ينذر بعزوف انتخابي كبير، أو يقرّب الواقع السّياسي الجزائري من شبح برلمانٍ يكون في مستوى البرلمانات السّابقة، مجرّد واجهة أو غرفة للتّسجيل، كما سمّاها الجزائريون، على مرّ العقود السّابقة.
يغيب التّنافس بين المرشّحين، حيث تفتقر الخريطة السياسية الجزائرية إلى برامج بوزن مشاريع مجتمع، تقصد التغيير، وتهدف إلى تعويض القصور
لن يجري الحديث هنا عن الحملة الدّعائية التي أبانت عن مستوى المرشّحين السياسي، ولا عن الشّعارات التي وُسمَت القوائم الانتخابية بها، وهو ما يخبرنا عن إشكالات ثلاثة وقعت فيها النّخبة السّياسية التي قبلت الانخراط في الانتخابات، أو المستقلّون الذين يريدون الوصول إلى البرلمان. تشير الأولى إلى ضعف مستوى النخبة السياسية في التواصل ومفردات التسويق السياسي الذي يحتاج خبراء، قصد اختبار الشعارات، شكل الخطاب ومضمونه، وفق معطيات الجمهور المستهدف، والوصول إلى عقول متلقي ذلك الخطاب وقلوبهم. الإشكالية الثانية، ضعف استخدام الإعلام البديل، بنشر محتويات إبداعية تستلهم التحدّي، الأمل والعمل المستقبلي للمرشّحين، حتى يقتنع المتلقي بنجاعة العملية السّياسية المقبلة، وبثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه لاختيار الأجدر للبرلمان. وبغياب ذلك، انتشر التهكّم على وسائل التّواصل الاجتماعي على مستوى المرشحين، وفراغ خطابهم الدّعائي، ما يمكنه إقناعهم لتغيير آرائهم بشأن حيوية الانتخابات المقبلة.
أمّا الإشكالية الثالثة، فهي متّصلة بغياب التّنافس بين المرشّحين، حيث تفتقر الخريطة السياسية الجزائرية إلى برامج بوزن مشاريع مجتمع، تقصد التغيير، وتهدف إلى تعويض القصور المسجل على مستويات السياسات العامة للبلاد على الأصعدة كافة، وقد يرجع ذلك إلى رفض النّظام التّواصل مع الحراك، من جهة، ورفضه، هو أيضاً، تنظيم نفسه، وهيكلة تياراته السّياسية أو الانخراط في العملية السّياسية الحالية، ما أفقد هذه الحملة الدّعائية، بسبب ذلك كله، النقاش السّياسي الذي كان من الممكن أن يمنحها اهتماماً أكبر، وربّما كان سيوصلها إلى معالجة القصور الملاحظ على شكل الخطاب ومضمونه، ومقاربة غياب استخدام التسويق السياسي وبالمقاربات المستحدثة، خصوصاً الافتراضية منها، لإقناع النّاخب بضرورة المشاركة لإحداث التّغيير المأمول، ولو بصفة جزئية، لأنّ السّياسة فن الممكن، وما لا يُدرك كله لا يُترك جُلُّه.
لحظات حرجة من حياة الأمة، يشارك الجميع في رفع تحدّي مواجهتها بالرّأي والرّأي الآخر، في كنف ثوابت يلتزم بها الجميع
لم تعرّج المقالة، قصداً، على الإشكال الذي نشاهد تواصله بإقصاء فصيل كامل من الطّبقة السّياسية ممن لا يقبل بخريطة السُّلطة لمخارج الأزمة التي بدأت في فبراير/ شباط من عام 2019، من التعبير عن آرائهم، حيث أغلقت بل أوصدت، تماماً، بلاتوهات القنوات، العمومية منها والخاصّة، عن نقاشٍ كان يمكن أن ينتج منه التّقارب وتبادل الرُّؤى، بل وتصحيح أوجه القصور الملاحظة لدى الجميع، بدون استثناء، وهو الواقع الذي لا يزال الهدف منه غير مفهوم، ذلك أنّ طبيعة الأزمات أنّها لحظات حرجة من حياة الأمة، يشارك الجميع في رفع تحدّي مواجهتها بالرّأي والرّأي الآخر، في كنف ثوابت يلتزم بها الجميع، وليس بمقاربة الغلق الكامل لوسائل الإعلام أمام المقاطعين أو المتردّدين في المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، ما فتح الباب، واسعاً، أمام سحرة الإنترنت والمغرضين لملء الفراغ، حيث، كما يقول المثل، الطبيعة تخشى الفراغ.
تلك هي الأفكار التي كان يجب اتخاذها مدخلاً للتّفكير في إجراء هذه الانتخابات، لأن الجزائر تستحقّ أكثر، وتجاربها السياسية تسمح لها بالأمل في ما هو أكبر وأنجع وأكثر رشادة مما قُدّم، ويتمّ تقديمه من خطاب سياسي أو مؤسّسة تشريعية، نعلم مقدّماً، بسبب ما ذكر أعلاه، أنّها ستبقى تؤدّي المهام نفسها.
ما زال كاتب هذه السطور، في كل مقالة ينشرها، ينادي إلى عمل سياسي رصين ومقنع، بمقاربات ذات كفاءة. ولهذا الأمل معقود على برلمانٍ نريده قوياً بنبذ أوجه القصور المشار إليها، وبتعقّل الجميع بوجوب الحوار، من الكلّ، سلطة ومعارضة، أيّا كانت، ثم بوجوب التّنظيم والانخراط في العملية السياسية برمّتها ومن الجميع، أيضاً، بقصد إنجاحها واقتناع الجميع، بأنّهم معنيون بالمشاركة، بالاقتراح وبالتفكير في مصير البلاد المقبلة على تحدّيات: استمرار أسعار النفط في الانهيار، تناقص المخزون النقدي، انخفاض قيمة الدينار، ارتفاع نسب البطالة، فشل تجسيد البناء التّكاملي - الاندماجي المغاربي ودور جواري وإقليمي، ليس في مستوى قيمة الجزائر الإستراتيجية والجيوسياسية، إضافة إلى عدم إنهاء إشكالية الذّاكرة مع عدُّو الأمس واليوم، فرنسا، وهو رهان رأس أولويات مشروع جزائر المستقبل، حقّاً لا مجازاً، لأنه من سيخرجنا من قوقعة التبعية، ويجعلنا ننطلق في رحاب مشروع تبوّء مكانة إقليمية كبيرة بأذرع مغاربية، نوازن بها تأثير الشُّركاء والأعداء، من كلّ حدب وصوب، على حدّ سواء.