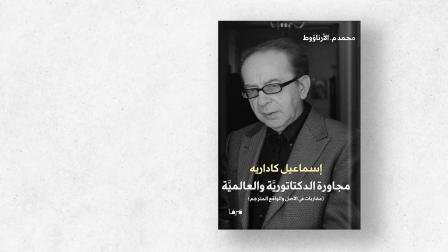كنتُ تقدّمت لسَكَن اللجوء من قبل ورفضوا الطلب. ولمّا تسلّمت آدا كولاو منصب العمادة، خلعَ موظّفو الصليب الأحمر و"سيار" نظاراتهم السوداء وعوضاً عنها ركّبوا ميكروسكوبات.
والحال أنني وزملاء انتقلنا، دفعة واحدة، من الرصيف إلى حيّ "ساريّا" الفخم (لا إلى "كمب احتجاز" كما قد يخُيّل إلى ذاكرة بعض القرّاء من ذوي السوابق). ليس هذا فحسب، بل إننا واقعاً لا مجازاً، نسكن ديراً قديماً للراهبات أشبه بقصر في قلب المنتجع الجبلي.
وبما أنه قصر، فإن أخلاطاً من رفاق ورفيقات الرحلة يتشاركون حيّزَه الواسع. وقد شاءت الصدفة أن يكونوا من فنزويلا والسلفادور وأفغانستان والنيجر وسيريلانكا وأوكرانيا، بينما الحراس من شرق المتوسط.
لقد أتممت إجراءات الدخول، وما إن تسلّمت الغرفة وخلوت بنفسي حتى شرعت في الابتسام. ذلك أننا الآن على مبعدة دقائق، من المبنى الذي أقام في طابقه الثاني غابرييل غارسيا ماركيز. وأنا كلما تذكرت الحال وقارنت، شعرَت بالمفارقة. فمن حضرتنا كي نسكن هذه السكنى بينما الزميل المسكين "غابو" سكن عمارةً ممسوحة الملامح؟
على أن ثمة جامعاً في هذا التجاور الهرطوقي لا علاقة له بالأدب: غابو أقام كمهاجر لا كأديب، ونحن شرحُه.
والأهم مما سبق، أن سيد الكتابة اللاتينية أبدعَ هنا خمساً من قصصه القصيرة، إضافة إلى رواية بالطبع. فهل سيكون المأوى ـ أو العُشّ المخفيّ وسط غابة الأرز ـ فألَ خيرٍ على كتابتي؟ سيما لا إنترنت في الغرفة ـ وغير تغريد الطيور، ما من صوت؟
على كل حال، لقد حللت هنا ببركة دعاء الوالدين الراحلين، وبعزيمة الرفيقة الشابة آدا، لا فقط كي أضطر لخيانة انحيازات عمرٍ مؤقتاً (فأتفخفخ غير شِكِل)، بل أيضاً كي أسترخي وأبتعد وأتأمل.
إنها التجربة الأولى والأخيرة مع سُكنى القصور (أللهم هذا كاف). تجربة ستمتد إلى ستة شهور وربما تسعة. ولسوف أكتبها إن اكتملت، لكني أحسّ منذ اللحظة بإحساسات ممضّة مؤدّاها أن كل قصر في جوهره، هو قفص ذهبي مع أرتال من السأم والملل.
على الأقل هذا ما ألمحه جلياً في وجوه الدجاج السابق. وليس ثمة ما يمنع من تكراره مع ديك مثلي، خاصة بعد أن جلست مطوّلاً مع المديرة، فقوقأت عليّ بممنوعاتها، حتى كدت أُجنّ فأقلب لها ظهر اللجَن على المطرح.
إني لا أنسى قصة صاحبي الشاعر الذي دُعي لإقامة أدبية في أميركا فمنعوه التدخينَ حتى في الشارع، فما كان منه إلا أن قطع الزيارة وعاد إلى بلده كي يدخّن براحته.
تُراي سأكون أدنى منه جرأة، وقد فهمت للتو بوضعي ـ كما غيري ـ تحت عيون العسس؟
ها أنا أبتسم. ها أنا أُدندن: "من الرصيف جئت وإلى الرصيف أعود".
ولن أكون يوماً أقلّ نزقاً من صاحبي. ذلك أن حالي أفدح من حاله. هو لم يحتمل ممنوعاتهم مدة يومين، فكيف سأحتملها أنا شهوراً؟