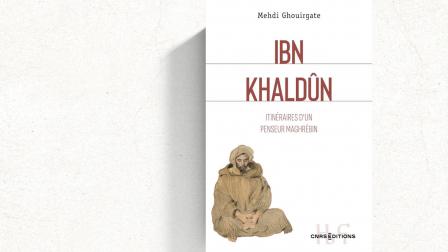من البعيد يبدو أنّ هناك غرفة في النافذة،
والباب ناطور تسلّم عليه فيفتح لك وتدخل،
إنّها غرفة معتمة لا شيء فيها يوحي بأنّ شاعراً عاش هنا ولم يكن يملك كرسيّاً ولا طاولة ولا ورقة
وكتبَ قصائده على الهواء وبالطبع لم ينشر قصيدة واحدة.
الرّجفةُ في يديه والرّيحُ على كتفيه، لذلك كان ينطفىء عودُ الكبريت قبل أن ينجح في إشعال سيجارته.
وذات فجر أزرق فاتح،
كان هذا الشاعر متّكئاً على النافذة كعادته،
فسحبَه أوّل شعاع شمس لامس السماء فيما كانت ظلال آخر المساء تزحف خارج الغرفة.
لم يجدوه،
وجدوا على الجدران ظلَّه المُجنَّح كطير هارب تحت البرد،
وبقايا كلمات
اعتاد أن يربّيها بحنان فائق لكن ما إن كان ينبت لها ريش حتّى تطير،
اعتاد أن يُخرجها يوميّاً من بين عظامه
وتكون عادةً هشّة عطوبة فيتسبّب أغلب الأحيان في كسرها أو خلعها
ممّا كان يجبره على الاعتناء بها لأشهر طويلة، ينقلُها في سيّارة إسعاف صغيرة جدّاً ليوقفَها في الفسحة الضيّقة بين الحلم والطيف، بين الرقّة والعاطفة
إلى أن تتعافى.
كذلك كان يقتني عدداً لا بأس به من المكانس والمجارف والعربات ذات الدولاب الواحد
لالتقاط ما تساقط من بقايا تلك الكلمات فوق الأرضيّة الخشب،
وثنايا الروح،
وخفايا القلب،
وعين الأفق المكتحِلة بالمغيب.
وبالرّغم ممّا كان يقوم به
لم تكن تعرف تلك الكلمات أن تهدأ، ولو للحظة واحدة
بل كانت تغلي وتفور باستمرار
فأمضى عمرَه يأخذها ويصفّها أمام مدخل العالم، وورقة على زجاجها: مركونة للتبريد.