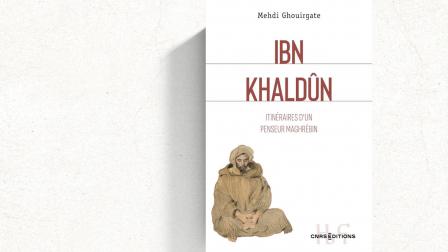لا يدري المرء متى بدأ مثقفون عرب (وأنا أتعمد حذف أل التعريف كي لا يكون الكلام عاماً، ونقول المثقفون العرب)، في النظر إلى أنفسهم على أنهم مجرّد تابعين، وملحقين ثقافيين في جمهوريات وملكيات العالم العربي؟ وهي نظرة غريبة تطرح الكثير من التساؤلات الفكرية، والوجدانية، والأخلاقية، عن طبيعة العلاقة التي يحكمها اتجاه واحد فقط، ذاهب من السياسي نحو المثقف، دون أن يرتد مرة واحدة في الاتجاه المعاكس. وما يتردد في الأوساط السياسية والثقافية العربية من أن جمال عبد الناصر قرأ "عودة الروح" لتوفيق الحكيم، وتأثر بها، لم نجد معادلاً له في الممارسة السياسية لنظام حكمه.
لا يستشهد أي سياسي عربي في خطبه، وأقواله البتة، بأي جملة أو عبارة لمثقف، أو كاتب عربي، مهما كانت قيمته الأدبية الإبداعية، على الصعيد المحلي، أو العالمي. وعلى الرغم من أن نجيب محفوظ نال جائزة نوبل، فلم أسمع أو أقرأ أن سياسياً عربياً، أو مصرياً، تباهى أنه قرأ له رواية ما، أو ضمّن كلمة ما من مجمل نتاجه الروائي قط. كأن الحاكم يرغب في محو المثقف، أو تجاهل وجوده، وكان يفعل ما يريد، تاركاً للكاتب هامشاً صغيراً للتعليق على ما يحدث، يعادل ما يراه هو من قيمة للثقافة. وفق أجندة معدة بإتقان تقتضي أن يكون التعليق مناسباً، ومهذباً، ومشغولاً بسنارة الممالأة، أو الحذر والغموض.
وفي المقابل فقد راح الكاتب العربي، يزجي الكلام المنمق لتحية السياسيين، وخاصة منهم رؤساء الدول وملوكها، وفي المؤتمر الأول للكتاب العرب المنعقد في بلودان السورية عام 1956 كلف المجتمعون طه حسين بإلقاء كلمة الافتتاح التي حضرها رئيس الجمهورية السورية آنذاك، فقال في الكلمة مخاطباً الرئيس: "إني لأسعد الناس حين يتاح لي أن أتحدث إلى هؤلاء الزملاء بمحضر فخامتكم، فهذا شرف عظيم (لاحظوا الجملة التالية) أظنني أقل من أن أستحقه". وهو كلام غريب، فضلاً عن روح الاستخذاء والركوع التي يضمرها، يجعلنا نتساءل: لماذا يجد الكاتب أنه لا يستأهل "شرف" التحدث أمام رئيس للجمهورية؟ كان الكاتب آنئذ عميداً للأدب العربي، وكان الرئيس (شكري القوتلي) قد عدل دستور سورية كي يعاد انتخابه.
وكتب نزار قباني يقول قبل حرب الخليج: "لقد جئت إلى بغداد مكسوراً، فإذا بصدام حسين يلصق أجزائي، وجئت كافراً بممارسات العرب، فإذا بصدام حسين يرد إلي إيماني، ويشدّ أعصابي.. شكراً (مرة أخرى؟) لصدام حسين، الذي قطَّر في عيني اللون الأخضر".
وقد أظهرت السنوات الخمس الأخيرة في العالم العربي، كيف تواطأ عدد من المثقفين العرب، مع أنظمة الطغيان، في ظاهرة غريبة من التراجع وإدارة الظهر لقيم كانوا هم من نادوا بها، أو آمنوا بها. تصل الوقاحة حدوداً لا مثيل لها، حين يتحوّل المثقف من منافق، إلى مزوّر، يتمكن من وضع "أذن" النظريات في المكان الذي يريده من "جرّة" الوقائع. أما القطعة الناقصة هذه الأيام فهي أن يقول المثقف أن مديحه للبوط العسكري، أو الدفاع عنه، "شرف" لا يستحقه.