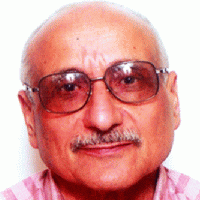06 نوفمبر 2024
درب "الصدّ ما ردّ" والهوية المتشظية
محض مصادفة أن أقرأ رواية الألماني ب. ترافن، "سفينة الموتى"، التي نقلها لنا إقبال القزويني، وأنا أتابع على الشاشات مسيرة سفن الموت، التي تضم غالبيتها سوريين وعراقيين، تشظت هوياتهم، وانكفأت أقدارهم، وتلاقت حظوظهم، على الشواطىء الرملية، أو في قيعان البحار، مع حظوظ غيرهم من بؤساء العصر القادمين من بلدان شموس أفريقيا الحارة، وما عادوا يذكرون عروبتهم بالخير، بعدما أنكرتهم عروبتهم.
وكلما نظرت مليا في الوجوه التي تظهر أمامي، كنت أجد فيها وجه جيرالد غايل، البحار الذي أبحرت السفينة من دونه، لأنه لم يعد، بالنسبة لقبطانها، سوى "فائض عديم النفع، مجرد مسمار قديم نزع من مكانه، وبقي مرميا"، وعليه الآن أن يدبر أمره بنفسه، وحيث أنه لم يكن يمتلك أوراقاً تثبت انتماءه إلى وطن، كما كان رجال الحكومة يجابهونه دائما، فما عليه إلا أن يخوض نضاله الخاص للحصول على وطن، وطن يضمن له "فطوراً من الجبنة واللحم المقدد"، ونوماً مليئا بالأحلام على ظهر سفينة مبحرة إلى عالم آخر.
وفي تراجيديا التيه العربي، المعروضة أمامنا على الشاشات، يتحول عيلان، ذو السنوات الثلاث، إلى "غايل" صغير، أعطى نفسه للبحر قرباناً لوطن لم يعترف به، وقد لفظه البحر لينكفئ على الشاطئ الرملي الغريب عنه، وكان المهيمنون على أقدارنا، حكاما ومعارضين، أوشكوا أن يقضوا عليه، باسم "الدولة الوحش التي تسلب الأمهات أولادهن، لكي ترمي بهن قرابين للطغاة"، لكن عيلان كان يريد كوباً من الحليب، وحبة دواء واحدة، ولذلك هرب، كان يبحث عن "هوية" تقر بانتمائه إلى أوطان الحياة، لا إلى أوطان الموت، لكن الموت لاحقه، تشظت هويته ساعة احتضنه الشاطئ الغريب، ليصبح مواطناً عالميا، ملء القلب والسمع والبصر.
القبائل التي أنكرته وهو حي نسبته إليها وهو ميت، لتكسب شرف التضحية، لكنها لم تكسب
سوى العار، وزعت دمه، وهويته، فيما بينها، زعمت واحدة أنه سوري، وقالت أخرى إنه عراقي، وقالت ثالثة إنه فلسطيني، ورابعة إنه كردي، وأقحمت وكالة أنباء غربية لغتها في اسمه، اخترعت له اسم آلان، وصحيفة قالت إن اسمه إيلان، لكنه لم يعرف لدى خالقه بسوى كينونته إنساناً.
الآلاف مثله، كبار، صغار، نساء، رجال، هجروا أوطانهم الأولى، هل كانت لهم "أوطان" حقاً وقد تسيّدها اللصوص والقتلة وبائعو الضمير؟ أولئك الآلاف تشظت هوياتهم على شواطئ البحار، أو في قوارب مافيات التهريب، عرب أنكرتهم عروبتهم، قال عنهم واحد من بائعي الضمير "إنهم هجروا بلادهم، لأنهم يعانون نقصاً في التربية الوطنية". آخر طالب بإعادتهم، و"الأبواب كلها مفتوحة أمامهم"، يقصد أبواب الموت الزؤام الذي تعدّدت أشكاله وصوره، ولم يكف ثالث عن الصراخ: "وطننا لا يحتاجهم، فليذهبوا"، يقصد وطنه هو الذي يستأثر بهويته، وثروته، وسلطته. كاتب عربي زاد: "أما كان بإمكان والد عيلان أن ينقل أسرته بالطائرة إلى أوروبا، ويجنبنا المشاهد الأيقونية الصادمة؟"
الرؤساء والملوك العرب لم يرفّ لهم جفن، وربما لم يسمعوا بالواقعة، وحده الرئيس التركي، الطيب أردوغان، كتب معزّياً: "ليتكم لم تبحروا، وكنتم ضيوفنا". زعماء وقادة غربيون تعاطفوا مع محنتنا، وفعلوا الكثير من أجلنا، لكننا شتمناهم، لأنهم أوقدوا نيران الحروب في بلداننا، وكانوا السبب في هجرة أبنائنا، وأنكرنا أن حكامنا يتحملون خطايا الحروب سواء بسواء مع أولئك، تعلمنا أن نعلق خطايانا على مشاجب المؤامرات، التي يحوكها خصومنا ضدنا، ونغض الطرف عما فعلناه بأنفسنا.
تحدث آخرون عما أسموها "بشاعة صورة الطفل عيلان"، لأنها تثير الاكتئاب لدى من يشاهدها، ولاموا المصورة التي التقطتها. للأسف، لم يعد البحر ينتج صوراً رومانسية عن لقاء محبين، لأننا لا نستحقها. هذا عصر الوحشية والبشاعة وانعدام الضمائر، والصور التي تعرض أمامنا على الشاشات هي لنا، نحن وحوش العصر، وقد نافسنا وحوش الغاب في خطايانا، ومن منا بلا خطيئة؟ أقل خطايانا أننا صفقنا لطغاتنا عقوداً، ولم نعترف بمآثرهم إلا عندما رمونا في البحر، وعندما لفظتنا البحار على رمال شواطئها، أدركنا أننا مجرد مسامير قديمة، نزعت من مكانها، وبقيت مرمية.
عيلان، والآلاف معه، وربما سيصبحون ملايين، راحوا في "درب الصدّ ما ردّ"، ولم يبق منهم سوى بقايا هويات متشظية، ملقاة على رمال الشواطئ الغريبة.
وفي تراجيديا التيه العربي، المعروضة أمامنا على الشاشات، يتحول عيلان، ذو السنوات الثلاث، إلى "غايل" صغير، أعطى نفسه للبحر قرباناً لوطن لم يعترف به، وقد لفظه البحر لينكفئ على الشاطئ الرملي الغريب عنه، وكان المهيمنون على أقدارنا، حكاما ومعارضين، أوشكوا أن يقضوا عليه، باسم "الدولة الوحش التي تسلب الأمهات أولادهن، لكي ترمي بهن قرابين للطغاة"، لكن عيلان كان يريد كوباً من الحليب، وحبة دواء واحدة، ولذلك هرب، كان يبحث عن "هوية" تقر بانتمائه إلى أوطان الحياة، لا إلى أوطان الموت، لكن الموت لاحقه، تشظت هويته ساعة احتضنه الشاطئ الغريب، ليصبح مواطناً عالميا، ملء القلب والسمع والبصر.
القبائل التي أنكرته وهو حي نسبته إليها وهو ميت، لتكسب شرف التضحية، لكنها لم تكسب
الآلاف مثله، كبار، صغار، نساء، رجال، هجروا أوطانهم الأولى، هل كانت لهم "أوطان" حقاً وقد تسيّدها اللصوص والقتلة وبائعو الضمير؟ أولئك الآلاف تشظت هوياتهم على شواطئ البحار، أو في قوارب مافيات التهريب، عرب أنكرتهم عروبتهم، قال عنهم واحد من بائعي الضمير "إنهم هجروا بلادهم، لأنهم يعانون نقصاً في التربية الوطنية". آخر طالب بإعادتهم، و"الأبواب كلها مفتوحة أمامهم"، يقصد أبواب الموت الزؤام الذي تعدّدت أشكاله وصوره، ولم يكف ثالث عن الصراخ: "وطننا لا يحتاجهم، فليذهبوا"، يقصد وطنه هو الذي يستأثر بهويته، وثروته، وسلطته. كاتب عربي زاد: "أما كان بإمكان والد عيلان أن ينقل أسرته بالطائرة إلى أوروبا، ويجنبنا المشاهد الأيقونية الصادمة؟"
الرؤساء والملوك العرب لم يرفّ لهم جفن، وربما لم يسمعوا بالواقعة، وحده الرئيس التركي، الطيب أردوغان، كتب معزّياً: "ليتكم لم تبحروا، وكنتم ضيوفنا". زعماء وقادة غربيون تعاطفوا مع محنتنا، وفعلوا الكثير من أجلنا، لكننا شتمناهم، لأنهم أوقدوا نيران الحروب في بلداننا، وكانوا السبب في هجرة أبنائنا، وأنكرنا أن حكامنا يتحملون خطايا الحروب سواء بسواء مع أولئك، تعلمنا أن نعلق خطايانا على مشاجب المؤامرات، التي يحوكها خصومنا ضدنا، ونغض الطرف عما فعلناه بأنفسنا.
تحدث آخرون عما أسموها "بشاعة صورة الطفل عيلان"، لأنها تثير الاكتئاب لدى من يشاهدها، ولاموا المصورة التي التقطتها. للأسف، لم يعد البحر ينتج صوراً رومانسية عن لقاء محبين، لأننا لا نستحقها. هذا عصر الوحشية والبشاعة وانعدام الضمائر، والصور التي تعرض أمامنا على الشاشات هي لنا، نحن وحوش العصر، وقد نافسنا وحوش الغاب في خطايانا، ومن منا بلا خطيئة؟ أقل خطايانا أننا صفقنا لطغاتنا عقوداً، ولم نعترف بمآثرهم إلا عندما رمونا في البحر، وعندما لفظتنا البحار على رمال شواطئها، أدركنا أننا مجرد مسامير قديمة، نزعت من مكانها، وبقيت مرمية.
عيلان، والآلاف معه، وربما سيصبحون ملايين، راحوا في "درب الصدّ ما ردّ"، ولم يبق منهم سوى بقايا هويات متشظية، ملقاة على رمال الشواطئ الغريبة.