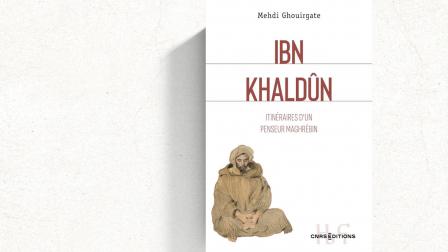لا أذكر المرة الأولى التي شرحوا لي فيها معنى اسمي بالإيطالية، ولم يخطر ببالي أبداً وأنا طفل أنه كان غير مألوف، ومختلفاً عن أسماء رفاقي في الصف. وكنت، على الأقل حتى سن الـ15 أو 16، غير مبال بمفهوم المنشأ. والفضل في هذا يعود لأبَوَيَّ، فعلى الرغم من أنّ أبي سوري مسلم وأمّي إيطالية مسيحية، عاشا اختلافهما في ما يمكن أن أسميه اليوم بالتَوْفيِقِيَّة، أو محاولة الجمع بين المعتقدات المتعارضة في الدين أو في أوجه الحياة الأخرى.
لقد وُلدت في عائلة كانت علامتها الفارقة دائماً التآلف، تآلف حقيقي وعفوي، لم يكن يتخلّله مناقشات حول سبب بعض الطقوس المعينة. فقد رأيت أمّي تُحضّر وجبة الإفطار لأبي في شهر رمضان، وكنّا نتناول الطعام معاً بعد غروب الشمس.
من ناحية أخرى، منذ سنوات ووالدي يواظب على حضور قدّاس عيد الميلاد، ويحتفل بعيد الفصح وكلّ عطلة مسيحية أخرى. ولعلّ الصلة الحميمة والعفوية بينهما هي التي ولّدت في وقت متأخر جداً السؤال: "من أنا ولماذا أملك هذا الاسم؟". بوادر اكتشاف هذه الهوية المعقدة ابتدأت عام 2001، عندما قرّرت الذهاب إلى سورية.
كنت في الثانية عشرة من العمر لمّا واجهت صدمة عالم مختلف، ولغة غير معروفة ومألوفة في نفس الوقت، بقيت هناك لمدة أسبوعين، ثم عدت إلى إيطاليا. لم أكن أدري شيئاً عن ماضي والدي حينذاك، ولم يخبرني أحد بذلك. لم أكن أعرف أنني ولدت في المنفى، منفى والدي، ولم أكن على علم بالتعذيب الذي تعرّض له.
لم أعان، كابن لعربي، من الهجوم على البرجين التوأمين عام 2001، ولكنني عشته، كأيّ يافع، بألم الحضور: تعاطف طبيعي مع الضحايا. في الأيام والأشهر التي تلت الهجوم، لم يطلب منّي البتّة أحد أصدقائي أن أنأى بنفسي وأدين المهاجمين. إن ما ارتكبه الإرهابيون لا يمكن أن يقع على كاهل مجتمع بأكمله من المؤمنين والأفراد ذوي الأصول العربية. بالنسبة لأصدقائي وزملائي في المدرسة، أنا كنت مجرّد شادي، ولم يكن ثمّة مجال ليحمّلوني أفعال المجموعة.
عالم الأطفال مختلف، إنه عالم صادق وأكثر نقاء. ومع ذلك، تأثر الجميع بأحداث أيلول/ سبتمبر 2001، حتى أقراني، لكن العواقب لم تظهر سوى في مرحلة البلوغ. أعتقد أيضاً أنني لم أتعرّض لإساءات عنصرية، ربّما لأن مظهري الخارجي ليس له سمات شرقية بارزة، وربّما مردّ ذلك إلى أن هذه الهوية تأخرت في الظهور. لقد تميّز المسار الذي سلكته تجاه هويتي وجذوري بالبطء، ببطء حثيث.
والهوية الدينية أيضاً، تجلّت في نفسي في وقت متأخر جداً. أنا مدين لجدّتي بالارتباط مع الله، وليس مع الدين المُعْلن. كانت جدّتي من جهة أمي تُدعى فاطمة، وأثّرت بعمق في سنوات حياتي الأولى، في جانبين على وجه الخصوص: التاريخ والعلاقة مع الله. كانت جدّتي مولعة كثيراً بالتاريخ. عندما كنت صغيراً، كانت تروي لي دائماً الحوادث التي مرّت بها خلال الحرب العالمية الثانية. تميّزت طفولتي بحكايات قليلة وغصّت بقصص حقيقية، ما ولّد في نفسي شغفاً لدراسة الماضي ونفوراً عميقاً من الحرب.
قصص جدّتي هذه، وهي في نواحٍ عديدة بعيدة عن النمطية وصارمة في تلقين التربية والانضباط -أدركتُ ذلك بعد سنوات- ساهَمَتْ في تكويني الأخلاقي، لكنّ إيمانها المطلق بالله، وَسَمَ طفولتي ببصمات لا يُمكن أن تُمحى. نحن جميعاً أحرار في أن نؤمن أو لا نؤمن. أسوق هذا الكلام حتى لا يشعر أحد بالإهانة بما سأقوله، والذي أعتبره أساسياً لتفسير النهج الذي أنضجته تجاه الإسلام. خلال كل تلك الفترة التي بقيت فيها مع جدّتي، ترعرعت بصورة ومثال يسوع المسيح. تعلّمت أيضاً الصلاة المسيحية لأنني التحقت بمدارس كاثوليكية.
لقد التقيت بيسوع الرؤوم والداعي للسلام، بفضل جدّتي التي كانت تتحدث عنه مع أحداث الحرب العالمية الثانية. رأفة يسوع التي علّموني إيّاها، ترسّخت في أساريري. بعد سنوات من السفر إلى "الشرق الأوسط" والتعرّف عن قرب على المسيحيين والمسلمين في زمن الحرب، أدركت أن للرحمة حيّزاً في المشرق، ولكنها لا تُمارس، لأننا يجب أن نكون أقوياء، وليس ضعفاء أبداً في مواجهة العنف. إن الرأفة نادرة في الحرب، ليس في الشرق الأوسط فحسب.
اللغة العربية هي المعيار الذي يقيس المسافة إلى نفسي. لقد نشأت وأنا محاط بمكتبة باللغة العربية وأخرى باللغة الإيطالية. لسنوات نظرت بلا اكتراث وبلا مبالاة إلى المجلدات العربية. ولكنني أدركت، عندما ذهبت إلى سورية، رغم أنني لم أتحدث العربية أبداً، أن تلك اللغة كانت تحوم في رأسي وتسكن في داخلي.
ورغم أن والدي لم يؤكّد ذلك قط، كنت أظنّ دائماً أنه لم يعلّمني لغته لحمايتي. لكن حمايتي مِمَّنْ؟ في عام 2009، عندما اكتشفت نفيه والتعذيب الذي تعرّض له، حتى وإن لم يكن مع التفاصيل التي أعرفها الآن فقط، فقد أعدت ربط ذلك الافتقار اللغوي إلى الخوف الذي الذي أنضجه كأب، حيث أنه لو كنت قد تحدّثت بلغة المكان الذي هرب منه، لطالبت بالعدالة، وربّما مارست السياسة في سورية.
بهذه الدراية، ربطت هذه اللغة، منذ بداية الأزمة السورية، بالشروط التي كنت أعيشها: فكلّ كلمة تعلّمتها باللغة العربية، كانت تحمل، بالنسبة لي، معنى الانتقام من الحرمان الذي ينطوي عليه المنفى. لكن ما هو المنفى؟ وماذا يعني بالنسبة لي؟ وصلت إلى جواب هذين السؤالين تدريجياً. بادئ ذي بدء، المنفى هو نتيجة فرص مسلوبة. في المرة الأولى التي ذهبت فيها إلى سورية، عندما طرقت باب جدّتي، لم تفتح لأنها لم تكن تعرفني. وكان تدخّل ابن عمي هو الذي طمأنها وجعلها تثق بي وتسمح لي بالدخول.
ثم كانت هناك مسألة التفاعل مع أفراد الأسرة. كنت أكثر ارتباطاً بجاري في إيطاليا من أعمامي. لا يمكن خلق المشاعر من العدم. لا أستطيع أن أحبّ شخصاً، حتى لو كان قريباً، إذا كان حتى يوم أمس غير معروف لي. واللغة ضرورية لمعرفة بعضنا البعض.
إن ترديد كلمة "أنا أحبّك" باللغة الإنكليزية، بدلاً من لغتك الأم، ليس له نفس الوطأة، ولا يسمح لنا بتقدير الفروق الدقيقة. ومع أنني موجود في سورية، كنت أعيش في منفى من المشاعر التي لم تنته بعد، رغم أنني أتحدث اللغة العربية اليوم وأتواصل أكثر مع أقربائي الذين لجأوا إلى الخارج.
في الآونة الأخيرة فقط بدأت أتحدّث عن المنفى مع أفراد عائلتي. لقد لاحظت دائماً أنهم يميلون إلى المواربة، حتى أنهم لم يخبروني عمّا كان يفكّر جدي، الذي وافته المنية قبل الأوان، بخصوص منفى ابنه. من ناحيتي، لم أتطرّق لمدة طويلة إلى ما كان يمثله المنفى لي، ولم يواجهني به أحد.
عندما انتقلت إلى بيروت عام 2015 للعمل، بدأت أنا وابن عمي عمر نتحدث عن المنفى. كان ذلك في شهر آذار/ مارس 2015، كنا في المنزل الذي استأجره عمر وشقيقه "إ" على الحدود مع سورية، لاستضافة أمه، زوجته وأولاد "إ". عندما لاحظ عمر أنني أنظر طوال الوقت من النافذة، بهوس تقريباً، سألني: "ما الذي تنظر إليه؟". "إلى القرية"، أجبته بدهشة، فقد ظننت أنه يتخيّل ذلك. كانت تلكلخ، مسقط رأس أبي وجميع أقربائي، على بعد خمسة كيلومترات من تلك النافذة. ابتسم بحزن، وقال: "انس كما فعلت أنا، فنحن الآن في المنفى".
* مقطع من كتاب شادي حمادي "النفي من سورية. صراع ضد اللامبالاة"، منشورات "أَدْ" في تورينو.
** ترجمة عن الإيطالية: يوسف وقاص