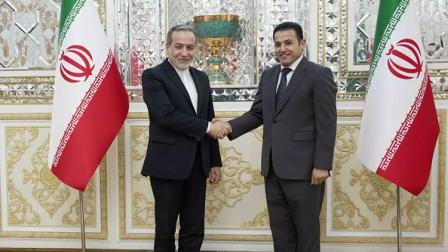بعد خمس سنوات من قيادته الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، والذي نفذ في 3 يوليو/تموز 2013 "على ظهر" تظاهرات 30 يونيو/حزيران من ذلك العام، يبدو الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وقد أمسك بمفاصل مراكز صنع القرار على مختلف المستويات، التنفيذية والعسكرية والأمنية والإدارية، بعدما أطاح بجميع من شاركوه صنع لحظة الثالث من يوليو 2013، خصوصاً من كانوا يتولون مناصب رسمية آنذاك، وكذلك من برزوا في تلك المناصب خلال الشهور الثمانية التالية لذلك الحدث، وهي الفترة الفاصلة بين الانقلاب وإعلان السيسي ترشحه رسمياً لرئاسة الجمهورية، وهي الفترة التي كانت الأوساط السياسية والإعلامية تعتقد وتروج فيها لصورة مختلفة للدولة المصرية بعد الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي. لكن هذه الصورة لم تتحقق أبداً، واتخذت الأحداث فيما بعد منحى وحيداً، هو التحول لنظام عسكري صريح لا مكان فيه للسياسة، يعتمد في تسيير أموره بالأساس على الاستخبارات والرقابة الإدارية والأمن الوطني، ويتسع بالكاد لمجموعة من التكنوقراط دون تخويلهم أي صلاحيات.
مهد السيسي السبب على مدار فترته الرئاسية الأولى (2014 - 2018) لاصطناع طبقة حاكمة جديدة، بهدف واحد هو توطيد دعائم حكمه، فأبعد جميع من كانوا في دائرة الضوء لحساب مجموعة جديدة من الموثوقين الذين يدينون له وحده بالولاء، ليس فقط لأن بعض من تخلص منهم، بصور شتى، كانوا يشكلون خطراً عليه، بل أيضاً ليكرس واقعاً جديداً مفاده أنه "لن يبقى أحد في مكان، ولن يصل أحد لمنصب، إلا برضا السيسي"، وهي معادلة، على بساطتها واعتيادها في الأنظمة الدكتاتورية، لم تكن سائدة في مصر، حتى في أشد العهود السابقة، شمولية وأوتوقراطية.
فدائماً ما كان رؤساء مصر السابقون يتركون هامشاً لاختيارات لا تحكمها قيود صارمة أو تفضيلات شخصية رئاسية، بل إن بعضهم كان يعمد لأن يخلي ما بينه وبين سلطات بعينها، كالقضاء، أو أجهزة بعينها، كالاستخبارات العامة. إلا أن السيسي استخدم كل الوسائل الممكنة، من التدخلات التشريعية والتهديدات الأمنية، لينصب شباكه حول جميع المواقع القيادية بالدولة من دون استثناء، مقابل استسلام تام من الجميع، حتى من رفاق عمره وشركاء لحظة وصوله للسلطة. واللحظة المفصلية التي أوضحت للمصريين جميعاً أن السيسي لن يسدد فواتير أبدية لأحد، وما من شيء أسهل عنده من الإطاحة بالأشخاص، كانت بالتأكيد عزله لصهره، والد زوجة ابنه، ورفيق مشواره العسكري، والأعلى منه رتبة والأكبر منه دوراً خلال عملهما بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في العام 2011، رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق محمود حجازي، الذي كان معروفاً أنه الرجل الأقوى في الجيش منذ استعاده السيسي للخدمة تزامناً مع ترشحه للرئاسة، ليؤمّن الجيش من خلفه، ولا يترك القيادة منفردة لوزير الدفاع، صدقي صبحي، الذي لم يكن السيسي هو من اختاره للصعود، بل كان اختياره وزيراً ضرورة حتمية في تلك الفترة، بعدما وصل لرئاسة الأركان بقرار من مرسي.
ولعب حجازي دوراً كبيراً في تأمين الجيش من الداخل وتطهيره من المشتبه بعدم ولائهم والتصدي لجميع التحركات المناوئة للسيسي، كما كان عوناً للسيسي في الإجراءات غير المسبوقة من إحالة عشرات الضباط في أسلحة مختلفة، على رأسها الدفاع الجوي، للتقاعد، بسبب اتصالات مع خصمهما رئيس الأركان الأسبق، سامي عنان، فضلاً عن أدائه دوراً تقليدياً في تحجيم قرارات صدقي صبحي نفسه. حتى أن جميع قيادات الجيش كانت تعرف أن صبحي ليس له كلمة مسموعة خارج ديوان الوزارة. عملية الإطاحة بحجازي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإن لبست ثوب العقاب الوظيفي، ارتباطاً بتورط حجازي في قرارات سلبية ساهمت في مذبحة "الواحات" لضباط الأمن الوطني والمباحث على يد خلية قاعدية التوجه، إلا أن أسبابها كانت أعمق بكثير. فبحسب مصادر متعددة، كان السيسي غاضباً من زيادة شعبية حجازي في الجيش، ومن تمتعه بمساحة حركة، مدعوماً بصلته الأسرية بالسيسي، فضلاً عن إقامته علاقات صداقة بالدوائر العسكرية في دول عدة، على رأسها الولايات المتحدة. كما كان السيسي مستفزاً من تعامل الإعلام بطريقة خاصة مع حجازي، وقدرة الأخير على تسويق نفسه والمناسبات التي يحضرها والفعاليات التي يتولاها، سواء العسكرية كالتدريبات المشتركة ومفاوضات التسليح، أو السياسية كإدارة الملف الليبي. وهذا لم يكن في الحقيقة منفصلاً عن التاريخ السابق لحجازي، فالرجل كان معروفاً في الأوساط الإعلامية وقريباً من دوائر سياسية عديدة منذ 2011، وبالتالي فقد كان له رصيد يسمح له برسم صورة لنفسه، مستقلة عن السيسي، ولو بقي معروفاً أنه يسبح في فلكه.
واعتبر السيسي، وهو على أعتاب نهاية فترته الأولى، أن صورة حجازي المستقلة ربما تشكل خطراً عليه، إذ بدأت تتردد همسات في الأروقة الحكومية عن دور أكبر ينتظره. وكانت الهمسات مبنية على محض أوهام، لكنها كانت كفيلة بإغضاب السيسي، فاتخذ قرار عزل حجازي، مستغلاً حادثاً إرهابياً، بالفعل كان الأكبر من نوعه، وبالفعل كان حجازي مقصراً فيه، لكنه في الواقع لم يكن منفصلاً عن سياق عجز الدولة المستمر عن محاصرة الإرهاب، بما لا يُتصور معه أن عزل حجازي هو الخيار الأنسب، أو على الأقل الخيار الوحيد! وأدى عزل حجازي إلى إيصال رسالة فورية لجميع المسؤولين والمراقبين، تفيد بألا حصانة لأحد، فارتفع سقف التوقعات بإطاحة من تبقوا من قادة الصف الأول، وعلى رأسهم صدقي صبحي، الذي خرج في التعديل الوزاري الأخير بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قرار عزله، حيث جنى السيسي ثمار تحركاته، التي شاركه فيها صهره محمود حجازي، ورئيس الأركان الحالي والأمين العام السابق لوزارة الدفاع، اللواء محمد فريد حجازي، في تغيير جلد المجلس الأعلى تماماً، وإبعاد جميع القادة الذين كانوا معاصرين لانقلاب السيسي وترشحه للرئاسة، وعلى رأسهم قائد قوات الدفاع الجوي، الفريق عبد المنعم ألتراس، وقائد الجيش الثاني الميداني، اللواء أحمد وصفي. وصفي كان من أوائل الأشخاص الذين دفعوا ثمن الوقوف خلف السيسي في انقلابه على الشرعية الدستورية. فبعدما كان يوصف إعلامياً خلال الفترة الانتقالية بعد الانقلاب بـ"أسد سيناء" تم نقله من قيادة الجيش الثاني (ثاني أهم منصب قيادي في الجيش ميدانياً) إلى وظيفة من الدرجة الثانية، هي "رئاسة هيئة التدريب" في مارس/آذار 2014، وذلك بعد إدلائه بتصريحات تلفزيونية تستبعد تولي السيسي رئاسة الجمهورية، وتصف هذه الخطوة، إذا حدثت، بـ"انقلاب عسكري". وبعد تجميده في هيئة التدريب، عزل منها في مايو/أيار 2017 ليصبح واحداً من عشرات الضباط المتقاعدين تحت الاستدعاء بصفة "مساعد وزير الدفاع"، وهي صفة شرفية بلا أي صلاحيات.
وعلى مستوى الأجهزة الأمنية، كان السيسي سباقاً في التخلص من وزير الداخلية، محمد إبراهيم مصطفى، في مارس/آذار 2015، بعدما كان زميلاً للسيسي في مجلس الوزراء في عهد مرسي، وأدى دوره على أكمل وجه في خداع جماعة الإخوان المسلمين ورئيس الجمهورية بالتظاهر بالعمل لمصلحة الدولة، ثم سماحه بخروج تظاهرات أمنية ضد مرسي ثم تأمينه التظاهرات المعارضة ثم إطلاق النار على تظاهرات الإخوان، وصولا لتنفيذه مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة. وكان البعض يعتقد أن إبراهيم سيبقى في منصبه للأبد بسبب العلاقة الخاصة التي كانت تجمعه بالسيسي، بينما كان يشيع في تلك الفترة أيضاً توهم بأن السيسي لا يرغب في التداخل مع الشرطة تحسباً لغضبها، لكن الحقيقة أنه كان يدرك أنه لم يعد مناسباً للمرحلة، وأن مقاليد الوزارة لا بد أن تكون بحوزة شخصية قوية تنتمي لجهاز الأمن الوطني وليس لوزير عمل فقط بالأمن العام ومصلحة السجون، مدعوماً برأي مستشاره الأمني، أحمد جمال الدين، الذي كان تولى حقيبة الداخلية قبل إبراهيم مباشرة وغادر منصبه بعد خلاف كبير مع مرسي. والأمر بشكل آخر تكرر مع اللواء خالد فوزي، الذي اختاره السيسي في ديسمبر/كانون الأول 2014، قائماً بأعمال مدير الاستخبارات العامة، خلفاً للواء محمد فريد التهامي بعد مرضه. ولم تشفع لفوزي علاقة الزمالة التي جمعته بالسيسي ومدير مكتبه عباس كامل منذ سنواتهم الأولى في الجيش، فأطاح به في يناير/كانون الثاني الماضي، عقاباً له على فشله في وقف الاتصالات بين ضباط الجهاز وخصمي السيسي، سامي عنان وأحمد شفيق. وما زال صاحب الواحد والستين عاماً قيد الإقامة الجبرية.
أما في الأجهزة الرقابية، فدفع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، ثمناً غالياً لمحاولته مهادنة السيسي بغية الاستمرار في منصبه بعيد الانقلاب. فبعد نحو 3 سنوات من إطلاق تصريحات تشيد بالسيسي وجهوده لمكافحة الفساد، رغم عدم تفعيل دور الجهاز ومنع جنينة من ممارسة اختصاصاته، كانت نهاية 2016 إيذاناً بنهاية جنينة، إذ تم الزج به في قضية إطلاق تصريحات كاذبة عوقب فيها بالحبس مع وقف التنفيذ. وبعد انخراطه في حملة عنان كان الانتقام الأكبر بإحالته للقضاء العسكري ومعاقبته بالحبس 5 سنوات. أما هيئة الرقابة الإدارية، فتدخل السيسي فيها مبكراً، وتحديداً في إبريل/نيسان 2015، بعزل رئيسها محمد عمر هيبة بسبب عدم موثوقيته (ينتمي للاستخبارات العامة وتم تعيينه في عهد مرسي)، وتم الدفع باللواء محمد عرفان الذي عمل تحت إمرة السيسي لسنوات في الاستخبارات الحربية، إيذانا بتحويل الرقابة الإدارية للهيئة الأهم على المستوى الرقابي والتنفيذي حالياً، ومنحها صلاحيات غير مسبوقة في مراقبة الوزراء والقيادات الإدارية العليا، بل والمشاركة في اتخاذ القرارات الإدارية.
وليس خافياً أن علاقة السيسي بالمؤسسات الرسمية، التي شاركت في بيان عزل مرسي في 3 يوليو/تموز، لم تبق على حالها من التنسيق، إلاّ مع جهة واحدة فقط، هي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي حسم رأسها البابا تواضروس الثاني جميع مواقفه لصالح التبعية المطلقة للنظام، رغم ما تكبده الأقباط المصريون من نزيف دماء متواصل، تارة بسبب فشل النظام في المواجهة السياسية والأمنية للإرهاب، ما تسبب في اتساع رقعة عملياته التخريبية، وتارة أخرى بسبب ضعف خطط الحماية الأمنية. أما باقي المؤسسات، فإما دخل السيسي معها في صدام لتقليم أظافرها والعبث بقواعدها، وإما حاول محاصرتها حتى لا تتمكن من القيام بدورها المرسوم لها، دستورياً وقانونياً أو المتوارث تاريخياً، ليحتكر هو ودائرته، التي شكلها من جهازي الاستخبارات العامة والرقابة الإدارية، رسم قواعد النظام العام دون مشاركة مؤسسية أو ديمقراطية.
ولم يشفع للقضاة انتماء عدد من أفراد أسرة السيسي لمرفق العدالة، على رأسهم شقيقه أحمد، القاضي بمحكمة النقض، إذ عانوا مالياً، للمرة الأولى، بضمهم إلى الفئات الخاضعة لقانون الحد الأقصى للأجور الذي سارع السيسي لإصداره بعد توليه رئاسة الجمهورية منتصف 2014. ولما حاول القضاة التملص منه، عبر إصدارهم أحكاماً قضائية وفتاوى بذلك، عاجلهم السيسي بقرارات حكومية لخفض نسب الاستعانة بهم كمستشارين للوزارات المختلفة. ولم يشفع للقضاء المصري، في مواجهته مع السيسي، مشاركته الكبيرة في تحجيم التيارات الإسلامية، عبر قرارات النيابة العامة وأحكام الإدانة المغلظة في قضايا التظاهر والتجمهر، وإضفاء وصف الإرهاب على مجموعة ضخمة من المعارضين من مختلف التيارات، بل كانت النتيجة أن تدخل السيسي في ربيع العام الماضي ليعصف بقاعدة الأقدمية الراسخة في القضاء المصري منذ نشأته، ويبسط سلطته المطلقة في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بعدما كانت تتمتع بالاستقلالية منذ أربعينيات القرن الماضي.
أما الإعلام، الذي استعان به السيسي بنجاح في تسويق عزل مرسي منذ النصف الأول من 2013، ثم في حشد المواطنين لتفويضه في 26 يوليو/تموز 2013 وفي دفعه مرشحاً للرئاسة في 2014، فقد عانى من حصار السيسي وأجهزته بشكل تدريجي، بدأ بالتدخل الرقابي والموضوعي وانتهى الحال به مداراً مباشرة بواسطة ثلاثة أجهزة، الاستخبارات العامة والاستخبارات الحربية والأمن الوطني، إذ تم إنشاء صناديق استثمارية وشركات مساهمة صورية اشترت بعض وسائل الإعلام بالكامل، كقنوات "أون" و"سي بي سي" و"الحياة" و"العاصمة" وصحف "الوطن" و"اليوم السابع" و"دوت مصر"، فضلاً عن شراء أكثرية الأسهم في مؤسسات أخرى، مثل "المصري اليوم" و"النهار" وتسعى للمزيد.
وعلى الصعيد السياسي، فقد استعان السيسي، في أول أشهر توليه السلطة الفعلية، بعدد من الشخصيات المعروفة بمعارضتها لكل من حسني مبارك و"الإخوان" وأسند لها مواقع قيادية كرئيس الوزراء الأسبق، حازم الببلاوي، ونائبيه حسام عيسى وزياد بهاء الدين، ووزير الخارجية نبيل فهمي، ووزير العمل أحمد البرعي، وهم من شكلوا ما عرف بـ"الجناح الديمقراطي بالحكومة"، إذ تخلص السيسي منهم واحداً بعد الآخر، بعدما شهدت فترة مشاركتهم في الحكم أحداثاً دامية صعبت عودتهم فيما بعد للمشهد السياسي، كفض اعتصامي رابعة والنهضة وأحداث الحرس الجمهوري واتخاذ قرار اعتبار "الإخوان" جماعة إرهابية، انتهاءً بإصدار قانون التظاهر المكبل للحريات العامة. وحالياً لم يعد لأي منهم دور واضح في معسكر المعارضة، بعدما تم "حرقهم" بلغة السياسة.
وفي مرحلة إعداد الدستور أعطى السيسي الضوء الأخضر للاستعانة بشخصيات عرفت بمعارضتها لمبارك و"الإخوان" وكذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أبرزهم عبد الجليل مصطفى وعمرو الشوبكي ومحمد أبو الغار وهدى الصدة. لكن السيسي اصطدم بهم بشكل مباشر، عندما شعر برغبتهم في إعاقة بعض أفكاره في الدستور، خصوصاً المتعلقة بسلطات القضاء العسكري وإمكانية محاكمة المدنيين أمامه. وبعد وضع الدستور، الذي وصفه السيسي فيما بعد بدستور النوايا الحسنة، تم التضييق على جميع الأحزاب والمجموعات السياسية، بمنا في ذلك التي شارك ممثلوها في لجنة الخمسين، إلى حد الإصرار على عدم تنفيذ حكم قضائي بإلحاق الشوبكي بمجلس النواب. وحتى رئيس اللجنة، عمرو موسى، الذي كان يظهر في الأشهر الأولى بعد الانقلاب كمستشار للسيسي للشؤون الخارجية، أصبح منكفئاً على نفسه، بعدما تلقى تحذيرات وتهديدات من الاستمرار في لعب دور المعارض المتحفظ، بعد تشكيله مجموعة تهدف لتفعيل الدستور وعدم تعديله.