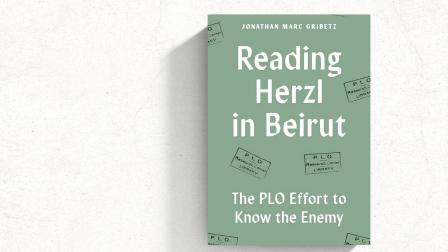عمل للفنان عاصم الباشا (بإذن من الفنان)
-1-
أكان عدد النجوم قليلاً، أم أن وقتهم كان طويلاً؟ ليصعدوا في غفلة عن أهلهم، إلى أعالي العمارة، ويحصوا عددها بإشارة من أصابعهم، ويبددوا ما تبقى من الوقت، بمسامرات عن ارتفاع السماء، وتدّرج طبقاتها، قبلما يهرعوا إلى تبادل الاستفسارات عن الزمن الآتي، باستقصاء مضطرب لمسارات النجوم وهندسة الفلك.
بداية دفعتهم لتفسير وقائع الأرض وأهلها بالاستعانة بالنجوم ومساراتها، التي باتت تنتمي لجدب في تصنيف العلوم، إلى ما أطلق عليه:علم الأبراج.
تأخر الفتية، في تبين أنه لا طالع يرتجى، من نجوم يتعقبونها، لا تلبث أن تغيب في سماء بعيدة ومعتمة، كما تأخروا في فهم قواعد التبادل السكاني بين الأرض والسماء، بصعود الموتى إليها مزودين بسجلات حسناتهم وسيئاتهم، ووصول الأطفال المولدين حديثاً منها.
لكن هذه السيارات المضيئة الهادرة، ليست نجوماً، إذ، لا تصدر النجوم أصواتاً في حركتها، ولا تسمع أصوات انفجاراتها النيزكية، وارتطام حطام أجرامها.
فكروا قبل الأوان، بهجرة هذه الأرض، بصعود إلى الأعالي محملين بالآمال، حيث لا ينتظرهم أحد، في حين تكون قلوب أهلهم قد احترقت بانتظارهم.
- ماذا سنفعل في السماء السابعة؟
- لا شيء، نزورها ثم ننزل بعد ذلك إلى السماء الأولى، الأقرب إلى الأرض، أرضنا.
ما لم يخطر في بالهم وفي مخيلاتهم، في هذه الحوارات السماوية، ولم تشر إليه الكتب التي تداولوها، إلى احتمال أن تتهاوى السماء في يوم ما فوق رؤوسهم.
لم تكن قد درجت عادة محادثة الناس لأنفسهم، وهم يسيرون في الشوارع، ويعبرونها من رصيف إلى آخر، كما يحصل في هذه السنوات، حيث اقتضت الضرورة إملاء الصمت المريب بكلام أقل ريبة، كأن يقول الأب لابنه، وهما يسيران على الرصيف: اتبعني! في الوقت الذي لا يملك الطفل، في هذا العالم الغريب، سوى متابعة والده ...أو يقول رجل آخر لابنه وهما يجتازان الشارع: إياك ان تفلت يدي! في حين أن الأب هو من يشد على يد ابنه خوفاً من افتقاده في هذا الزحام وفوضى حركة العربات. يجب الاحتيال على هذا الصمت المروع، بحفنة كلمات تخرج مترنحة كسكير من بوابة حانة.
يجب تذكر المصائر التي تتربص بالأولاد، في الامتحانات اليومية القاسية، في المطاردات المجنونة، في التعقب الهذياني لأجهزة المخابرات....الحمولة ثقيلة عليهم....كما على أهلهم.
حرص يوسف العظمة على وداع ابنته "ليلى"، وأوصى بها قبل ذهابه إلى مقتله في معركة ميسلون، وواظب إبراهيم هنانو في لجة المواجهة مع جيش الاحتلال الفرنسي، على إرداف ابنته "نباهة" خلفه على حصانه، ليمضيا من بلدة إلى أخرى، ويختفيا أوائل الليل في جوف المغائر.
-3-
لا بأس من الإشادة بارتفاع منسوب الوعي عند الناس، بأثر من التعلم والقراءة والمقارنة بين أحوالهم وأحوال الأمم التي تشاركهم شواطئ هذا البحر المهيب، وقد أضحوا بحزمة تلك المؤثرات، والتعظيم الذي يحملونه للعقلانية، ينحازون نحو الأفعال الواقعية، التي تقيد غلاة الخياليين والميتافيزيقيين. مما دفعهم مع مرور الوقت، لتجاوز المهمة التي أرهقت الأجيال التي سبقتهم، وعجزوا عن الوصول إلى خواتمها الضرورية، بعدما ساروا على غير هدى لإنجاز مقدماتها: إصعاد الحمار إلى أعالي المئذنة، إلى مهمة رأوها واقعية وأكثر جدوى، لكنها ظهرت أشد صعوبة: العمل على إنزاله، بأقل الأضرار التي سيسببها حرونه، الناتج عن اعتياده العيش في المكان العالي.
لكم تساءلوا، وهم يزفرون تعبهم: ترى من وضع كل هذه المهام الشاقة في طريقنا، أم أنه الاستعمار ذاته، الذي أمسى كما البرد سبب لكل علة؟
بالصابون كانوا يفركون رؤوسهم لإزالة أملاح التعب وزيوته، وبالنقد والنقد الذاتي يصوبوا مسارها. ما من طريق واضح، يمكنهم السير عليه، كما هي طرقات سائقي العربات والحافلات...لا بد من تحديد المسار والتهيؤ لشق الطريق وتعبيده.
يحتاج المرء أحياناً، لضروب من التسلية، كتبديد لوقت مبدد، في صالة انتظار الطبيب أو قدوم القطار، بحل الكلمات المتقاطعة، كما بفصل الزؤان عن حبيبات البرغل، والشعب عن الناطقين باسمه.. قبل الاستيطان في عهود اليأس الذي دفعهم، لتبديد الوقت في متابعة المباريات الرياضية والمراهنة على نتائجها.
-4-
تتغير الأمور بأسرع مما هو متوقع، استبدل الناس في حواراتهم، الكلمة الحسنة أو حتى الشتيمة المقذعة، بالسكاكين والهراوات، وانتظم المسار اللغوي كتعبير عن التوتر الاجتماعي، وفق صيغة "يا قاتل يا مقتول"، وكأنه تشييع للكلام والحوار إلى مقبرته، بافتراض أن المونولوجات الليلية الطويلة، التي يجترحها المعذبون مع أنفسهم في حين، والمصطفى من أصدقائهم في حين آخر، هي حوارات، وكأننا نتناسى أجيالاً كاملة ماتت مخنوقة بكلمات عجزت عن البوح بها.
وإن كان المرء ينحدر من أقلية، التي باتت تعبيراً مجازياً، بعدما حوّل الاستبداد المزمن، المجتمع برمته إلى كسور لا تنتهي من زجاج أقليات لا تلتحم، يتوجب عليه الالتزام بها، لا التحرر منها ومن أمراضها، حاله حال علاجات مشاكل الأحذية..."المنكمة" أي القالب الحديدي القابل للتمدد، لتوسيع قياسها، و"الضبان" الجلدي لتضييقها.....ليكمل أتباعها حياتهم في زيارات متواصلة للإسكافيين، أو من يقوم مقامهم، وهم يتأبطون أحذيتهم، ليؤكدوا طلبهم الموزّع بين خيارين أمسيا أزليين، إما التضييق أو التوسيع، مع إصرارهم الحاسم على الإسكافي في البدء والختام، بوجوب الحفاظ على سلامة الحذاء وتمتين أماكن ضعفه، وتلميعه بأصبغة راسخة، تعيد شيخوخته إلى فتوتها.
لم يضطروا للإصغاء لحلف اليمين، حينما يسألون البائع عن سعر كيلو بندورة وباقة بقدونس. ولا للاستماع للمطولات التي يقتبسها الباعة برهافة من أجهزة الإعلام، ويحسبونها شامخة في علياء الجدية، ويضمها الزبائن إلى جديد الهزل، حين ينبري الباعة للحديث عن الاقتصاد وارتفاع سعر صرف "الدورار"، ناظرين بعين نحو السماء بوصفها المكان المناسب لتعقد المشكلة، بعدما أدرجوا الاقتصاد في ثبت القضايا الربانية، وبالعين الأخرى على الزبون، لتحري نتائج هذه البلاغة الاقتصادية المدججة بهراوات الحكمة.
- أسيرتفع سعر البرميل كذلك؟
- أي برميل منهما؟
عزيز تبسي نيسان 2016