قبل سنوات قليلة، ظهر مصطلح جديد في أميركا يصف واقعاً إثنياً يزداد وضوحاً كلّ يوم، ويتعلّق بالأشخاص من ذوي الأصول العرقية المختلطة، والذين لا تشير ملامحهم إلى عرق محدّد، نجدهم في مجالات السينما والإعلام والسياسة والرياضة، على غرار ميغان ميركيل، وفين ديزل، وليزا بوني، وجيسيكا ألبا. وهؤلاء تعود شعبيتهم، في جزء كبير منها، إلى عدم القدرة على تحديد خلفيتهم العرقية وإن كانوا من السود أو البيض أو العرق الهسباني أو السكّان الأصليين "الهنود الحمر"، أو أنهم نتاج خلطة إثنية أخرى. هكذا ظهر مصطلح "الغامض إثنياً" أو "المبهَم عرقياً" في الأوساط الإعلامية الأميركية.
أقلية جديدة
الحقيقة أن هذه الظاهرة تُعدّ، بالدرجة الأولى، ثمرة سنوات الثمانينات والتسعينات، حين طغت ظاهرة التزاوج بين الأعراق، خصوصاً في المدن الأميركية الكبرى متعدّدة الثقافات، على غرار سان فرانسيسكو ونيويورك ولوس أنجليس، ليولد أبناء من العرق المختلط الذين بدأوا بتشكيل "أقلية" لا تختلف عن بقية الأقليات العرقية التي كان من شأنها مواجهة تحدّيات كبرى في مجالات العمل القائم على الصورة الثقافية، مثل السينما والموضة، كونهما مجالين طالما اعتمدا على ملامح "نقية" تتّكئ على الأشكال النمطية المعروفة لجماعات بعينها.
لكن، مع التزايد الكبير لهذه الفئة وطغيانها على المشهد الأميركي (في إحصاء سكّاني عام 2010، وصف تسعة ملايين أميركي أنفسهم بأنهم أبناء أعراق أو ثقافات مختلفة)، أصبحت وسائل الإعلام الأميركية تميل يوماً بعد يوم إلى تبنّي هذه الظاهرة الديمغرافية الجديدة، خصوصاً بعد أن ذهبت "ناشونال جيوغرافيك" للتأكيد على أنه، وفي غضون الأربعين سنة القادمة، سيُصبح جميع الأميركيّين "مبهمين عرقياً".
وهنا، تذكر ليندا ويلز، رئيسة تحرير مجلة "ألير"، أنه "قبل حوالي عشر سنوات، كانت قرابة ثمانين في المائة من أغلفة المجلّات تُخصّص لعارضات أزياء من عرق واحد، بينما نميل اليوم إلى إبراز الوجوه ذات الأعراق المختلطة. ذلك أن الملامح المتجانسة لم تعد مطلوبة".
هكذا بدأ تصوير التنوُّع الثقافي في مجال الموضة ينتقل من إبراز الاختلاف العرقي على شكل فسيفساء تُظهر أجناساً متباينة إلى تبنّي الشكل الذي تنصهر فيه مختلف الأعراق، وهو التوجُّه الذي يتوافق مع الفكرة القائلة بأن مفهوم "العرق" نفسه ليس سوى وهم. وهي نظرية دفع بها باحثون بارزون على غرار ك. أنثوني أبايا، أستاذ الفلسفة في جامعة برينستون، وإيفلين هاموند، أستاذة تاريخ العلوم والدراسات الأفروأميركية في جامعة هارفرد. ويذهب هاموند إلى القول إن "العرق حالة مصطنعة، وليس إلا مصطلحاً جرى اختراعه من أجل تصنيف الاختلافات البيولوجية والاجتماعية والثقافية في الجماعات البشرية".
جرى تلقُّف هذه النظرية في مجال التسويق، فأكّد جون بارتيلا، خبير الصورة في "وكالة براند باز" الإعلانية الكبرى، أن "هناك من بدأ لتوّه بالاعتراف بأن الكثير من الثقافات والأعراق آخذة في الانصهار بين بعضها البعض"، وأن "ما نقوم به حالياً ليس إلّا محاولة لإبراز هذا التمازج الحاصل بين الأفراد، والذي يعكس توجُّهاً اجتماعياً، لا توجُّهاً في سياسات التسويق"، مضيفاً أنَّ "الأمر يتعلّق لأوّل مرّة بحالة يتماهى فيها الفن مع الحياة".
هذا التوجُّه الفكري والثقافي القائم، بالأساس، على تحوُّلات ديمغرافية أفرزتها، بالدرجة الأولى، موجات الهجرات في العالم وما تبعه من تمازج عرقي، ناجم عن الزواج المختلط والذي استغلّه خبراء التسويق في العالم، وقد انعكس هو الآخر بصورة واضحة على الأدب الأميركي الذي أخذ يُظهر انفتاحه على سرديات محلية تستقي من ثقافات وعرقيات مختلفة خيوط سردياتها، وهو التيار الذي بدأت ملامحه بالظهور في العقدين الأخيرين من الألفية الثانية، وقد أشار إليه غريغوري س. جاي، أستاذ الأدب الأميركي في جامعة ويسكنسون، في مقال له بعنوان "نهاية الأدب "الأميركي": نحو ممارسة متعدّدة الثقافات".
النمطية وأضدادها
ماذا عن إيطاليا؟ كيف برزت ملامح السرد المتعدّد ثقافياً لدى الكتّاب الإيطاليّين المعاصرين؟ وهل ظهرت معه أيّ معالم لسرديات غير محدّدة إثنياً في مجتمع لطالما كان مسرحاً لهجرات متباينة، بداية من السبعينات إلى يومنا هذا؟
 روزيتا فيراتو صحافية إيطالية لها مؤلّفات في أدب الرحلة وريبورتاجات تناولت المنطقة العربية على غرار تونس والمغرب، صدرت لها هذا العام روايةٌ عن "منشورات نيوس" بعنوان "العشيق السوري"، تتناول قصّة عاطفية بين "مثقّف" سوري مقيم منذ أكثر من عشرين سنة في باريس، وصحافية فرنسية من عائلة أرستقراطية.
روزيتا فيراتو صحافية إيطالية لها مؤلّفات في أدب الرحلة وريبورتاجات تناولت المنطقة العربية على غرار تونس والمغرب، صدرت لها هذا العام روايةٌ عن "منشورات نيوس" بعنوان "العشيق السوري"، تتناول قصّة عاطفية بين "مثقّف" سوري مقيم منذ أكثر من عشرين سنة في باريس، وصحافية فرنسية من عائلة أرستقراطية.
تقع "لي" في غرام "أمير" في عزّ تأزُّم وضعه المادي، لتأتي وتنقذ محلّه الذي لطالما شكّل مركز إشعاع ثقافي عربي في باريس من الإغلاق. غير أنَّ البطل السوري يتنكّر للآنسة النبيلة في النهاية، ويدير ظهره لها بمجرّد حصوله على مبتغاه، مبرزاً بذلك معدنه الحقيقي، كما صوّرته الرواية من خلال رمزية خاتمٍ قدّمه متشرّد للبطلة على ضفاف نهر السين اعتقدَت في بداية أنه خاتم من الذهب، لتكتشف في النهاية أنه من النحاس.
وبغضّ النظر عن السطحية التي عالجت بها الصحافية الإيطالية علاقة الشرق والغرب من خلال قصة حب فاشلة شحذت لها كلّ ما أمكن من صور نمطية عن الرجل العربي الذي يسكن في رأسه دكتاتور صغير، والذي يتحوّل في أوروبا إلى مهاجر استغلالي، والمرأة العربية البدينة التي لا صوت لها (تمكّنت البطلة الفرنسية من إثارة اهتمام أمير لأنه غير معتاد على النساء القويات في بلده الأصلي)، فقد أخفقت فيراتو على الصعيد الأدبي في الإمساك بتفاصيل شخصيتها المحورية، مرتكبةً أخطاء ثقافية فادحة في وصف الشخصية السورية من خلال اللهجة وطريقة الأكل والذوق في اختيار اللباس والاحتفال بالأعياد.
كلّ ذلك يجعلنا نتساءل عن جدوى اختيار هذه الجنسية لبطل الرواية إن لم تكن الكاتبة ملمّةً بالحد الأدنى من جوانبها الهوياتية. هذا عدا عن القصور الواضح في فهم مكوّن ثقافي آخر مركزي في العمل وهي شخصية غامضة مثّلتها زوجة أمير الجزائرية، والتي كان البطل مهووساً بها (لأسباب تركتها الكاتبة ملتبسة)، وحيث إنها شكّلت العائق الذي حال بينه وبين وقوعه في حب البطلة الفرنسية، وقد أتى وصف "نعيمة" باختصار على أنها "شقراء جميلة، لكنك يمكن أن تنسى جمالها بعد لحظات فقط من مقابلتها"، رافقه تعليق مبهم من خالة البطلة على النموذج الجزائري في الحب.
كان بالإمكان أن نعزو هذا القصور في الولوج إلى عمق الشخصيات العربية في الرواية إلى تقصُّد الكاتبة إظهار الشخصية "الشرقية" على أنها مكوّن معتم في المجتمع الأوروبي يصعب النفاذ إليه، كما كان بالإمكان تصنيف هذا العمل على أنه يندرج ببساطة ضمن فكرة "الشرق شرق والغرب غرب، ولن يلتقيا"، خصوصاً أنّ الكاتبة اختارت أن تختم روايتها مظهرةً البطلة وهي تُخرج الخاتم الصدئ من مخبئه "ملتقطةً إياه بطرفي أصبعيها، لتتفادى المزيد من الاحتكاك معه، وتلقيه بعيداً عنها" (ص 123).
وليت فيراتو لم تفلت بناء الشخصية الفرنسية في نصّها هي الأخرى، ولم تخفق في الإمساك بلحظة باريس كابنة أصيلة للمدينة، إذ أتى وصف الكاتبة الإيطالية للعاصمة الفرنسية في روايتها مثل وصف أيّ سائح لشوارع عاصمة الجن والملائكة في أعياد رأس السنة والعطلات الربيعية. هذا عدا أنها كانت تتحدّث طيلة صفحات الرواية بصوت إيطالية مُحدثة الدخول إلى عالم البورجوازية لا بصوت أرستقراطية فرنسية، وذلك رغم محاولتها حشد كلمات من لغة موليير طيلة صفحات الرواية، لتذكّرنا في كلّ مرّة أننا بصدد التعاطي مع شخصية باريسية، وذلك بالموازاة مع توظيف كلمات عربية هنا وهناك (من اللهجة التونسية) لإقناعنا بأنها ملمّة بالخلفية اللغوية لبطلها السوري. وهكذا قدّمت فيراتو نموذجاً قاصراً عن هذا النوع من الأدب، في رواية أتت عرجاء ثقافياً على محور غرب/ غرب، وشرق/ غرب سواءً بسواء.
 في المقابل، تقدّم ماريا كريستينا فاكانوني، الأستاذة في جامعة كافوسكاري بالبندقية، رواية مختلفة، تدور أحداثها كلّياً في الجزائر العاصمة بعنوان "باحة جزائرية دون إطلالة"، صدرت عن "دار روبين" (2012). استغلّت الكاتبة البعد متعدّد الثقافات لهذه المدينة المتوسّطية من أجل نسج أحداث رواية بوليسية، تبدأ بجريمة قتل يتمّ اكتشافها في المقبرة اليهودية بـ"سانت أوجان"، تكون إحدى السائحات الإيطاليات "ماريا" شاهدة عليها، لتبدأ رحلة تحقيق حولها رفقة صديقها الجزائري "حسان"، بالموازاة مع التحقيقات الرسمية التي يقودها المحقّق نيدوتاك.
في المقابل، تقدّم ماريا كريستينا فاكانوني، الأستاذة في جامعة كافوسكاري بالبندقية، رواية مختلفة، تدور أحداثها كلّياً في الجزائر العاصمة بعنوان "باحة جزائرية دون إطلالة"، صدرت عن "دار روبين" (2012). استغلّت الكاتبة البعد متعدّد الثقافات لهذه المدينة المتوسّطية من أجل نسج أحداث رواية بوليسية، تبدأ بجريمة قتل يتمّ اكتشافها في المقبرة اليهودية بـ"سانت أوجان"، تكون إحدى السائحات الإيطاليات "ماريا" شاهدة عليها، لتبدأ رحلة تحقيق حولها رفقة صديقها الجزائري "حسان"، بالموازاة مع التحقيقات الرسمية التي يقودها المحقّق نيدوتاك.
وعلى عكس فيراتو، أظهرت فاكانوني إلماماً أكبر بثقافة العاصمة الجزائرية وإحاطةً بتاريخها الفني ومكوّناتها العقائدية والإثنية واللسانية، لدرجة بدت فائضةً عن حدود السرد الروائي في أماكن عدّة.
أتت مقاربة فاكانوني أذكى من فيراتو من حيث اختيار القالب البوليسي للعمل، حيث يكون البطل بالضرورة هو شخصية المحقّق التي عادة ما تكون نمطية، وتطغى مهامها الوظيفية على تفاصيلها الإنسانية، بالإضافة إلى أن هذا النوع من الروايات يستدعي عدم كشف أوراق الشخصيات كاملة، وهو ما عوّلت عليه الكاتبة لتسويغِ تقديمها الحد الأدنى من الوصف الداخلي لشخصياتها، فكانت بذلك البطلة الإيطالية ماريا هي التي تفكر عن الجميع وتحلّل عن الجميع، وحتى عن المحقّق الجزائري نفسه.
إلا أن هذه الزاوية المحدودة من السرد جعلت العمل يبدو مهلهلاً على صعيد البناء الدرامي للشخصيات التي كانت كلّها متشابهة وتتكلّم بصوت واحد، وهو ما حال دون إشراك القارئ في تخمين دوافع أي من المشتبه بهم، وفي النهاية مرتكب الجريمة، لتفشل هذه الرواية ضمن بنيتها الداخلية، قبل الخارجية، في امتحان السرد البوليسي الذي أغفلت فيه الكاتبة ضرورة فك شفرات النفس البشرية، قبل محاولة فكّ شفرات "الآخر" اللغوية والدينية. "لتبقى الجزائر لغزاً أبدياً بالنسبة إلى مارياً" (ص 202)، وتختم الكاتبة روايتها بهذه الطريقة وهي تودّع "مدينة فريدة من نوعها، تختلف عن مدن المتوسّط الأخرى وبقية المدن المغاربية، بفعل ذلك المزيج العرقي الذي ترك أثره واضحاً في ملامح أهلها" (ص 200).
تعكس ملامح السرديات متعدّدة الثقافات في الأدب الإيطالي المعاصر، إلى حد كبير، موقفاً مجتمعياً مرتاباً من فكرة التعدُّدية الإثنية والثقافية، ونخبة إيطالية هي وجهان لعملة واحدة تتقاسم بيمينها ويسارها النمط الفكري القائم على وضع حدود فاصلة بين الأنا والآخر، إذ لا زالت سرديات اليمين تُشبه أغلفة مجلّة "فوغ" سنوات السبعينات، بينما تبدو سرديات اليسار غارقةً في عوالم إكزوتيكية ووضعيات مفتعلة لعارضات يرتدين أزياء إثنية مبالغاً بها.
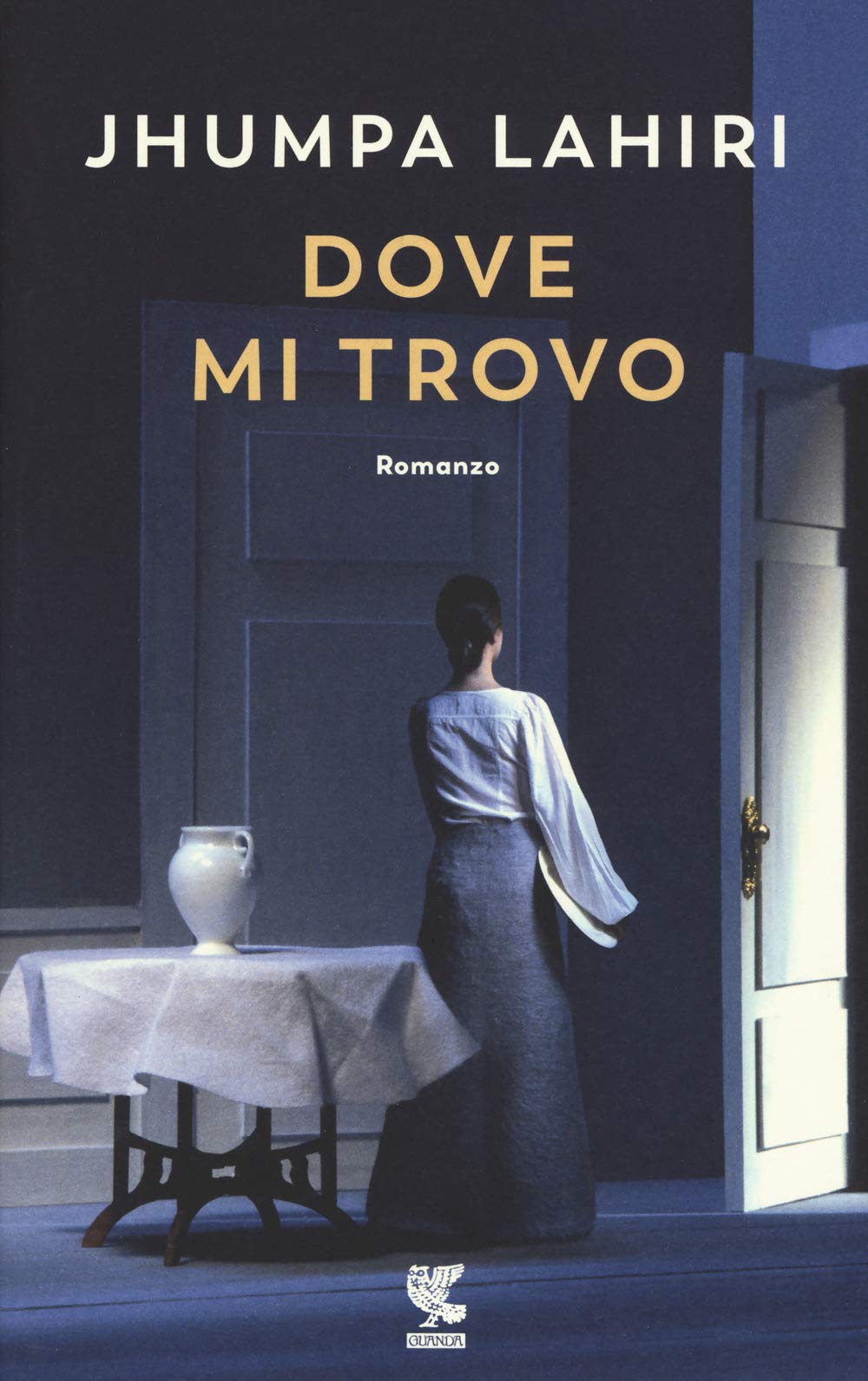 لكن، كان لا بد في النهاية أن تهب ريح مختلفة على الأدب الإيطالي لتبثّ فيه نفساً غير محدّد إثنياً، وتمنحه بعداً تتمازج فيه ملامح الأنا بالآخر على نحو انسيابي يعكس واقع الحقبة التي نعيشها. وهكذا حملت جومبا لاهيري ملامح تجربتها السردية الخاصة إلى إيطاليا، في رواية صدرت لها بعنوان "حيثما أكون" عن "دار غواندا" (2018).
لكن، كان لا بد في النهاية أن تهب ريح مختلفة على الأدب الإيطالي لتبثّ فيه نفساً غير محدّد إثنياً، وتمنحه بعداً تتمازج فيه ملامح الأنا بالآخر على نحو انسيابي يعكس واقع الحقبة التي نعيشها. وهكذا حملت جومبا لاهيري ملامح تجربتها السردية الخاصة إلى إيطاليا، في رواية صدرت لها بعنوان "حيثما أكون" عن "دار غواندا" (2018).
هذا العمل الذي ألّفته الروائية الأميركية من أصل هندي والمقيمة في إيطاليا منذ 2010، مباشرة باللغة الإيطالية، لا تدور أحداثه في مكان محدّد ولا يبدو وكأن شخوصه يتحدّثون لغة بعينها، حيث تتفادى البطلة، على نحو مقصود، تسمية الأماكن التي تتواجد فيها أو ذكر أسماء أًصدقائها أو زملائها في العمل، وحتى وهي تسافر وتسمع لغات أجنبية لا تعرفها، لا تحدّد أبداً وجهتها ولا تُشعرنا بحالة انقطاع التواصل مع أشخاص لا تفهم ألسنتهم، بل هي تقع في لحظة حب مرهفة مع زميل لها حضر مؤتمراً علمياً في بلد أجنبي لم تتبادل معه فيه كلمة واحدة، حين تناهى إلى سمعها صوته وهو يتحدّث من غرفته في الفندق على الهاتف بلغة "أجنبية".
تواصل لاهيري (1967)، من خلال فصول روايتها، ذات المشاهد المنفصلة المتّصلة، والتي يتوالى فيها عرض لوحات من الحياة اليومية لبطلة قد يجد كلُّ شخص فينا شيئاً منها، إذ لا حبكة محدّدة ولا عقدة ولا تصاعد في الأحداث في الرواية، فقط محاولة التقاط لحظات الهشاشة للنفس البشرية في يوميات عادية يخلص فيها القارئ إلى أن لحظات الاغتراب الحقيقية في زمننا ليست هي التي نعيشها بسبب ما نعتقد أنه حدود تفصلنا عن الآخر تحت مسمّيات اللغة والثقافة والإثنية والدين والهوية والجنس، إنما مردُّها هو تضييع طريقنا نحو صميم أنفسنا التي لن نُوفَّق أبداً في الاستكانة لها إن بقينا عالقين على باب القشور التي تلفّها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"تقاليد" إكزوتيكية
رغم التحوّلات الثقافية الجذرية التي تشهدها بلدانهم، لا يزال كتّاب عرب ملتزمين بتلبية متطلّبات الوكلاء الأدبيّين الأجانب، والمتمحورة حول نشر أعمال أحادية الثقافة من شأنها إضافة لمسة إكزوتيكية على المكتبة الغربية، يكون فيها الكاتب القادم من ثقافات الهامش، هو "الكائن" أحادي الجينات الذي يُفترض أن يقدّم أدباً مقفلاً يحوم على ثيمة الحروب الأهلية والعقائدية وثيمة الاضطهاد الذكوري الكلاسيكية.
* كاتبة جزائرية مقيمة في إيطاليا



