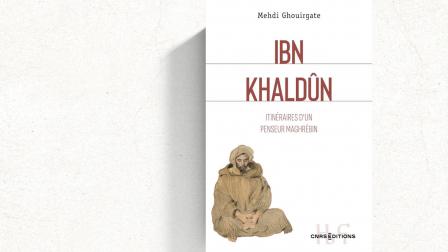في كتابه "فلسفة الثورة" (منشورات زوركامب)، يحاول المفكّر الألماني غونار هيندريش (1971) تقديم تفسير فلسفي للثورة، خلافاً للتفسيرَين التاريخي والسياسي، مُنطلقاً من أربعة مفاهيم لكل منها مجاله الخاص به: أكريفوسيا (الحق)، والإيتيقا (السلطة)، والإستيتيقا (الجمال)، والميتافيزيقا (الإله). فالعمل يتساءل عن الحق الذي يؤسّس للثورة، وكيف يُؤثّر على الحياة في المجتمع الثوري، وعن التمظهرات الجمالية التي يتّخذها الفعل الثوري، وأخيراً عن علاقة الثورة بالإله. تُركّز هذه القراءة على النقطة الأخيرة؛ أي على العلاقة بين الدين والثورة.
رغم أن الكتاب جاء، كما يُخبرنا صاحبه في مقدّمته، بمناسبة الذكرى المئوية لثورة أكتوبر (1917)، والتي لا يعتبرها ثورةً روسية محضة، بل ثورة تندرج في التقليد الشيوعي للطبقة العمّالية الأوروبية حملت على عاتقها الوفاء بوعود الثورة الفرنسية التي ظلّت معلّقة، فإنه لن يقتصر على دراسة هذه الثورة.
يفهم هيندريش، في مقدّمة عمله، الثورة باعتبارها تعطيلاً للقواعد. ولأن القواعد ليست معطاةً بشكل طبيعي، إذ إنها من عمل الإنسان، فإن الإنسان يملك حق تجاوزها إذا وقفت ضدّ حريته. الثورة هي بذلك تأكيد حرية اجتراح القواعد. لكن كلّما جرى النظر إلى المجتمع باعتباره طبيعة، وذلك بغض النظر عمّا إذا كان الأمر يتعلّق بطبيعة أولى أو ثانية، يصبح كل تمرّد على القواعد بمثابة خروج على الطبيعة.
تضع الثورة حدّاً لهذه التبعية، ويظهر المجتمع فيها باعتباره مجتمعاً وليس باعتباره طبيعة؛ فـ "الثورة شيء غير طبيعي"، والفعل الإنساني شيء غير طبيعي أيضاً، بمعنى أنه لا يمكن تفسيره وفقاً لقوانين الطبيعة. وفي هذا السياق، تُعتبر السيادة في الدولة الديمقراطية ممارسة للإرادة العامة، فهي ليست سيادة طبقة على طبقة أو حاكم على شعب، بل هي تعبيرٌ عن التضامن والاتفاق بين كل أعضاء المجتمع. وهو ما عبّر عنه روبسبيير في خطبته حول إعدام الملك. فالنظام القديم لم يعرف سيادة الإرادة العامة بل سيادة الفرد، وسيادةُ الفرد تُجهِز على العقد الاجتماعي. ولهذا، فإن حكومة هذا الملك لا تملك أساساً قانونياً، وعلاقةُ الشعب بها ليست علاقة قانونية اجتماعية. "الملك يوجَد دوماً خارج القانون"، ولهذا، وكما عبّر روبسبيير، لن نكون مضطرّين إلى محاكمته قانونياً.
يعود هندريش إلى جان جاك روسو وإيمانويل كانط وكارل ماركس، من أجل تفسير الثورة باعتبارها قطيعة مع القانون القائم ومع الخضوع المعتاد للقواعد. فمع روسو، سيُفكّر في الشعب باعتباره ذاتاً قانونية، تتمظهر إرادته العامّة في الثورة باعتبارها مؤسّسة للقانون. أمّا الواجب الأخلاقي لدى كانط، فهو يتشابه بُنيوياً مع الإرادة العامة لدى روسو، فمعه يتعلّق الأمر أيضاً بتشريع عام، يتأسّس على الإرادة المحضة. لكن وفي الوقت الذي لم يصل كانط إلى الحديث عن حقّ في الثورة، سيتحقّق ذلك مع فيشته، وبشكل أكبر مع ماركس والماركسيّين.
"الانتقال من الخضوع إلى الحرية يعني ربط محدّدات الفعل المادية ببنية القانون الكوني: ولا شيء آخر غير ذلك يطالب به الواجب الأخلاقي: Kategorischer Imperativ. تتصرَّف بطريقة تجعل قاعدة سلوكك مبدأ لتشريع عام. وفي الوقت الذي يُحقّق الإنسان ذلك، يتجاوز الوضع الطبيعي (...). وفقاً لذلك، يُمكن إعادة صياغة الواجب الأخلاقي بالطريقة الآتية: تصرَّف بالطريقة التي تجعل حريتك العملية تتوافق مع الحرية العامة". سيقوم فيشته بتجذير الفكرة السياسية في الحرية الأخلاقية كما صاغها كانط، وتصبح من هنا فصاعداً حرية الفرد أساساً للدستور باعتبار أنها ليست شيئاً آخر غير تحقيق للواجب الأخلاقي الذي يتوجّب أن يحكم القانون والدستور.
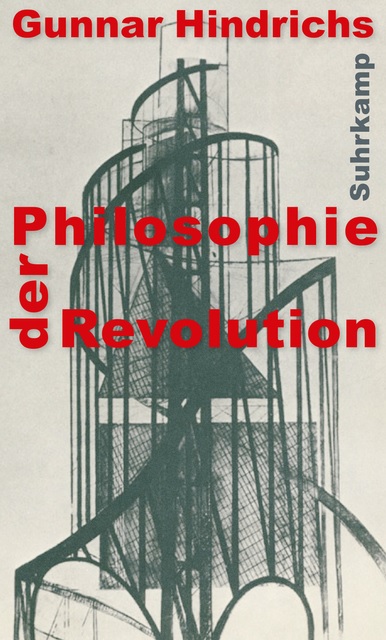 مِن القاعدة التي صاغها يوهان فيشته والتي تقول: "لا تمنع حريةَ أحد، ما دامت لا تمنعك"، سيشتق فيشته، وبخلاف كانط، الحقَّ في الثورة، مُطوّراً نظريةً للحقوق الذاتية عبر الربط بين المعيار السياسي والمعيار الأخلاقي. لكن، إذا ما عملت دولة معيّنة ضد ذلك، "فإنها لن تكون دولة، إنها جهنم، ويتوجّب على الناس أن يحرّروا أنفسهم منها ويدمروها"، كما كتب يوهان بنيامين إرهارد في كتابه "عن حقّ الشعب في الثورة". إنه يرى وجود ثلاثة حقوق لا تقبل المساومة: الحق في الحرية، المساواة، والاستقلالية. وإذا وقفت الحكومة ضدّ هذه الحقوق الثلاثة، تصبح الثورة واجباً أخلاقياً.
مِن القاعدة التي صاغها يوهان فيشته والتي تقول: "لا تمنع حريةَ أحد، ما دامت لا تمنعك"، سيشتق فيشته، وبخلاف كانط، الحقَّ في الثورة، مُطوّراً نظريةً للحقوق الذاتية عبر الربط بين المعيار السياسي والمعيار الأخلاقي. لكن، إذا ما عملت دولة معيّنة ضد ذلك، "فإنها لن تكون دولة، إنها جهنم، ويتوجّب على الناس أن يحرّروا أنفسهم منها ويدمروها"، كما كتب يوهان بنيامين إرهارد في كتابه "عن حقّ الشعب في الثورة". إنه يرى وجود ثلاثة حقوق لا تقبل المساومة: الحق في الحرية، المساواة، والاستقلالية. وإذا وقفت الحكومة ضدّ هذه الحقوق الثلاثة، تصبح الثورة واجباً أخلاقياً.
وفي الثورة يتصرّف الشعب وفقاً لقوانين يضعها بنفسه، لأنه فقط، عبر الثورة، يتحوّل الشعب إلى ذات قانونية، تسري عليها القوانين التي وضعها هو بنفسه. وفي لغة ماركسية: إن الثورة تجاوزٌ للاستلاب؛ فـ "العامل لا يمكنه النظر إلى ما ينتجه، باعتباره منتوجاً خاصاً به". إنه لا يمتلك ما ينتجه كما لا يمتلك عمله. وكما كتب ماركس "لا يشعر العامل بنفسه إلّا خارج العمل. أما في العمل، فهو خارج نفسه". وبلغة أخرى، لا يملك العامل في المجتمع الرأسمالي حريته، ومن هنا ينبع حقّه في الثورة.
ومن أجل تسليط الضوء أكثر على هذه العلاقة بين الحرية والثورة، يتطرّق هيندريش في الفصل الأخير من كتابه إلى ما يسمّيه إله الثورة وعلاقته بمملكة الحرية. وهنا سيقدّم الفيلسوف مساحة كبيرةً من كتابه لمناقشة كتاب الفيلسوف الأميركي مايكل والزر "الخروج والثورة".
والزر الذي نظر إلى أسطورة خروج اليهود من مصر باعتبارها المشهد الأصلي للثورات الأوروبية، مؤكّداً أن هذا الخروج كان مشروعاً ثورياً، وأن الثورة تتضمّن دوماً لحظة خروج.
يقرأ والزر قصّة الخروج كتاريخ تقدم، وكنعان هي نقيض مصر، والطريق إلى كنعان قاس ومقفر. إنه يمر عبر الصحراء. و"الصحراء مدرسة الحرية"، كما يكتب هندريش. وبغض النظر عمّا إذا كانت سياسة الخروج مختلفة عن السياسية المسيحانية التي تطلب تحرير الإنسان خارج التاريخ أو يتحقّق فيها التحرير المنشود كنهاية للتاريخ، فإن ما يستوقف القارئ هنا هو النقد الذي عبّر عنه هندريش لما كتبه إدوار سعيد في مراجعته الشهيرة لكتاب والرز.
ولا بأس أن نُذكّر هنا بنقد سعيد والمتمثّل في أمر أساسي، وهو أن قصة الخروج كما يحكيها والزر لا تأخذ في الاعتبار مصير الكنعانيين؛ سكّان كنعان الأصليين، فكنعان التي ستكون أرض الحرية وجنة الله على الأرض بالنسبة إلى اليهود ونقيضَ عبوديتهم في مصر، يبدو سكّانها خارج كل ميثاق مع الإله، وبلغة سعيد: "إن الكنعانيين مقصيّون من عالم الاهتمام الأخلاقي"، وهو ما يحرمهم من حقوق مماثلة لحقوق اليهود.
في هذا المقال نفسه، سيوضّح سعيد العلاقة بين كتاب والزر حول الخروج ومقال قديم له صدر عام 1967، يحمل عنوان: "إسرائيل ليست فيتنام"، يحاول فيه والزر الدفاع عن "إسرائيل"، مُعتبراً أنها تختلف عن الدول الاستعمارية مثل فرنسا والولايات المتّحدة وبريطانيا.
يرفض هيندريش نقد سعيد لوالزر، لأنه برأيه يخطئ المعنى الثوري للخروج، فبما أن الثورة تضع قواعد الفعل من جديد، فإنها ستُحدّد عبر ذلك هويات الضحايا وأعضاء الثورة المضادّة، مؤكّداً أن تمحوُر النقد اليساري اليوم على قضايا الهوية والإقصاء، يشكّل نوعاً من نسيان الثورة، وينتهي باليسار إلى نوع من "الأخلاقوية الرسمية".
وهنا يتوجب الرد على الأقل في نقطتين على هيندريش: أولا، إننا لم نتفق بعد إن كان يمكن اعتبار خروج اليهود من مصر النص الأصلي للثورات الأوروبية، أو تعبيرا مكتملا عن الثورة. ثانيا، إن نقد سعيد لوالزر يذكرنا بالنقد الذي وجهه بنيامين لفكرة التقدم في نصه الشهير عن "مفهوم التاريخ"، وبلغة أخرى إن ثورة لا تلتفت إلى الضحايا وتنظر إلى الآخرين باعتبارهم حطبا لها، لا تستحق اسمها، وفي لغة شخصانية: "إنني لا أتحرر إلا وأنا أُحرر"، ففي فعل التحرير تكمن الحرية الإيجابية وليس في اتفاق نبرمه مع الآلهة.