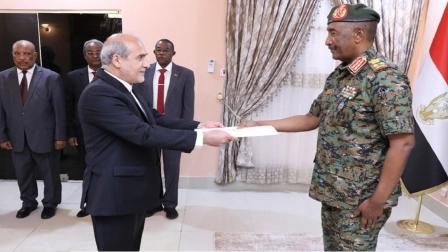رجعتُ إلى البيت سالماً، وقد انتابني شعور بالنقص لأن أترابي من التلاميذ أصيبوا أو استشهدوا..
ألقيتُ بحقيبة المدرسة في الصالون، وكانت الأحداث مستمرة. وحين عزمت أن أخرج ثانيةً صرخت أمي: "لا تذهب لبعيد.. روح هات جرّة الغاز من دكانة موسى". وخرجتُ بذريعة الجرّة.
كانت الأحداث على أشدّها. في كل ناحية رشقُ للحجارة ومطاردات جيبات "حرس الحدود" للمتظاهرين. بالصدفة، وجدتني أجري مع اثنين من أبناء عمّي، ووراءنا تماماً جيب لحرس الحدود.
ولأننا لا نملك أجنحة لم نطر. كنا قد وصلنا حارتنا، ولكن بقيت خمس دقائق من الجري لنبلغ بيوتنا. خانتنا أجسادنا الرياضية، فلجأنا لطلب الحماية في دكان الحاج "موسى النجار". ونزل الجنود خلفنا. قبضوا علينا. أحدهم أخذ عكاز الحاج موسى، وانهال علينا بالضرب على كل مكان في أجسادنا.
جنديّ آخر دفع الحاج وأوقعه وحمل مصفوفات البيض وكسّرها علينا. أخذونا في الجيب وداروا بنا ساعة على أطراف خان يونس، ولم يكفّوا عن التسلّي بنا. استهدفوا مفاصل أجسادنا بكعاب البنادق. كنا معصوبي العيون ومقيّدي الأيدي. كوّمونا على بعض في زاوية الجيب. كنت أبكي وفم ابن عمي "أشرف" على أذني. كان يقرأ قصار السور والأدعية على نفسه وعليّ.
في المركز العسكري (الذي تحوّل بقدوم السلطة لمدرسة تحمل اسم "أبو يوسف النجار") فرزونا بحكم السنّ: أنا بعمر 14 سنة، وأشرف بعمر 15 سنة. أما ابن عمي الثاني، جودت، فحُوّل لمكان آخر باعتبار أن عمره كان فوق الـ18.
أوقفونا صفّاً واحداً وكان معنا عشرات المعتقلين من الأطفال والشبان. مع طول الصفّ، كان يمشي ضابط غليظ يتكلم العربية، وقف وسألني: "ليش بتحدف حجار على الجيش"، قلت له: "كنت رايح أجيب جرة الغاز". بصق في وجهي، وضرب الواقف خلفي كفاً.
وضعوني، أنا وأشرف، في غرفة توقيف ضيقة وقذرة. وهناك، صرنا ننظر إلى بعضنا البعض.. نبكي ونصمت. وفجأة تناهى إلى أسماعنا ضحك هستيري. سمعنا مجنّدة تتغنج مع مجنّد، وكانا يقتربان من باب الغرفة.
سمعنا صوت نهنهات القبل على الباب الذي فتحه الجندي ظناً منه أن لا أحد في الغرفة، كي يأخذ فرصته منها. واستطعنا رؤية صدرها الطافح المكشوف، لكن الجنديّ تفاجأ بنا كلعنة، بصق علينا ورطن بالعبرية الشتائم وأغلق الباب. قلت لأشرف بنبرة طفل يفكّر بالانتقام، والجندي يغلق علينا الباب: "تعال نقتل الجندي و... المجندة" وضحكنا.
بعد نصف ساعة جاء جندي، وأخذنا إلى غرفة الكابتن يوسف. بدأ باستجوابنا وشتمنا. قال لي: "أعطني رقم تلفون أهلك"، وأعطيته رقم ابن عمي المحامي غسّان. اتصل به وقال له أمامنا: "فيه هدية لكم عندي تعالوا خذوها".
أخبره أن نصر وأشرف محتجزان وسيحبسان ويُرحّلان إلى سجن النقب إن لم يحضر أهلهما. بعد ساعة وصل أبي وغسّان وبعض الأقرباء. أوّل ما رآني أبي بيد متورمة ووجه مجروح، نفخ في قبضته وضربني أمام الكابتن كفّاً، وقال له الكابتن: "يا حج هسّا جاي تربّي ابنك؟".
أجبر الكابتن أبي على التوقيع على تعهّد بعدم تكرار ذلك، ودفع غرامة قدرها 1000 شيكل، وهي كبيرة يومها على أب مسن لا يعمل، لكن لم يكن له خيار وإلا سأحبس أسبوعاً، وقد اقترب موعد تقديم الامتحانات النهائية، وكنت في الصف الثاني إعدادي.
أما أشرف فقد حُبس أسبوعاً لتعذّر دفع أهله الغرامة. وبمرور الأيام، عاش أشرف الدور، فكان في كل زيارة يومية يقوم بها المحامي غسان، يطلب منه إحضار السجائر. أما جودت، فقد حُوّل إلى سجن النقب وحكم عليه بالسجن سنة.
بعد التعهد بدفع الغرامة، فـُكّ أسري، وأخذوني إلى مستشفى ناصر (نسبة إلى جمال عبد الناصر) في غرب خان يونس، وصوّروني وكنت أعاني من كسر خفيف في يدي ورضوض ووجع عظام.
*****
وأنا في الصفّ الثالث إعدادي، ظهيرة يومٍ كانت فيه المواجهات مع الاحتلال في خانيونس مستمرة كعادة يومية. كنت أنا السبّاق في إخبار أهل ابن الجيران "محمد" و أهل ابن عمي "أشرف"، عن إصابة الأخيرين بالرصاص الحيّ.
أصيب الإثنان أمامي من قناص كان يعتلي بيتاً لعائلة "اللحام" يقع على المحور بين مخيّم خانيونس والبلد. في اليوم الثالث بالضبط، لشدة غيرتي، حدست، لئلا أقول تمنّيت، بأنني سأصاب في ذلك اليوم.
ودفعني حدسي لأن أحدّث نفسي وأقوم بعمل احتياطات تقيني الخجل - ليس من الرصاصة بالطبع - إذ كنت أرتدي بنطال جينز وتحته "كيلوت" مخروق. قلت لنفسي: إذا أصبت سيعريني المسعفون ويروا الخرق. ومن كلّ عقلي دخلت الحمام، لبست "شورت" طويلاً فوقه، ثم لبست الجينز، وخرجت إلى البلد. ولا أعرف، إلى الآن، لماذا لم أحدس بأني سأصاب في الرأس أو القلب؟
على سطح بناية صفراء، أول شارع البحر، كان يوجد قناصة. وتحت البناية، تعسكر سيارة جيب عسكرية. رشق الحجارة مستمر كالمطر على الجيب والبناية. والمكان يعجّ بالشبان وسياراتِ الإسعاف لنقل الإصابات إلى المستشفى. إصابات كثيرة كانت على مرأى عيني، فيما الحجارة في يدي. كنت أشارك، رغم صغر سني، في الجري لحمل المصابين. إلى أن رأيت حدسي بكل يقين موجع.
سدّد القناص رصاصة متفجرة من نوع "دمدم" إلى فخذ رجلٍ أربعينيّ بدين كان يقف بعيداً قليلاً أمامي اسمه "علي شراب". ورغم أن عليّاً كان أطول مني بحكم السنّ، إلا أنني لا أعرف كيف أكملت الرصاصة طريقها إلى لبّ فخدي فوق الركبة بعشر سنتمترات تقريباً، بعيداً عن العصب؟
حملونا، أنا وعلي، في سيارة الإسعاف. كان الدم ينزف. ضحكتُ من ألمي الشديد، أو من فرحتي بتحقّق شعرية الإصابة الحقيقية، في وجه "علاء"- وهو شاب من أقرباء أمي - لحظة إغلاق المسعف باب السيارة لتطير بنا إلى مستشفى ناصر. وصار علاء يضحك أيضاً ويقول: "ماكل طلق وبتضحك!". لا أعرف من أخبر أهلي عن حدث إصابتي، ربما علاء.
لفّ الأطباء جُرحي، ولم يُخرجوا الشظايا التي ما تزال في جسمي وأتحسّسها إلى الآن. ومنها شظية سرحت إلى فوق في مكان مخجل. كان أهلي قد وصلوا المستشفى، ووقفوا على تصويري في غرفة التصوير بالأشعة.
بعد ساعة، خرجت من المستشفى لكثرة الإصابات وقلّة الأسرّة. أوّل ما وصلت البيت، صرخَت أمي في وجهي و بكت، ووبّختني بنبرة خوف، ثم صنعت لي عصير ليمون شربته والناس فوق رأسي تطل عليّ.
(أوسلو)