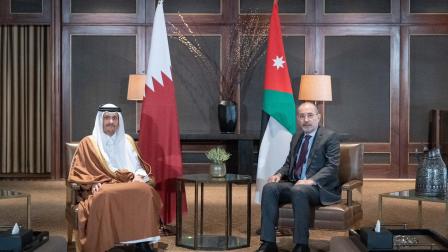تحل الذكرى الثامنة للإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي، بانقلاب عسكري دموي بين 30 يونيو/ حزيران 2013 و3 يوليو/ تموز منه، بعد ساعات من مرور ألف يوم على اختفاء النائب الأسبق مصطفى النجار. وقد انقطعت أخبار النجار منذ أواخر شهر سبتمبر/ أيلول 2018، عندما هاتف زوجته من أسوان، جنوبي البلاد، قبل تلقّيها اتصالاً من مجهول ينبئها بالقبض عليه. وخلال تلك الفترة ضربت الحكومة عرض الحائط بحكم قضائي ملزم بالكشف عن مصيره، متجاهلة مئات البلاغات الأخرى للنيابة العامة بالاختفاء القسري لمواطنين ثم ظهورهم بعد فترات طويلة للتحقيق معهم، كمتهمين في قضايا ذات بعد سياسي. وعلى الرغم من أن اختلافات عديدة طرأت على بنية السلطة الحاكمة في مصر وتحالفاتها في الداخل وعلاقاتها الخارجية على مدار ثماني سنوات، إلا أن القمع والتنكيل بالمعارضين وفرض المزيد من القيود تباعاً على الحريات العامة، خصوصاً السياسية والتنظيمية والتغول على الحقوق الشخصية، ظلت من الأركان الأساسية للنظام برئاسة عبد الفتاح السيسي الذي يحاول حالياً أن يضفي عليها وصف "الجديدة". وحافظت الأجهزة الأمنية والسيادية على عاداتها القمعية كاملة، بل واستطاعت بمساعدة القضاء تارة والبرلمان تارة أخرى، تطوير استخدام أدوات القمع لتضفي عليه التقنين اللازم للدفاع عن ممارساتها أمام العالم، والادعاء بأنها جميعاً ذات سند قانوني.
توسعت الأجهزة الأمنية في استخدام أشكال التعذيب المختلفة وسوء المعاملة
ويمكن رصد صور مختلفة من تطوير أدوات التنكيل بالمواطنين والعصف بحقوقهم؛ بداية من الإخفاء القسري الذي طاول عدداً غير معروف من المواطنين، يُرجح أن يكون مصطفى النجار أحدهم. وبعدما كان الإخفاء يحدث في الفترة الفاصلة بين الاعتقال والظهور أمام النيابة العامة في التحقيق الرسمي، سواء طالت تلك الفترة أو قصرت، أصبحت للإخفاء صور أخرى في الآونة الأخيرة. وبات معتاداً أن يحدث بعد عرض المعتقل سريعاً من دون محام على النيابة لاستصدار قرار بحبسه، ولا يُحال بعده المعتقل إلى قسم شرطة أو سجن كما ينص القانون، بل يتم إخفاؤه في مكان غير معروف تابع غالباً للأمن الوطني للتحقيق معه واستقاء المعلومات والضغط عليه، كما حدث أخيراً في حالة السفير السابق يحيى نجم.
وداخل أماكن الاحتجاز والسجن، توسعت الأجهزة الأمنية في استخدام أشكال التعذيب المختلفة وسوء المعاملة ضد المتهمين والمحتجزين، ما أودى بحياة مئات الأشخاص، مع إفلات متكرر للجناة من العقاب أو الاكتفاء بعقوبات مخففة لا توازي الجرم المرتكب، بحسب تقرير حقوقي جماعي من عدة منظمات صدر يوم السبت الماضي بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة التعذيب"، الموافق في 26 يونيو من كل عام.
ورصدت المنظمات أساليب عدة، أبرزها الصعق بالكهرباء أو التحرش الجنسي بهدف انتزاع الاعترافات أو الإذلال، فقد تعرّض إبراهيم عز الدين ومحمد الباقر وإسراء عبد الفتاح وعلاء عبد الفتاح لاعتداءات بدنية متفرقة خلال فترات احتجازهم. وفي بعض القضايا تم تأييد أحكام بالإعدام وتنفيذها استناداً إلى اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب، في محاكمات عسكرية وجنائية، مقابل تجاهل تام من القضاء لفحص مئات الشكاوى والبلاغات بالتعذيب، وتعمد رفض فتح تحقيقات جادة حولها أو حتى تنفيذ طلبات الدفاع بعرض الضحايا على الطب الشرعي.
كما رصدت المنظمات الحقوقية ارتفاع وتيرة الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، خصوصاً أقسام الشرطة. ويحظى الضباط مرتكبو هذه الجرائم بإفلات تام من العقاب، كما حدث في واقعة قتل المحامي كريم حمدي جراء التعذيب في قسم شرطة المطرية كما جاء في تقرير الطب الشرعي، والتي برأت محكمة النقض فيها الضباط المتورطين في تعذيبه. كما استبعدت المحكمة اتهامات التعذيب بحق الشاب محمد عبد الحكيم، المعروف بـ"عفروتو"، الذي لقي مصرعه نتيجة التعذيب في قسم شرطة المقطم عام 2018. وكذلك في العام الماضي في جريمة مقتل الشاب إسلام الأسترالي بقسم شرطة المنيب نتيجة التعذيب، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل الضابط المتهم وحبس أربعة من أمناء الشرطة على ذمة التحقيق.
رصدت المنظمات الحقوقية ارتفاع وتيرة الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز
وبينما أصبح معتاداً ومثيراً للسخرية تعمد وسائل الإعلام تصوير السجون كفنادق مريحة لإقامة نزلائها، خلال تصوير الزيارات المجهزة سلفاً والمعدة خصيصاً لتفنيد الانتقادات الدولية لأوضاع السجون، وثقت مجموعة من المنظمات الحقوقية ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات داخل أماكن الاحتجاز، وصلت إلى 400 حالة وفاة داخل السجون خلال السنوات الأربع الماضية. وذكرت المنظمات أن السلطات المصرية لا تسمح للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، فضلاً عن عدم تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان من زيارة السجون بشكل مستقل ومفاجئ. بالتالي أصبحت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
وخلال العام الماضي، وبعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين عناصر الأمن والنزلاء في السجون، ومنع الزيارات بشكل عام ثم تنظيمها بصورة مقيدة وتعسفية، ثارت حالة من التوتر والاضطراب، خصوصاً بين المحكومين السياسيين والمحبوسين احتياطياً، الذين يتعرضون، بحسب التقارير الحقوقية، للتعذيب والتجاوزات والتشدد خلال فترة الحبس الأولى لهم حتى صدور الأحكام ضدهم. ويعاني هؤلاء أيضاً منذ إعلان وزارة الداخلية استئناف الزيارات للسجناء والسماح لذويهم بالحضور إلى السجون، للمرة الأولى منذ بدء اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا في منتصف مارس/ آذار 2020، بعدما أدت سياسة السجون في إدارة آلية الزيارات الجديدة لانتشار حالة من التوتر والغضب والمشادات بين السجناء والإدارات، وتفاقم سوء الحالة النفسية لآلاف السجناء الذين تم منع الزيارات عنهم طوال هذه المدة، وما زالوا محرومين بسبب طبيعة القضايا الخاصة بهم. وارتفعت أيضاً أعداد المرضى والمتوفين، كما يحصل كل صيف، نتيجة الحرارة الخانقة وظروف الطقس السيئة وحرمان المعتقلين في أماكن عديدة من التهوئة الصحية.
وأضيفت هذه الأسباب المعيشية إلى الأسباب السياسية والقانونية المعتادة، لتلقي بظلال من القلق والتساؤلات حول الحالة النفسية والصحية للسجناء ذوي الخلفيات السياسية وكيفية التعامل معهم، خصوصاً بعد الوفاة الغامضة للفنان شادي حبش بسجن طره في مايو/ أيار 2020، ووفاة عمرو علي أبو خليل وعصام العريان واثنين آخرين في السجن نفسه، الصيف الماضي، ثم حادث مقتل أربعة من السجناء وأربعة من عناصر الداخلية في سجن العقرب شديد الحراسة بالمجمع نفسه في سبتمبر الماضي. وتؤكد هذه الأنباء مسؤولية السلطات، فالقواعد الأساسية في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية تنصّ على مسؤولية السلطات في الحفاظ على صحة المحتجز أو السجين. وتتمثل السلطات هنا بوزارة الداخلية ومصلحة السجون، والتي ينصّ دورها على منع دخول أشياء قد تضرّ بصحة المحتجز أو استخدامها للإضرار بنفسه، وكذلك العمل على حمايته، فضلاً عن معاملته بصورة لا تؤثر بالسلب على حالته النفسية.
وإذا حالف الحظ المعتقل في النجاة من الإخفاء القسري والتعذيب، فأمامه العديد من الأخطار الأخرى، على رأسها إهدار حقه في الدفاع والتجديد المستمر والتلقائي للحبس، من دون التأكد من توافر المتطلبات القانونية لذلك. كما أصبح من المعتاد في السنوات الماضية استمرار حبس المعتقلين السياسيين في مصر لأكثر من عامين، وتجاوز المدة القصوى للحبس الاحتياطي من دون اكتراث بأي نصوص قانونية أو طعون مقدمة من المحامين. ثم استحدثت الشرطة والنيابة "ظاهرة التدوير"، عبر فتح قضايا جديدة للمتهمين المحبوسين احتياطياً، البارزين والمشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تركّز عليهم الجهات الحكومية وغير الحكومية الأجنبية في مطالباتها بالإفراج. بالتالي يجد المحبوسون، وهم على وشك إنهاء فترة السنتين، أنفسهم معتقلين على ذمة قضايا جديدة، مثل رئيس حزب "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص وغيرهما. وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أبو الفتوح في منزله في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة عقب عودته من زيارة لبريطانيا، شهدت إجراءه مجموعة من اللقاءات التلفزيونية، التي وجّه فيها هجوماً على السيسي، متهماً إياه بقتل الحياة السياسية والتنكيل بالمعارضين، وتوريط الجيش في الحياة المدنية. ولم تلتفت السلطات المصرية للنداءات المتكررة من المنظمات الحقوقية وأسرة أبو الفتوح بإخلاء سبيله أو تقديم الرعاية الصحية اللازمة له، رغم معاناته الصحية.
استحدثت الشرطة والنيابة "ظاهرة التدوير"، عبر فتح قضايا جديدة للمتهمين المحبوسين احتياطياً
ويكون تدوير المتهمين في الغالب على قضايا فُتحت بعد قضاياهم الأصلية، وتجمع عدداً كبيراً من المتهمين المحبوسين والأشخاص المراقبين خارج السجون، وتتضمن اتهامات الترويج لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. ولا تربط بين المتهمين فيها أي صلة تنظيمية أو حتى معرفة مسبقة ولا حتى نطاق جغرافي واحد، ما يرجح استخدام "التدوير" لفترة كمصيدة لأي شخص ترغب السلطات في التنكيل به، حتى وإن كان حريصاً على عدم إبداء آرائه السياسية عبر مواقع التواصل. ويرجح محامون أن يتم تطوير التنكيل بالتدوير بواسطة إصدار أحكام سريعة في القضايا الجديدة، المتعلقة غالباً بمنشورات المعتقلين السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يقنن استمرار حبس المتهمين لفترات طويلة قبل التصرف القضائي في قضاياهم الأصلية من الأساس.
ومن أشهر القضايا التي تُستخدم حالياً لتدوير المتهمين، القضايا أرقام 1356 و1898 لسنة 2019 و558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، التي تم ضم عدد كبير من المعتقلين إليها من دون وقائع محددة ومن دون صلات بينهم. وتشهد توجيه اتهامات بإساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بسبب انتقادهم لتعامل الحكومة مع انتشار وباء كورونا، أو مشاركة تقارير على حساباتهم لا ترغب السلطات في نشرها.
ووفقاً لمحامين، تكتظ السجون المصرية بأكثر من 1400 حالة تم رصدها لمحبوسين احتياطيين تخطّوا المدة القصوى للحبس الاحتياطي وهي سنتان. مع العلم أن القانون يستثني فقط من قاعدة "الحدّ الأقصى" المحبوسين الذين سبق الحكم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد، عند نظر قرارات حبسهم أمام محكمة النقض أو الإعادة. وعلى الرغم من النص الصريح على ذلك، فإن المحاكم والنيابة العامة كانت تطبقه على نحو مخالف، منذ تعديله في عهد رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور إلى الصيغة المطبقة حالياً. وادّعت أنه يسمح بفتح مدد الحبس الاحتياطي لأي شخص وُجهت له اتهامات يعاقب القانون عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، وبالتالي انتحلت دوائر نظر استمرار الحبس صفة محكمة النقض ومحكمة الجنايات في مرحلة الإعادة. وتعاظمت خطورة الحبس الاحتياطي مفتوح المدة وأثره الداهم على حرية الأفراد، في ظلّ إفراط النظام في اتّباعه، ليتحول من إجراء تحفظي وتدبير مؤقت يهدف في الأساس لمنع التأثير على مجريات القضية أو هروب المتهم، إلى عقوبة بحد ذاتها.
وقبل أيام معدودة مر عامان على حبس آخر مجموعة من المعارضين والتي أطلق عليها إعلامياً اسم "خلية الأمل" زُج أفرادها في السجون، مصحوبين بمجموعة من الاتهامات المعلبة، ومنها "التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين لإحداث اضطرابات سياسية بالبلاد". وهي التهمة المستحيلة في ظل الخلافات السياسية الكبيرة بين أفراد المجموعة من النشطاء السياسيين والجماعة، وفي مقدمتهم زياد العليمي، أحد أعضاء ائتلاف شباب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والذي كانت قبة البرلمان المصري شاهدة على مدى معارضته لحكم الرئيس المنتخب في حينه محمد مرسي. ومن المُتهمين أيضاً حسام مؤنس، الذي كان بمثابة أحد المتحدثين باسم "جبهة الإنقاذ"، التي دعت إلى تظاهرات 30 يونيو 2013، بالإضافة إلى الصحافي اليساري هشام فؤاد. وانضم للمعتقلين لاحقاً الناشط اليساري ضد الصهيونية رامي شعث، الذي لم تشفع علاقاته الواسعة ولا كونه نجل القيادي الفلسطيني الشهير بحركة "فتح" نبيل شعث ولا الوساطات الدولية، وأبرزها مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإفراج عنه.
لا يبدي النظام أي تعاطف أو مرونة تجاه الإسلاميين، خصوصاً قيادات وأعضاء الإخوان
وقبل ذلك، دفع النظام بمجموعة أخرى من أبرز الوجوه التي شاركت في 30 يونيو وأيدت الإطاحة بمرسي، إلى السجون وتم إخلاء سبيل بعض أفرادها بتدابير احترازية، ليظلوا في منازلهم رهن الإقامة الجبرية. ولا يبدي النظام أي تعاطف أو مرونة تجاه الإسلاميين، خصوصاً قيادات وأعضاء الإخوان، حاليين وسابقين. وما زالت الأحكام المشددة تصدر بالإعدام والسجن المؤبد بحقهم، فضلاً عن عدم السماح بخروجهم تحت أي بند أو شمولهم بالعفو أو إخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً منهم.
واستخدم النظام ضد هؤلاء جميعاً مجموعة من الأدوات الأخرى، كالإدراج على قوائم الإرهاب والمنع من التصرف في الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها في بعض الأحيان. وكان الهدف في بداية الأمر التنكيل فقط بجماعة الإخوان وعناصرها وامتداداتها الاجتماعية وصولاً إلى مصادرة أموال العشرات منهم، لكن تم استخدامها لاحقاً ضد النشطاء الحقوقيين البارزين ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات سياسية أخرى.
ويمتد التعامل الشرس مع المعارضين إلى التحكّم الكامل في وسائل الإعلام المحلية والتوسع في الرقابة على المطبوعات وتحريك قضايا عديدة وسريعة باستخدام القوانين الجديدة التي تقنن مراقبة الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تجريف أرضية المعارضة بالداخل، وتجهيل الرأي العام، ويعتبر حجب المواقع الإلكترونية أحد صور تلك الظاهرة.
واستغلّ النظام دعوات التظاهر التي وجهها المقاول الممثل محمد علي للادّعاء بتعرض مصر لحروب إعلامية ودعائية من الخارج، فزاد عدد المواقع الإلكترونية الإعلامية والصفحات المحجوبة إلى 549 خلال العام الماضي، بحسب إحصاء لمؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، في قفزة كبيرة، بعدما كان العدد 21 عام 2017 و74 عام 2018. وتم منع العديد من كتّاب الرأي من نشر مقالاتهم، كما أحكمت المخابرات سيطرتها على وسائل الإعلام من قنوات ومواقع إلكترونية وصحف ورقية عبر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مستوى الإدارة والمحتوى، بعد الاستحواذ على معظمها خلال السنوات الأربع الماضية.
لكن التحكم الكامل في تلك الوسائل لم ينجح في الدفاع عن سمعة مصر في الخارج، فقد شهدت الأشهر الستة الأخيرة تطورات أساءت إلى تاريخ مصر وسمعتها، بدءاً من صدور بيان جماعي من أعضاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطالب بفتح المجال العام وتحسين أوضاع الجمعيات الأهلية والحقوقية والإفراج عن المعتقلين، ثم تلويح عدة دول بمراجعة علاقاتها العسكرية والاقتصادية بمصر، وانتهاء بتحريك قضية رسمية ضد الضباط الأربعة المتهمين بقتل الشاب جوليو ريجيني في مصر منذ خمس سنوات.
وإزاء تلك الاتهامات لا تشعر السلطة بغضاضة وهي ترفض نصائح من بعض النواب والسياسيين من جماعات الضغط الأميركية والمتعاملين مع شركة "براونستين هيات فاربر شريك"، التي تستأجر مصر خدماتها، بضرورة الاستعداد لاتخاذ إجراءات تعكس رغبة النظام في تحسين أوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك بحث إمكانية الإفراج عن معتقلين ومحكومين من حاملي الجنسية الأميركية. وتتجه السلطة إلى عدم المسارعة في ذلك، واستغلال المعتقلين كورقة مساومة مستقبلية مع الإدارات الأميركية والأوروبية.