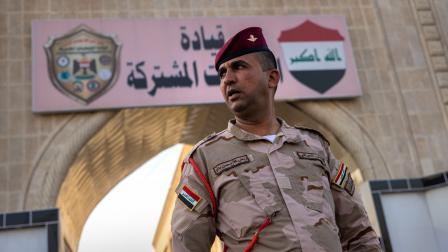النظام المصري درس سوابق تاريخية في طمس الحقائق
أُعلن عن إصدار شكل جديد للجنيه يحمل شعار الشرطة
سعى القضاء المصري لتثبيت نفي أمر مبارك في استخدام الأسلحة
عشر سنوات مرّت على اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، شبّ خلالها أطفال لم يشاركوا فيها، ولم يروا سقوط 1750 قتيلاً في الأحداث الرئيسية للثورة، وإصابة الآلاف برصاص شرطة وقنّاصي وبلطجية نظام حسني مبارك، وهم يهتفون للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية. الأطفال الذين باتوا مراهقين، لم يقرأوا عن تلك الأحداث في الكتب الدراسية، وتجاهلتها وسائل الإعلام، التي امتنعت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الاحتفاء والاحتفال بذكرى أكبر ثورة شعبية في تاريخ مصر. وبلغ التضييق على ذكرى الثورة مستويات مرتفعة، مع تخصيص مجلة صادرة عن دار نشر قومية عدد هذا الشهر عن السيسي و"ثورة" 30 يونيو/حزيران 2013، التي أجهضت مسار ثورة يناير. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل تمّ الإعلان عن إصدار شكل جديد للجنيه المصري، يحمل شعار الشرطة إحياء لعيدها، الموافق في 25 يناير أيضاً.
وسبق أن أنتج مبدعون مصريون وعرب أعمالاً أدبية عدة، مستوحاة من الأحداث الممهدة للثورة ووقائعها، وصولاً إلى تعثرها وفشل تحقيق أهدافها، وتشتت الثوار والمؤمنين بالثورة بين المنافي الاختيارية والإجبارية وبين البقاء في مصر تحت نير الخطر والخيبات. كما صدرت في العامين التاليين للثورة أعمال تأريخية مهمة، حاولت توثيق الواقع الذي عاشه المصريون، بالإضافة إلى إصدار العديد من الأواق البحثية والكتب الفكرية عن الثورة وآثارها في مختلف المجالات.
ما زال التاريخ الحقيقي لثورة يناير يعاني من الروايات المدسوسة
لكن على الرغم من كل تلك المساعي لكتابة تاريخ الثورة في مساحات متباينة ما بين الخاص والعام، والشخصي والجمعي، ما زال التاريخ الحقيقي لثورة يناير يعاني من ضعف التوثيق والروايات المدسوسة، لأغراض تتعلق بالصراع السياسي اللاحق على السلطة. وتستمر محاولات الطمس والإساءة، التي يمارسها النظام الحاكم منذ سبع سنوات بأذرعه القضائية والإعلامية، لتجد الأجيال القادمة نفسها أمام سردية مشوهة تقدم لها وكأنها واقع لا جدال فيه. في المقابل، يعجز أصحاب السردية الحقيقية عن التوثيق والنشر، لا سيما مع هجرة عدد كبير من الأكاديميين والناشطين المؤمنين بالثورة إلى خارج مصر، ووجود أولويات أخرى لدى الجهات الأكاديمية والإعلامية التي من الممكن أن تتبنى مثل هذه المشاريع التوثيقية الكبرى.
وبمقارنة الصراع الحالي حول سردية ثورة يناير بما حصل في ثورة 1919، يتبين أنه في الأخيرة حُسم الصراع مبكراً لمصلحة المنتمين للثورة، بعد وصول قياداتها للحكم والأغلبية البرلمانية، فضلاً عن سرعة توثيق أحداثها بواسطة مؤرخين ذوي كفاءة وشخصيات سياسية عاشت أحداثها وسجّلتها بحرية. ويُسجّل أيضاً محدودية القدرات الإعلامية والدعائية للأطراف المعادية لثورة 1919، مثل القصر السلطاني (مصر كانت سلطنة بين عامي 1914 و1922) والاحتلال البريطاني أمام المد الثوري الكبير، والالتفاف على قيادة استثنائية كالزعيم الراحل سعد زغلول.
وبعد إطاحة الملكية في ثورة 23 يوليو/تموز 1952، أدرك قائدها جمال عبد الناصر أهمية الإعلام والتعليم في حسم صراع السرديات التاريخية. وبتحكمه فيهما، تمكن بعد أزمة مارس/آذار 1954 السياسية، من حذف اسم أول رئيس للجمهورية محمد نجيب من كتب التاريخ المدرسي والمناهج الجامعية. وتجاهلت وسائل الإعلام وتلك الكتب أي ذكر للتيارات الوطنية المصرية في العهد الملكي، بعد حلّ جميع الأحزاب وجماعة الإخوان المسلمين. بالتالي نشأت أجيال لا تعلم شيئاً عما حدث من صراع على السلطة بعد إطاحة الملكية، إلا بعد نشر كتب حركة صحوة الإسلام السياسي في السبعينيات والثمانينيات، وصدور مذكرات عدد من القيادات القديمة للحركة، ومنهم محمد نجيب نفسه بعد تراجع المد الناصري.
ويبدو أن النظام الحالي درس تلك السوابق التاريخية جيداً، مضيفاً إلى استخدام الإعلام والتعليم استغلال القضاء، الذي أدى دوراً كبيراً في اعتماد سرديات مغلوطة وكاذبة ومنافية لأبسط المعلومات المسجلة التي عاشها ملايين المصريين. وجارت المحاكم الأكاذيب بالاعتماد على تحريات الأجهزة العابرة لنظامي مبارك والسيسي وشهادات قيادات الثورة المضادة، في صورة "وثائق قضائية" تُنشر في وسائل الإعلام، ثم إدراجها لاحقاً في الكتب الدراسية.
تعاون القضاء مع المنظومة الحالية لإقرار أحكام قضائية مناهضة للثوار
في السياق، انتهت محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين ببراءتهم جميعاً. مع العلم أن النيابة العامة اتهمتهم بواسطة أدلة قديمة ومعيبة وغير مكتملة بـ"الاشتراك بالتحريض والمساعدة مع بعض ضباط أفراد الشرطة، في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليهم والشروع في قتل آخرين". ويعني هذا غياب الفاعل الأصلي وخلق حالة من شيوع الاتهام وبطلان الاستناد إليه.
ولم تكن المشكلة الوحيدة في القضية عدم تحديد من أطلق الرصاص على المتظاهرين، وهي ظاهرة تكررت في جميع قضايا قتل الثوار مما أدى إلى براءة جميع الضباط، لكن المشكلة الأكبر كانت في استغلال المحكمة الشهادات التي استمعت إليها من عناصر نظام مبارك، لصياغة سردية جديدة للأحداث. وتصوّر هذه السردية الثورة كعملية استخباراتية شاركت فيها دول كثيرة ذات مصالح متضاربة، لم تجتمع إلا على إسقاط مبارك، وأهملت جميع أقوال الثوار. وأخذت المحكمة بأقوال نائب رئيس الجمهورية، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق عمر سليمان، الذي حضر اجتماعاً في 20 يناير/كانون الثاني 2011 في القرية الذكية، بناء على أمر مبارك، برئاسة رئيس مجلس الوزراء آنذاك أحمد نظيف، وبحضور وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، وحبيب العادلي، ووزير الإعلام أنس الفقي، ووزير الاتصالات طارق كامل. وادّعت المحكمة أن هذا الاجتماع لم يترتب عليه أي اتفاق على الإضرار بالمتظاهرين. مع العلم أنه ثبت وجود أدلة على اتخاذ قرارات قطع الاتصالات عن مناطق متفرقة من البلاد في الاجتماع، فضلاً عن تفويض وزير الداخلية في حفظ النظام بالطريقة التي يراها مناسبة.
وأخذت المحكمة بادعاءات سليمان بأن جهاز المخابرات رصد يوم 27 يناير 2011، اتصالات وتحركات لعناصر أجنبية مسلحة دخلت البلاد، وشوهد بعضهم بميدان التحرير، واقتحم بعضهم الآخر السجون. وادّعى أيضاً أن الاشتباكات بدأت بين المتظاهرين وبين الشرطة بمهاجمة عناصر إجرامية أقسام الشرطة وإشعال الحرائق فيها، ما أدى إلى إنهاك الأمن المركزي.
وجاء في حيثيات شهادة سليمان أن مبارك أمر لدى علمه بوقوع وفيات ومصابين، بتشكيل لجان تقصي الحقائق، وأنه لا يستطيع الجزم بمسؤولية المتهم عن الوفيات أو الإصابات التي حدثت بالمتظاهرين، إذ استجاب لكل ما طلب منه لحماية البلاد. كما تجاوب فور مطالبته بتنازلات سياسية بأن تخلى عن منصب رئاسة الجمهورية.
كما أخذت المحكمة بشهادة طنطاوي، بأن مبارك أمر في 28 يناير 2011 بنزول القوات المسلحة من دون استخدام سلاح لتأمين الأهداف الحيوية ومساعدة الشرطة. ونفى في شهادته أن يكون مبارك قد وجّه وزير الداخلية باستعمال الشرطة للقوة أو الأسلحة النارية ضد المتظاهرين، أو أن يكون قد أصدر أمراً بإطلاق النار عليهم. وشدّد على أن مبارك حثّ خلال اجتماع عقد في اليوم التالي بغرفة عمليات القوات المسلحة، على عدم استخدام العنف من جانب القوات المسلحة.
وفي مقابل الإهمال الكامل لوقائع القتل وبحث المسؤولية الجنائية، أخذت المحكمة بنفي وزير الداخلية الأسبق اللواء منصور العيسوي لأمر مبارك باستخدام الأسلحة، ووزير الداخلية الأسبق، اللواء محمود وجدي، ورئيس أركان حرب الجيش الأسبق سامي عنان، ووكيل جهاز مباحث أمن الدولة إبان الأحداث اللواء خالد عبد الوهاب محمد. كما أخذت بنفي قائد الشرطة العسكرية آنذاك اللواء أركان حرب حمدي بدين، وقائد المنطقة العسكرية إبان الأحداث اللواء أركان حرب حسن الرويني، ومدير أمن أسيوط وقتها اللواء أحمد محمد جمال الدين، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق اللواء محمد فريد التهامي.
بالتالي سمحت المحكمة ولأمثالهم بكتابة السردية الرسمية للثورة، محمّلين العناصر الخارجية مسؤولية قتل المتظاهرين والشرطة على حد سواء، ومحمّلين الإخوان تهمة التخابر مع حركة "حماس" وتركيا وإيران والولايات المتحدة وحزب الله وقطر وغيرها من الجهات. وبناء على شهاداتهم التخيلية قامت قضيتان أخريان، هما "التخابر مع حماس" و"اقتحام السجون"، اللتان خُصصتا للتنكيل بجماعة الإخوان المسلمين بعد إطاحة حكمها.
ولم يكن غريباً أن يستغل النظام الحاكم ذلك لإهانة الرئيس الراحل المعزول محمد مرسي، وربط اسمه بعد وفاته في المحكمة بكلمتي "الجاسوس" و"القاتل"، نظراً لاتهامه في القضيتين السابق ذكرهما. مع العلم أن مرسي كان وقت الثورة أحد ممثلي الإخوان في الاجتماعات مع عمر سليمان نفسه.
واللافت أن الأقوال المصرية التي مُنحت مساحات إعلامية واسعة في عهد السيسي، تغوّلت لتتهم كذباً دولاً وشخصيات بعينها بدعم الثورة. ومن بين تلك الأكاذيب ما أشيع عن سعي وزيرة الخارجية الأميركية السابقة والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون لإطاحة مبارك، وأن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما كان مناصراً للإخوان. واتضح كل شيء في مذكرات أوباما الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي كشف فيها عن موقف كلينتون المؤيد لبقاء مبارك إلى حد تعنيف أوباما لها. وتحفظ الرئيس الأسبق على التعاون مع الإخوان، متردداً في إعلان تأييده للثورة ومطالبته مبارك بالتنحي، إلى ما بعد تأكده من عدم الاستجابة لأي من نصائحه، حول تأمين الانتقال الهادئ وغير المتعجل للسلطة برعاية مبارك نفسه، مع اتخاذه إجراءات ديمقراطية حقيقية.
امتدت الأكاذيب إلى مرحلة ما بعد الثورة، خصوصاً انتخابات الرئاسة 2012
وامتدت الأكاذيب إلى مرحلة ما بعد الثورة، خصوصاً انتخابات الرئاسة 2012، والتي نجت من تحويل الشائعات الكاذبة بشأن تزويرها إلى أحكام قضائية، بفضل رغبة السيسي في ضمان عدم المساس بما ترتب على شرعيتها، لقطع طريق الطعن على المرشح الخاسر بها أحمد شفيق. وقد أُغلق هذا الملف بحكم صادر من محكمة جنايات الجيزة في إبريل/نيسان 2018 برفض تحريك الاتهام ضد مرسي بالتزوير، وتأييد قرار قاضي التحقيق بحفظ التحقيقات في هذه القضية في أغسطس/آب 2017. وبالتالي مُنع محامي شفيق، من الطعن على حفظ التحقيقات، لأن مرسي يُعدّ موظفاً عاماً بصفته رئيساً للجمهورية، ومعه المستشارون أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية ومسؤولو المطابع الأميرية، وهم جميعاً موظفون عموميون.
وفي الفترة ما بعد انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، وُجّهت اتهامات لمرسي والإخوان بالتخابر مع أطراف مختلفة على رأسها دولة قطر، إلى حد صدور حكم ضد مرسي بالسجن المؤبد، بسبب تهمتين في قضية "التخابر مع قطر". والتهمتان هما: تشكيل جماعة إرهابية بالمخالفة للدستور والقانون، واختلاس أوراق حكومية على قدر عالٍ من السرية وتمس الأمن القومي. مع ذلك، فشلت المحكمة في إثبات علاقة واقعية بين مرسي وموظفي مكتبه من جهة، وبين متهمين آخرين بمحاولة بيع الوثائق لقناة "الجزيرة" من جهة أخرى.
وكان هذا الحكم الذي صدر في سبتمبر/أيلول 2017، بعد ثلاثة أشهر من الحصار الرباعي على قطر، داعماً لتحركات الأجهزة المصرية الراغبة في نسج سردية قانونية موثقة، يُمكن من خلالها اتهام حكومة قطر بالضلوع في تمويل العمليات الإرهابية على أراضيها. وهو ما ثبت ضعف الأدلة الواردة في تلك القضية، وغياب القرائن على وجود صلة بين الوقائع الفعلية التي حدثت وبين ادّعاء السلطات المصرية حول حصول عمليات تمويل واسعة النطاق بين قطر وتركيا ومصر، لخلايا غير مركزية تابعة لجماعة "الإخوان"، في 9 محافظات، أبرزها القاهرة والجيزة والإسكندرية.