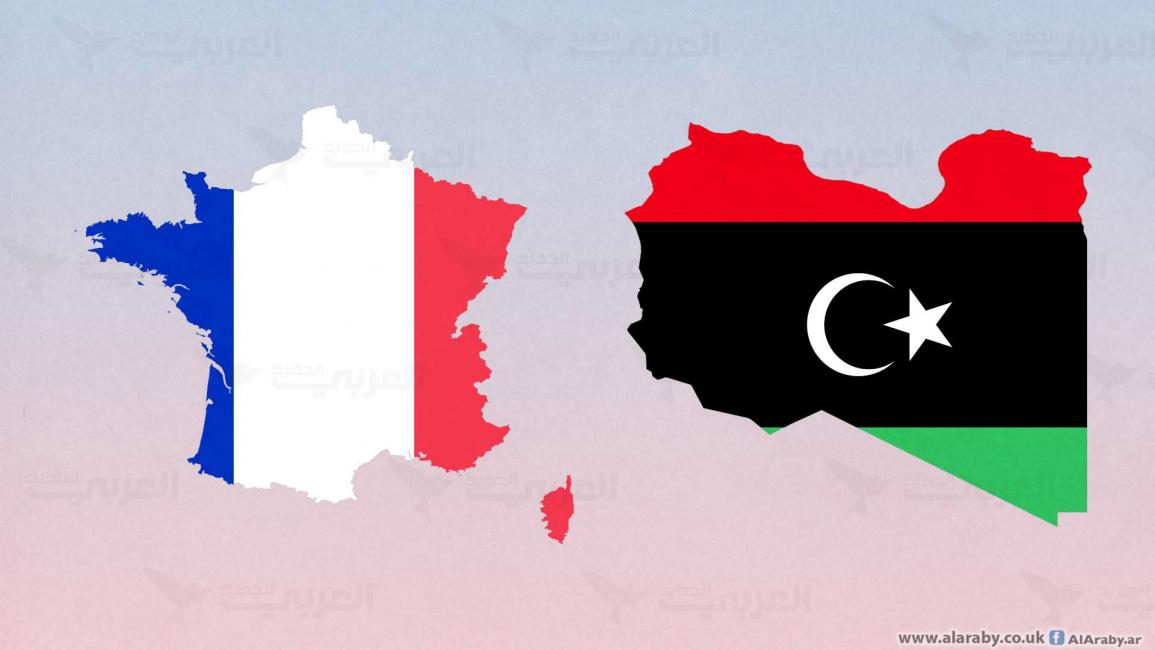09 نوفمبر 2024
لسياسة فرنسية في ليبيا أقل غموضاً
في وصفه السياسة الفرنسية تجاه ليبيا، كتب موقع دويتشه فيله الألمانية إنها تقوم على دعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في العلن، بينما تدعم الجنرال خليفة حفتر في السر. وقبل أيام، تحدث وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، مع السراج، بخصوص وقف إطلاق النار، والعودة إلى العملية السياسية. فيما كانت الدوائر الفرنسية، على مدى الأسابيع الماضية، تبدي قلقها من استعادة حكومة الوفاق المناطق التي سيطر عليها حفتر في حملته العسكرية منذ إبريل/ نيسان من العام الماضي.
يصعب القول بوجود سياسة فرنسية متماسكة ومقنعة إزاء ليبيا، فقد انجرفت باريس إلى تأييد حفتر، بدعوى أنه رجل "قوي"، مع غض النظر عن سعيه إلى إقامة حكم عسكري، لا مدني، فيما كان ينقضّ على تفاهمات مؤتمري برلين وموسكو، وفيما كان وفد الأمم المتحدة برئاسة الأمين العام أنطونيو غوتيريش يزور ليبيا، وبينما كان المبعوث الأممي، غسان سلامة، يستعد لمغادرة موقعه على وقع الصراع الإقليمي والدولي في هذا البلد. وبينما تتحدّث باريس عن قلقها على الوضع الأمني الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي، فقد ظلت عاجزةً أو غير راغبة بالتفاهم مع دولة أوروبية معنية بالشأن الليبي وعضو في حلف الأطلسي، وهي إيطاليا، وظل الصراع على النفوذ مع الشقيقة الأوروبية هو ما يحكم سياستها، ومنه الصراع على عقود النفط بين شركتين كبيرتين للبلدين. وإذ تُبدي باريس قلقها من الاتفاقيات الموقعة بين طرابلس وأنقرة، فإنها تبدي أقل القلق من النفوذ الروسي الذي يتخذ من قاعدة الجفرة وسط البلاد مركزا لتجميع مرتزقة فاغنر
وللمقاتلات الحربية من طراز سوخوي 29. وبينما يتحدث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن خشيته المتزايدة من سورنة الصراع على ليبيا، فإنه لا شيء يدل في سلوك باريس على تحبيذ الدفع نحو حل سياسي يقوم على الاتفاقيات والتفاهمات السابقة، ويضيف إليها، بعدما تبيّن للقاصي والداني أن طموحات حفتر الشخصية هي التي زجّت بلد عمر المختار في أتون الحرب التي خلّفت مقابر جماعية وانتهاكات واسعة لحقوق الانسان. الحاجة ماسّة للعودة إلى الحلول السياسية، وأفضل تسهيل لذلك هو الجمع بين الحياد الإيجابي وتعزيز الاعتراف بالحكومة الشرعية، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع وإطالة أمد النزاع بما يهدّد بمزيد من موجات الهجرة من هذا البلد، ومنح مزيد من الذرائع لليمين الأوروبي المتطرّف للسيطرة على الفضاءين، الاجتماعي والسياسي.
ويسترعي الانتباه أن باريس لا تجد في الاتحاد الأوروبي من يدعم سياستها الانتقائية والمزدوجة في ليبيا، وقد بذلت ألمانيا، على وجه الخصوص، جهوداً لتطويق النزاع الليبي، لكن باريس لم تجد ما تفعله سوى دعم من انقضّ على مخرجات مؤتمر برلين في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، وهو ما باعد بين فرنسا والمجموعة الأوروبية. وحيث تزداد الدعوات الفرنسية، في هذه الآونة، إلى غطاء أوروبي لها، إذ تبدو فرنسا في موقف من يغرّد خارج السرب الأوروبي. ولئن كان من الصحيح أنه لا إجماع أوروبيا حول موقف موحد، إلا أنه من الصحيح أيضا أن موقف الحياد والسعي إلى إطفاء الحريق الليبي هو الغالب على المواقف، علاوة على موقف الدولة الأطلسية الكبرى، الولايات المتحدة التي لا تحبّذ تغذية النزاع. وفي وسع أربع دول أوروبية، ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، بلورة موقفٍ أكثر إتزانا يدفع نحو وقف إطلاق النار ورعاية حوار ليبي بين الفرقاء الأساسيين، وبممثلين عن مجلس النواب في كل من طرابلس وطبرق، وبمشاركة الأمم المتحدة. والمضي في مراقبة حظر وصول الأسلحة براً وبحراً وجواً ضمن ما سميت عملية إيريني الأوروبية، ولا بأس بحلقة ثانية من مؤتمر برلين وبحضور أطراف إقليمية ودولية معنية بصورة مباشرة بالملف الليبي، وذلك بعد ما تبين أن تحبيذ الحلول العسكرية لن يوصل إلى شيء، سوى التدافع على النفوذ، وبناء واقع تقسيمي على الأرض، على حساب أمن الليبيين وكرامتهم ومستقبلهم.
وبالنظر إلى المعادلات الراهنة للصراع على الأرض، وما تبدو عليه المواجهة في مدينة سرت من استعصاء، في ضوء التحشيد المتزايد والمتبادل بين الطرفين، والخشية المتنامية من أن يستخدم الطرفان في المعركة، إن وقعت، كل ما يحوزان من أسلحة، وأن تشارك قوى غير ليبية في هذه المواجهة بأسلحة فتاكة لم تستخدم من قبل، فإن الوصول إلى هذه النقطة الحرجة في
الموازين العسكرية والسياسية يُملي اهتبال الأطراف المعنية بالأمن والسلام في ليبيا الفرصة، بأن تحشد جهودها من أجل وضع المتنازعين أمام خيار التفاوض، باعتباره الوحيد الذي يحقق بعض طموحات الفريقين ومطالبهما. وذلك أفضل من أية حلول أخرى، تطيل أمد النزاع، وتضفي عليه مزيدا من التعقيد، وتستدرج لاعبين جددا، بما يجعل من الوطن الليبي ساحةً للصراع والنفوذ إلى ما لا نهاية، ويغلق مستقبلاً سبل الحل المتاحة في هذا الظرف، والتي قد لا تتكرّر لاحقاً.
وإذا كانت فرنسا معنيةً حقا باستباب الأمن والاستقرار، وتخشى من ارتدادات النزاع علي دول الساحل الإفريقية (تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا) بتسرّب متطرفين أو إرهابيين إليها، فإن بناء الثقة الفرنسية مع جميع الأطراف الليبية، وإجراء تفاهماتٍ أمنيةٍ مُلزمة معها، يستدعي أن تتوفر فرنسا على رؤيةٍ للسلام في هذا البلد الممزّق، وأن تتشارك هذه الرؤية مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بدلاً من المضي في سياسة ملتوية و"غامضة"، تشجع عملياً المغامرات العسكرية، وتغلق الباب أمام الحلول التفاوضية، وتدفع نحو مزيد من التدخلات الخارجية. وهو ما حدث خلال العامين الماضيين، وما زال يحدث في أيام الناس هذه، حيث بات استخدام لغة سياسية مزدوجة شائعاً، وربما اقتداءً بالأسلوب الفرنسي في التعامل مع هذه الأزمة التي طال أمدها. ومن الأفضل، وسط أجواء التشاؤم السائدة، أن ينطلق حوار فرنسي تركي مباشر وصريح، عوضاً عن حرب التصريحات بين الجانبين، بما يُمكّن من تحديد المصالح المشروعة للطرفين، وأوجه التعاون بينهما، وفي إطار ثابت من احترام حق الليبيين تقرير مصير بلدهم.
ويسترعي الانتباه أن باريس لا تجد في الاتحاد الأوروبي من يدعم سياستها الانتقائية والمزدوجة في ليبيا، وقد بذلت ألمانيا، على وجه الخصوص، جهوداً لتطويق النزاع الليبي، لكن باريس لم تجد ما تفعله سوى دعم من انقضّ على مخرجات مؤتمر برلين في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، وهو ما باعد بين فرنسا والمجموعة الأوروبية. وحيث تزداد الدعوات الفرنسية، في هذه الآونة، إلى غطاء أوروبي لها، إذ تبدو فرنسا في موقف من يغرّد خارج السرب الأوروبي. ولئن كان من الصحيح أنه لا إجماع أوروبيا حول موقف موحد، إلا أنه من الصحيح أيضا أن موقف الحياد والسعي إلى إطفاء الحريق الليبي هو الغالب على المواقف، علاوة على موقف الدولة الأطلسية الكبرى، الولايات المتحدة التي لا تحبّذ تغذية النزاع. وفي وسع أربع دول أوروبية، ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، بلورة موقفٍ أكثر إتزانا يدفع نحو وقف إطلاق النار ورعاية حوار ليبي بين الفرقاء الأساسيين، وبممثلين عن مجلس النواب في كل من طرابلس وطبرق، وبمشاركة الأمم المتحدة. والمضي في مراقبة حظر وصول الأسلحة براً وبحراً وجواً ضمن ما سميت عملية إيريني الأوروبية، ولا بأس بحلقة ثانية من مؤتمر برلين وبحضور أطراف إقليمية ودولية معنية بصورة مباشرة بالملف الليبي، وذلك بعد ما تبين أن تحبيذ الحلول العسكرية لن يوصل إلى شيء، سوى التدافع على النفوذ، وبناء واقع تقسيمي على الأرض، على حساب أمن الليبيين وكرامتهم ومستقبلهم.
وبالنظر إلى المعادلات الراهنة للصراع على الأرض، وما تبدو عليه المواجهة في مدينة سرت من استعصاء، في ضوء التحشيد المتزايد والمتبادل بين الطرفين، والخشية المتنامية من أن يستخدم الطرفان في المعركة، إن وقعت، كل ما يحوزان من أسلحة، وأن تشارك قوى غير ليبية في هذه المواجهة بأسلحة فتاكة لم تستخدم من قبل، فإن الوصول إلى هذه النقطة الحرجة في
وإذا كانت فرنسا معنيةً حقا باستباب الأمن والاستقرار، وتخشى من ارتدادات النزاع علي دول الساحل الإفريقية (تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا) بتسرّب متطرفين أو إرهابيين إليها، فإن بناء الثقة الفرنسية مع جميع الأطراف الليبية، وإجراء تفاهماتٍ أمنيةٍ مُلزمة معها، يستدعي أن تتوفر فرنسا على رؤيةٍ للسلام في هذا البلد الممزّق، وأن تتشارك هذه الرؤية مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بدلاً من المضي في سياسة ملتوية و"غامضة"، تشجع عملياً المغامرات العسكرية، وتغلق الباب أمام الحلول التفاوضية، وتدفع نحو مزيد من التدخلات الخارجية. وهو ما حدث خلال العامين الماضيين، وما زال يحدث في أيام الناس هذه، حيث بات استخدام لغة سياسية مزدوجة شائعاً، وربما اقتداءً بالأسلوب الفرنسي في التعامل مع هذه الأزمة التي طال أمدها. ومن الأفضل، وسط أجواء التشاؤم السائدة، أن ينطلق حوار فرنسي تركي مباشر وصريح، عوضاً عن حرب التصريحات بين الجانبين، بما يُمكّن من تحديد المصالح المشروعة للطرفين، وأوجه التعاون بينهما، وفي إطار ثابت من احترام حق الليبيين تقرير مصير بلدهم.