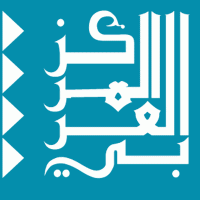09 يناير 2025
انتفاضة لبنان: أسبابها وتداعياتها
حشد من الشباب اللبناني يتظاهر في بيروت (21/10/2019/فرانس برس)
يشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 تظاهرات شعبية غير مسبوقة، تضغط باتجاه إسقاط المنظومة السياسية التي حكمت البلد منذ انتهاء الحرب الأهلية في بداية تسعينيات القرن الماضي. وتتميز هذه التظاهرات بأنها شاملة، عابرة للطوائف والمناطق، ومتفاوتة في أعمار المشاركين فيها والطبقات الاجتماعية التي ينحدرون منها. وكلها تُجمع، من حيث المزاج المنتشر في التظاهرات على إسقاط الطبقة السياسية الحاكمة، وتجاوز نظام المحاصصة الطائفية وتقسيم المناصب والمنافع العامة المعمول به منذ استقلال لبنان وإعلان الميثاق الوطني عام 1943. ولكن هذه الانتفاضة التي كسرت حاجز الزبائنية والطائفية السياسية والخوف لا يزال أمامها تحدّي بلورة مطالبها بشكل أوضح، وإنتاج قيادات قادرة على ترجمة ضغط الشارع إلى مكتسبات سياسية حقيقية. وهذا لا يحدث بين ليلة وضحاها، والحركة أكثر عفوية من أن تنتخب مندوبين عنها، وبقي أن يفرز الحراك، إذا أسعفه الوقت، ناطقين باسمه على الأقل.
أسباب الانتفاضة
تعدّ الرسوم التي اقترحتها الحكومة اللبنانية على الخدمة الصوتية لتطبيق "واتساب" للهواتف الذكية المحرّك السببي لهذه التظاهرات، أو القطرة التي أفاضت كأس الاحتقان الشعبي، فقوة ردة فعل الجمهور اللبناني، وسعة انتشار الاحتجاجات التي أربكت الطبقة السياسية، تشيران إلى كمٍّ كبير من المشكلات البنيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة أدّى، في نهاية المطاف، إلى دفع اللبنانيين إلى تجاوز انقساماتهم الداخلية والطائفية، ورواسب الحرب الأهلية، والخروج إلى الشارع على امتداد لبنان، للمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة. ويمكن تحديد أربعة عوامل رئيسة مهدت لهذه الاحتجاجات.
1. سقوط نظام "الطائف"
نتج النظام السياسي اللبناني القائم من تسوياتٍ إقليمية ودولية، كان هدفها الرئيس إنهاء الحرب الأهلية التي امتدت خمسة عشر عامًا؛ أي إن هذا النظام لم يكن نتاج تسويات داخلية، أو اتفاق اللبنانيين عليه، بل كان مفروضًا عليهم من الخارج عبر وصاية النظام السوري، وبرعاية أميركية - سعودية عُبِّر عنها في "اتفاق الطائف". ومثّل اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، في فبراير/ شباط 2005، ضربة كبيرة لهذا النظام. ذلك أنه أدّى إلى نهاية نظام الوصاية السورية المباشرة، واستبدالها بانقسام سياسي بين تحالف "8 آذار" المدعوم من طهران ودمشق وتحالف "14 آذار" المدعوم من واشنطن والرياض، قبل أن يحسم حزب الله هذه المواجهة السياسية عسكريًا في "اجتياح" بيروت في أيار/ مايو 2008. أمّا الضربة الثانية التي تلقّاها هذا النظام، وأدت إلى ترنّحه، فقد تمثلت بالثورة التي اندلعت في سورية عام 2011 وكان لها تداعيات كبيرة على لبنان، بحيث انقسم اللبنانيون بين مؤيد للنظام ومؤيد للمعارضة، خصوصا مع تدخّل حزب الله مباشرة في الصراع السوري.
نتيجة ذلك، دخل لبنان حالة من التوتر السياسي والأمني استمرت في الفترة 2011 - 2013، قبل أن تتدخل القوى الخارجية لتفرض الاستقرار فيه، خوفًا من أيّ تداعيات سلبية على دور لبنان الذي يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين وقواتٍ دوليةً في جنوبه، فضلًا عن الحاجة إلى إدارة النزاع البحري وحلّه بين لبنان وإسرائيل حول استغلال حقول الغاز المكتشف حديثًا حينها في شرق المتوسط. تبلورت هذه المظلة الدولية عام 2014 برعاية أميركية – سعودية – إيرانية، أسفرت عن إسناد رئاسة الحكومة إلى شخصية محايدة نسبيًا هي تمام سلام. وفي عام 2016، تجدّدت التسوية بتوافق أميركي - إيراني لم ترض عنه السعودية، وأدى إلى إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، وانتخاب الجنرال ميشال عون للرئاسة في مقابل تولّي سعد الحريري رئاسة الحكومة. ولكن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات عليها واستهداف حليفها حزب الله، والتصعيد السعودي ضد إيران في اليمن، وغيرها، في بداية مرحلة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ذلك كله وضع ضغوطًا كبيرة على لبنان، وانعكس على النظام السياسي والاقتصادي، على نحوٍ أدّى إلى تفجر الاحتجاجات.
2. أفول الثنائية السنية - الشيعية
حوّلت المظلة الدولية التي نشأت منذ عام 2014 المواجهة بين الثنائية السنية - الشيعية إلى ائتلاف بينهما، وربما تحالف مبطن، وذلك بعد أن فقد سعد الحريري كل مقومات المواجهة مع حزب الله. ومنذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحكم في السعودية، وخصوصًا مع تولي ابنه محمد ولاية العهد، انسحبت السعودية ماليًا وسياسيًا من لبنان، على وقع تراجع نفوذها الإقليمي. فوق ذلك، قطعت السعودية كل مصادر التمويل عن سعد الحريري، وجمّدت استثماراته، ووصل الأمر إلى حد احتجازه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وإجباره على تقديم استقالته من رئاسة الحكومة. أدى ذلك كله إلى إضعافه، الأمر الذي بدا واضحًا في نتائج الانتخابات البرلمانية العام الماضي، حين خسر الحريري أغلبيته البرلمانية، وفاز تحالف خصومه من حزب الله والتيار الوطني بأغلبية المقاعد في مجلس النواب. واهتزت مواقع الحريري أكثر على وقع فضائح طاولته، وجاءت في وقتٍ كان مئاتٌ من موظفي الشركات والمؤسسات التي يمتلكها ينتظرون رواتبهم غير المدفوعة منذ سنين. وبناء عليه، لم يكن مفاجئًا أن تكون المناطق التقليدية التي كان ولاؤها تاريخيًا لآل الحريري أول من خرج للتظاهر مطالبةً بإسقاط الحكومة التي يرأسها. فلا نجح الحريري في الحفاظ على مواقع السنّة في الحكم، بل أضعف منصب رئيس الحكومة الذي تحوّل إلى أقلية معارضة داخل حكومته، ولا نجح في تقديم الخدمات، ولا استقال وترك حزب الله وعون يتحملان المسؤولية بدلًا من أن يشكّل واجهة لهما.
بالمثل، تعرّضت مكانة أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، إلى نكساتٍ عديدة، منذ قرّر الحزب القبض على السلطة في لبنان عام 2005 في محاولة لملء فراغ انسحاب النظام السوري. ولكن التداعيات الأكبر على مكانة الحزب بدأت منذ قرّر التدخل عسكريًا في الحرب السورية، وهو الأمر الذي تسبّب في أضرار فادحة على قاعدة الحزب الشعبية، ليس على المستوى المالي فقط بل نتيجة عودة جثث مقاتلي حزب الله من سورية من دون تفسير مقنع عن أسباب تضحياتهم. وفي بعض الأحيان، كان يتم تسليم الجثث من دون جنازة. ومنذ الحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز/ يوليو 2006، يعيش أمين عام حزب الله بعيدًا عن أعين الناس، ويخاطب جمهوره عبر شاشات كبيرة، على نحوٍ جعل تفاعله مع القاعدة الشعبية محدودًا. أكثر من ذلك، أدّت الضغوط التي تتعرّض لها إيران، وانغماسها في عديد من مشكلات الإقليم من سورية إلى العراق واليمن، إلى تكريس موارد وجهود أقلّ لحلفائها في لبنان. كما أنّ انشغال زعيم حزب الله، بمناسبةٍ وبغير مناسبة، في الدفاع عن سياسات إيران، في وقت تعاني فيه قاعدته الشعبية، أثّر أيضًا في شعبيته. وفي الفترة الأخيرة، بات الحزب يطلب تبرعاتٍ ماليةً من مناصريه، بدلًا من أن يستمر في تقديم خدماته الاجتماعية المجانية التي طبعت عمله في العقود الأخيرة.
لقد خدمت المواجهة السياسية بين الحريري ونصر الله منذ عام 2005 الطرفين لجهة أنها ساعدتهما في تحشيد المناصرين عبر شدّ العصب الطائفي، كلّ في طائفته، وضمان الدعم الإقليمي ضمن أجندةٍ خارجية معينة. ولكن مع انتهاء هذه المواجهة عام 2014، ثم دخولهما في ائتلاف حكومي منذ عام 2016، تبيّن لجمهور الطرفين عقم المعارك السياسية التي عطّلت البلد سنواتٍ من دون تقديم أيّ حلول لتسهيل حياة المواطنين، أو تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
3. أزمات نظام المحاصصة الطائفية
تمثل أحد أهم عناوين احتجاجات لبنان في تعرية الفشل البنيوي لنظام المحاصصة الطائفية باعتباره نظامًا ريعيًا يتم فيه اقتسام السلطة والثروات، والاستئثار بها وفق معايير لا تعتمد الكفاءة والأهلية من بينها. ومنذ عام 2005، يعيش لبنان حالةً من الشلل السياسي المستمر نتيجة هذا الصراع على اقتسام الموارد والسلطة، ما حال دون إقرار أيّ إصلاحات مهمة. وأغلقت الاضطرابات الإقليمية الباب أيضًا أمام مبادلات لبنان التجارية مع سورية والعراق والأردن وبلدان الخليج، ما أدّى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد وانكشاف المشكلات البنيوية في الاقتصاد اللبناني وسياساته المالية. ويتجاوز الدَيْن العام في لبنان حاليًا حاجز 85 مليار دولار؛ أي ما يمثّل 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ومعظم هذا الدين مستحقٌ للمصارف اللبنانية التي لديها نفوذ واسع النطاق على الطبقة السياسية. ولمّا كانت الحكومة تعكس ميزان القوى في مجلس النواب، أصبح من المستحيل مساءلتها أو محاسبتها، في حين يخضع القضاء لسطوة الطبقة السياسية الحاكمة، ولا يمكنه المساعدة في تصحيح المسار ومقاضاة عمليات الفساد داخل أجهزة الدولة وخارجها. وما يزيد الوضع سوءًا هو عجز الحكومة عن توفير الخدمات الرئيسة، مثل الكهرباء والمياه النظيفة ومنع التلوث ووسائل النقل العام وجمع القمامة وفرزها، وغيرها من المطالب التي عجز نظام المحاصصة الطائفية عن توفيرها، ما يفسّر هذا الخطاب العابر للطوائف بين المتظاهرين.
4. غياب العدالة في توزيع الثروات
يعدّ التفاوت الطبقي أحد أبرز أسباب الانتفاضة اللبنانية، وقد عبّرت التظاهرات عن ذلك بوضوح، ولا سيما التي خرجت خصوصا في الأطراف شمالًا وجنوبًا وفي سهل البقاع. ولم يكن يومًا التفاوت الطبقي بين أقليةٍ تُحكم سيطرتها على الثروات وأغلبيةٍ تعيش على هامش خط الفقر واضحًا في لبنان كما هو اليوم. وفي دراسةٍ لمنظمة أوكسفام، صدرت مطلع العام الجاري تبين أن سبعة أثرياء لبنانيين يملكون ثروة شخصية إجمالية تبلغ 13.3 مليار دولار؛ أي عشرة أضعاف ما يملكه نصف الشعب اللبناني. كما يملك 1% من اللبنانيين ثروة تزيد عمّا يملكه 58% من اللبنانيين. الدعوة إلى تحقيق حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية كانت الخطاب الجامع للمتظاهرين في شرحهم مكامن الفساد في النظام اللبناني. وتمثلت رسالة المتظاهرين الرئيسة في رفض فرض ضرائب جديدة لسدّ عجز الخزينة اللبنانية، في حين تزداد ثروات الطبقة الحاكمة، وقد برز ذلك في رفع شعار "استعادة الأموال المنهوبة".
إضافة إلى ذلك، برز دور المعضلة التي بات يواجهها القطاع العام الذي تجاوز حجمه قدرة الدولة على تمويله، بسبب التوظيف الفائض عن الحاجة على أساس المحاصصة الطائفية، ما جعله عبئًا على الاقتصاد، مع فاعلية إنتاجيةٍ منخفضةٍ بسبب ضعف الكفاءة وقلة الأجور التي تشجع على الفساد والرشوة. وسيبقى القطاع العام، على الأرجح، يعاني هذه المشكلات لعدم القدرة على اتخاذ قرار بإجراء إصلاحات بنيوية فيه، بسبب خوف الطبقة السياسية الحاكمة من خسارة النظام الريعي الذي حوّل الدولة إلى غنيمةٍ يقتسمها قادة الطوائف، عبر ممثليهم في الوزارات، ليقوموا بدورهم بتوزيع الريع (بما فيه الوظائف) على طوائفهم، بما يكرّس زعامتها التقليدية، لا سيما في ظل غياب وظائف بديلة، وتراجع الدعم المالي الإقليمي الذي موّل الحياة السياسية في لبنان عقودًا، مع تراجع أهميته، حتى بوصفه ساحة صراع.
خاتمة
يواجه لبنان انتفاضة غير مسبوقة في تاريخه الحديث، عنوانها الرئيس إسقاط الطبقة السياسية الحاكمة، وتقودها، خلاف العادة، الطبقات المتوسطة والفقيرة، ويحاول المجتمع المدني في المدن الكبرى التأقلم معها ومجاراة مطالبها. كما توحي مناطق انتشارها وتوزّعها في طرابلس وعكار وصور وزحلة وعاليه بانتهاء المركزية التاريخية التي طالما مارستها بيروت في تحديد إيقاع الحياة السياسية اللبنانية. الأهم من ذلك كله أنّ وعيًا سياسيًا جديدًا يتشكل في لبنان، ويؤسس لهوية وطنية جديدة، وتطلّعًا إلى نظام جديد يطوي صفحة الحرب الأهلية و"اتفاق الطائف" الذي أنتج نظامًا سياسيًا لم يعد قابلًا للحياة، فهل تنجح الانتفاضة في تحقيق هذه النقلة في حياة لبنان السياسية، في غياب قيادة واضحة، وآليات لتنفيذ المطالب، وفي ظل مقاومة شرسة للتغيير تبديها الطبقة السياسية التي تحكم البلد منذ عقود؟ المهمات صعبة، والإجابة عن هذه الأسئلة ليست نظرية، بل تتوقف على قدرة اللبنانيين على التنظيم خارج الطائفية السياسية، والاستمرار في امتناع/ أو منع القوى السياسية المسلحة في لبنان من التعامل بالعنف مع الانتفاضة الشعبية (كما حصل في العراق مثلًا). الواضح الآن أنّ هناك حالةً يشهدها لبنان لم يعد ممكنًا معها تجاهل معاناة اللبنانيين، أو الاستخفاف بإرادتهم ورغبتهم في تحقيق التغيير الذي منعه نظام محاصصة سياسي طائفي فاسد.
تعدّ الرسوم التي اقترحتها الحكومة اللبنانية على الخدمة الصوتية لتطبيق "واتساب" للهواتف الذكية المحرّك السببي لهذه التظاهرات، أو القطرة التي أفاضت كأس الاحتقان الشعبي، فقوة ردة فعل الجمهور اللبناني، وسعة انتشار الاحتجاجات التي أربكت الطبقة السياسية، تشيران إلى كمٍّ كبير من المشكلات البنيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة أدّى، في نهاية المطاف، إلى دفع اللبنانيين إلى تجاوز انقساماتهم الداخلية والطائفية، ورواسب الحرب الأهلية، والخروج إلى الشارع على امتداد لبنان، للمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة. ويمكن تحديد أربعة عوامل رئيسة مهدت لهذه الاحتجاجات.
1. سقوط نظام "الطائف"
نتج النظام السياسي اللبناني القائم من تسوياتٍ إقليمية ودولية، كان هدفها الرئيس إنهاء الحرب الأهلية التي امتدت خمسة عشر عامًا؛ أي إن هذا النظام لم يكن نتاج تسويات داخلية، أو اتفاق اللبنانيين عليه، بل كان مفروضًا عليهم من الخارج عبر وصاية النظام السوري، وبرعاية أميركية - سعودية عُبِّر عنها في "اتفاق الطائف". ومثّل اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، في فبراير/ شباط 2005، ضربة كبيرة لهذا النظام. ذلك أنه أدّى إلى نهاية نظام الوصاية السورية المباشرة، واستبدالها بانقسام سياسي بين تحالف "8 آذار" المدعوم من طهران ودمشق وتحالف "14 آذار" المدعوم من واشنطن والرياض، قبل أن يحسم حزب الله هذه المواجهة السياسية عسكريًا في "اجتياح" بيروت في أيار/ مايو 2008. أمّا الضربة الثانية التي تلقّاها هذا النظام، وأدت إلى ترنّحه، فقد تمثلت بالثورة التي اندلعت في سورية عام 2011 وكان لها تداعيات كبيرة على لبنان، بحيث انقسم اللبنانيون بين مؤيد للنظام ومؤيد للمعارضة، خصوصا مع تدخّل حزب الله مباشرة في الصراع السوري.
نتيجة ذلك، دخل لبنان حالة من التوتر السياسي والأمني استمرت في الفترة 2011 - 2013، قبل أن تتدخل القوى الخارجية لتفرض الاستقرار فيه، خوفًا من أيّ تداعيات سلبية على دور لبنان الذي يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين وقواتٍ دوليةً في جنوبه، فضلًا عن الحاجة إلى إدارة النزاع البحري وحلّه بين لبنان وإسرائيل حول استغلال حقول الغاز المكتشف حديثًا حينها في شرق المتوسط. تبلورت هذه المظلة الدولية عام 2014 برعاية أميركية – سعودية – إيرانية، أسفرت عن إسناد رئاسة الحكومة إلى شخصية محايدة نسبيًا هي تمام سلام. وفي عام 2016، تجدّدت التسوية بتوافق أميركي - إيراني لم ترض عنه السعودية، وأدى إلى إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، وانتخاب الجنرال ميشال عون للرئاسة في مقابل تولّي سعد الحريري رئاسة الحكومة. ولكن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات عليها واستهداف حليفها حزب الله، والتصعيد السعودي ضد إيران في اليمن، وغيرها، في بداية مرحلة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ذلك كله وضع ضغوطًا كبيرة على لبنان، وانعكس على النظام السياسي والاقتصادي، على نحوٍ أدّى إلى تفجر الاحتجاجات.
2. أفول الثنائية السنية - الشيعية
حوّلت المظلة الدولية التي نشأت منذ عام 2014 المواجهة بين الثنائية السنية - الشيعية إلى ائتلاف بينهما، وربما تحالف مبطن، وذلك بعد أن فقد سعد الحريري كل مقومات المواجهة مع حزب الله. ومنذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحكم في السعودية، وخصوصًا مع تولي ابنه محمد ولاية العهد، انسحبت السعودية ماليًا وسياسيًا من لبنان، على وقع تراجع نفوذها الإقليمي. فوق ذلك، قطعت السعودية كل مصادر التمويل عن سعد الحريري، وجمّدت استثماراته، ووصل الأمر إلى حد احتجازه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وإجباره على تقديم استقالته من رئاسة الحكومة. أدى ذلك كله إلى إضعافه، الأمر الذي بدا واضحًا في نتائج الانتخابات البرلمانية العام الماضي، حين خسر الحريري أغلبيته البرلمانية، وفاز تحالف خصومه من حزب الله والتيار الوطني بأغلبية المقاعد في مجلس النواب. واهتزت مواقع الحريري أكثر على وقع فضائح طاولته، وجاءت في وقتٍ كان مئاتٌ من موظفي الشركات والمؤسسات التي يمتلكها ينتظرون رواتبهم غير المدفوعة منذ سنين. وبناء عليه، لم يكن مفاجئًا أن تكون المناطق التقليدية التي كان ولاؤها تاريخيًا لآل الحريري أول من خرج للتظاهر مطالبةً بإسقاط الحكومة التي يرأسها. فلا نجح الحريري في الحفاظ على مواقع السنّة في الحكم، بل أضعف منصب رئيس الحكومة الذي تحوّل إلى أقلية معارضة داخل حكومته، ولا نجح في تقديم الخدمات، ولا استقال وترك حزب الله وعون يتحملان المسؤولية بدلًا من أن يشكّل واجهة لهما.
بالمثل، تعرّضت مكانة أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، إلى نكساتٍ عديدة، منذ قرّر الحزب القبض على السلطة في لبنان عام 2005 في محاولة لملء فراغ انسحاب النظام السوري. ولكن التداعيات الأكبر على مكانة الحزب بدأت منذ قرّر التدخل عسكريًا في الحرب السورية، وهو الأمر الذي تسبّب في أضرار فادحة على قاعدة الحزب الشعبية، ليس على المستوى المالي فقط بل نتيجة عودة جثث مقاتلي حزب الله من سورية من دون تفسير مقنع عن أسباب تضحياتهم. وفي بعض الأحيان، كان يتم تسليم الجثث من دون جنازة. ومنذ الحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز/ يوليو 2006، يعيش أمين عام حزب الله بعيدًا عن أعين الناس، ويخاطب جمهوره عبر شاشات كبيرة، على نحوٍ جعل تفاعله مع القاعدة الشعبية محدودًا. أكثر من ذلك، أدّت الضغوط التي تتعرّض لها إيران، وانغماسها في عديد من مشكلات الإقليم من سورية إلى العراق واليمن، إلى تكريس موارد وجهود أقلّ لحلفائها في لبنان. كما أنّ انشغال زعيم حزب الله، بمناسبةٍ وبغير مناسبة، في الدفاع عن سياسات إيران، في وقت تعاني فيه قاعدته الشعبية، أثّر أيضًا في شعبيته. وفي الفترة الأخيرة، بات الحزب يطلب تبرعاتٍ ماليةً من مناصريه، بدلًا من أن يستمر في تقديم خدماته الاجتماعية المجانية التي طبعت عمله في العقود الأخيرة.
لقد خدمت المواجهة السياسية بين الحريري ونصر الله منذ عام 2005 الطرفين لجهة أنها ساعدتهما في تحشيد المناصرين عبر شدّ العصب الطائفي، كلّ في طائفته، وضمان الدعم الإقليمي ضمن أجندةٍ خارجية معينة. ولكن مع انتهاء هذه المواجهة عام 2014، ثم دخولهما في ائتلاف حكومي منذ عام 2016، تبيّن لجمهور الطرفين عقم المعارك السياسية التي عطّلت البلد سنواتٍ من دون تقديم أيّ حلول لتسهيل حياة المواطنين، أو تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
3. أزمات نظام المحاصصة الطائفية
تمثل أحد أهم عناوين احتجاجات لبنان في تعرية الفشل البنيوي لنظام المحاصصة الطائفية باعتباره نظامًا ريعيًا يتم فيه اقتسام السلطة والثروات، والاستئثار بها وفق معايير لا تعتمد الكفاءة والأهلية من بينها. ومنذ عام 2005، يعيش لبنان حالةً من الشلل السياسي المستمر نتيجة هذا الصراع على اقتسام الموارد والسلطة، ما حال دون إقرار أيّ إصلاحات مهمة. وأغلقت الاضطرابات الإقليمية الباب أيضًا أمام مبادلات لبنان التجارية مع سورية والعراق والأردن وبلدان الخليج، ما أدّى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد وانكشاف المشكلات البنيوية في الاقتصاد اللبناني وسياساته المالية. ويتجاوز الدَيْن العام في لبنان حاليًا حاجز 85 مليار دولار؛ أي ما يمثّل 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ومعظم هذا الدين مستحقٌ للمصارف اللبنانية التي لديها نفوذ واسع النطاق على الطبقة السياسية. ولمّا كانت الحكومة تعكس ميزان القوى في مجلس النواب، أصبح من المستحيل مساءلتها أو محاسبتها، في حين يخضع القضاء لسطوة الطبقة السياسية الحاكمة، ولا يمكنه المساعدة في تصحيح المسار ومقاضاة عمليات الفساد داخل أجهزة الدولة وخارجها. وما يزيد الوضع سوءًا هو عجز الحكومة عن توفير الخدمات الرئيسة، مثل الكهرباء والمياه النظيفة ومنع التلوث ووسائل النقل العام وجمع القمامة وفرزها، وغيرها من المطالب التي عجز نظام المحاصصة الطائفية عن توفيرها، ما يفسّر هذا الخطاب العابر للطوائف بين المتظاهرين.
4. غياب العدالة في توزيع الثروات
يعدّ التفاوت الطبقي أحد أبرز أسباب الانتفاضة اللبنانية، وقد عبّرت التظاهرات عن ذلك بوضوح، ولا سيما التي خرجت خصوصا في الأطراف شمالًا وجنوبًا وفي سهل البقاع. ولم يكن يومًا التفاوت الطبقي بين أقليةٍ تُحكم سيطرتها على الثروات وأغلبيةٍ تعيش على هامش خط الفقر واضحًا في لبنان كما هو اليوم. وفي دراسةٍ لمنظمة أوكسفام، صدرت مطلع العام الجاري تبين أن سبعة أثرياء لبنانيين يملكون ثروة شخصية إجمالية تبلغ 13.3 مليار دولار؛ أي عشرة أضعاف ما يملكه نصف الشعب اللبناني. كما يملك 1% من اللبنانيين ثروة تزيد عمّا يملكه 58% من اللبنانيين. الدعوة إلى تحقيق حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية كانت الخطاب الجامع للمتظاهرين في شرحهم مكامن الفساد في النظام اللبناني. وتمثلت رسالة المتظاهرين الرئيسة في رفض فرض ضرائب جديدة لسدّ عجز الخزينة اللبنانية، في حين تزداد ثروات الطبقة الحاكمة، وقد برز ذلك في رفع شعار "استعادة الأموال المنهوبة".
إضافة إلى ذلك، برز دور المعضلة التي بات يواجهها القطاع العام الذي تجاوز حجمه قدرة الدولة على تمويله، بسبب التوظيف الفائض عن الحاجة على أساس المحاصصة الطائفية، ما جعله عبئًا على الاقتصاد، مع فاعلية إنتاجيةٍ منخفضةٍ بسبب ضعف الكفاءة وقلة الأجور التي تشجع على الفساد والرشوة. وسيبقى القطاع العام، على الأرجح، يعاني هذه المشكلات لعدم القدرة على اتخاذ قرار بإجراء إصلاحات بنيوية فيه، بسبب خوف الطبقة السياسية الحاكمة من خسارة النظام الريعي الذي حوّل الدولة إلى غنيمةٍ يقتسمها قادة الطوائف، عبر ممثليهم في الوزارات، ليقوموا بدورهم بتوزيع الريع (بما فيه الوظائف) على طوائفهم، بما يكرّس زعامتها التقليدية، لا سيما في ظل غياب وظائف بديلة، وتراجع الدعم المالي الإقليمي الذي موّل الحياة السياسية في لبنان عقودًا، مع تراجع أهميته، حتى بوصفه ساحة صراع.
خاتمة
يواجه لبنان انتفاضة غير مسبوقة في تاريخه الحديث، عنوانها الرئيس إسقاط الطبقة السياسية الحاكمة، وتقودها، خلاف العادة، الطبقات المتوسطة والفقيرة، ويحاول المجتمع المدني في المدن الكبرى التأقلم معها ومجاراة مطالبها. كما توحي مناطق انتشارها وتوزّعها في طرابلس وعكار وصور وزحلة وعاليه بانتهاء المركزية التاريخية التي طالما مارستها بيروت في تحديد إيقاع الحياة السياسية اللبنانية. الأهم من ذلك كله أنّ وعيًا سياسيًا جديدًا يتشكل في لبنان، ويؤسس لهوية وطنية جديدة، وتطلّعًا إلى نظام جديد يطوي صفحة الحرب الأهلية و"اتفاق الطائف" الذي أنتج نظامًا سياسيًا لم يعد قابلًا للحياة، فهل تنجح الانتفاضة في تحقيق هذه النقلة في حياة لبنان السياسية، في غياب قيادة واضحة، وآليات لتنفيذ المطالب، وفي ظل مقاومة شرسة للتغيير تبديها الطبقة السياسية التي تحكم البلد منذ عقود؟ المهمات صعبة، والإجابة عن هذه الأسئلة ليست نظرية، بل تتوقف على قدرة اللبنانيين على التنظيم خارج الطائفية السياسية، والاستمرار في امتناع/ أو منع القوى السياسية المسلحة في لبنان من التعامل بالعنف مع الانتفاضة الشعبية (كما حصل في العراق مثلًا). الواضح الآن أنّ هناك حالةً يشهدها لبنان لم يعد ممكنًا معها تجاهل معاناة اللبنانيين، أو الاستخفاف بإرادتهم ورغبتهم في تحقيق التغيير الذي منعه نظام محاصصة سياسي طائفي فاسد.