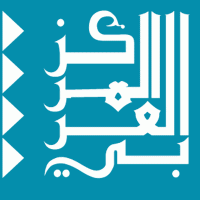18 نوفمبر 2024
احتجاجات العراق بين مطالب الشارع وعنف السلطة
من مشاهد الاحتجاج في شارغ فلسطين في بغداد (5/10/2019/الأناضول)
شهد العراق خلال الأسبوع الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2019 موجة احتجاجات واسعة في العاصمة بغداد، وعدد من محافظات الجنوب ومنطقة الفرات الأوسط، سقط خلالها عشرات القتلى (بعض الإحصاءات تعدّهم بالمئات)، وآلاف الجرحى، بعد أن تعرّضت لقمع غير مسبوق، يرجح أن بعض الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة مسؤولة عنه. وقد طرح ذلك أسئلة عديدة عن مدى قدرة الدولة على السيطرة على المليشيات، وعن مستقبل النظام السياسي برمته الذي نشأ بعد الغزو الأميركي للبلاد في عام 2003.
الدعوة إلى التظاهر
ظهرت خلال أيلول/ سبتمبر 2019 على وسائل التواصل الاجتماعي صفحات مجهولة بإعلانات مموّلة تدعو إلى الخروج بتظاهرات كبيرة ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي. وعلى الرغم من أن القوى السياسية التي درجت على تنظيم مثل هذه الاحتجاجات تبرّأت من هذه الدعوات، ولم يأخذها كثيرون على محمل الجد، كان لافتًا تصريح صدر عن قيس الخزعلي، زعيم "عصائب أهل الحق"، وهي من أكبر فصائل الحشد الشعبي، في أواخر آب/ أغسطس، حذّر فيه من حصول تظاهرات تنطلق مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، متهمًا إسرائيل والولايات المتحدة وأطراف عربية، بالوقوف وراءها.
وهناك عوامل عديدة ساعدت في جعل الأول من تشرين الأول/ أكتوبر موعدًا لخروج المحتجين إلى الشوارع، إذ شهد الشهر الماضي احتجاجاتٍ قطاعيةً نظمها أطباء، وأخرى لحملة الشهادات العليا العاطلين عن العمل، وثالثة لجنود مفصولين من الخدمة، وغيرها. لذلك، عندما انطلقت الحركة الاحتجاجية مطلع تشرين الأول/ أكتوبر في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، التحقت بها التظاهرات القطاعية القائمة.
إقالة الساعدي
رافق تصاعد عملية التحشيد نهاية أيلول/ سبتمبر أجواء سياسية معقدة، وخلافات متصاعدة داخل هيئة الحشد الشعبي، بين فصائل محسوبة على قوى عراقية وفصائل تدين بولائها لإيران،
على خلفية هجماتٍ تعرّضت لها مخازن سلاح تابعة للحشد، واتهامات متبادلة داخليًا وإقليميًا بشأن المسؤولية عنها. وقد شكل ذلك مناسبةً لظهور رأي عام ضاغط، يرفض دخول العراق إلى جانب أي طرفٍ في الصراع القائم بين إيران والولايات المتحدة.
وقد ازداد الاحتقان مع صدور قرار مفاجئ من رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، بنقل أبرز قادة المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وهو الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، من منصبه قائدا رفيعا في قوات النخبة وجهاز مكافحة الإرهاب، إلى دائرة الميرة والمحاربين؛ ما يعني تجريده من دوره العسكري، ومنحه وظيفة إدارية، تعد بمنزلة تجميد لضابط كبير.
ويمثل الساعدي لدى شريحة واسعة من العراقيين رمزًا لصعود الشعور الوطني العابر للانقسامات الطائفية، حيث برز دوره في لحظة استعادة الجيش مكانته بعد انتكاسة عام 2014 التي أظهرته عاجزًا أمام مقاتلي تنظيم داعش، ومحتاجًا إلى دعم فصائل مسلحة يرتاب الجمهور من مصادر تسليحها وتدريبها وتمويلها ومن مشاركتها في النزاع في سورية.
لذلك أصبحت إقالة الساعدي، قبل بضعة أيام من الاحتجاجات، عامل غضب وتحشيدًا إضافيًا. وقد لوحظ رفع صور له في ساحة التحرير، رافقتها شعارات واتهامات لإيران بالمسؤولية عن قرار استبعاده. وعزّزت ذلك تصريحات لقادة من فصائل الحشد تتهم الساعدي بالتآمر، والتحريض على التظاهر. وقد زاد رئيس الحكومة الوضع سوءًا، عندما صرّح إن هناك ضباطًا في الجيش يتمرّدون ويترددون على سفارات أجنبية؛ ما ترك انطباعًا بأن الساعدي قد يكون جزءًا من محاولة انقلاب عسكري تطيح الطبقة السياسية الفاسدة، وهو أمر يلقى صدى بين شريحة بارزة من المتظاهرين الناقمين على أداء السلطة.
تحول في المطالب وجيل جديد من المحتجين
أدّى التهديد الأمني الذي مثله تنظيم داعش منذ صيف 2014 دورًا كبيرًا في تغييب القضايا
الاقتصادية والخدمية عن واجهة الأحداث، وإلى دفع الناس إلى تأجيل الحديث عنها، أو التفاعل مع الدعوات إلى الاحتجاج على إهمال الحكومة لها. ولكن انتهاء الحرب بهزيمة "داعش"، وحصول استقرار أمني كبير منذ عام 2018، أعاد هذه القضايا إلى الواجهة، في ظل حالة إحباط عام من إمكانية تحقيق إصلاحات حقيقية؛ الأمر الذي أبرز شعار إسقاط الطبقة السياسية برمتها، وهو ما ظهر في احتجاجات البصرة خريف 2018 التي شهدت مؤشراتٍ على تبلور جيل جديد من المحتجين. وعلى الرغم من أن التظاهرات في البصرة ركّزت، مثل سابقاتها في عموم العراق، على فشل الإدارة والتنمية ونقص الخدمات والفساد، فإنها تجاوزتها لجهة تعبيرها عن مطالب عامة الناس، بعيدًا عن أجندات القوى والأحزاب السياسية. وقد لوحظ أن تلك الاحتجاجات لم تحظ بتأييد الأحزاب، أو مشاركتها، بما في ذلك القوى المحسوبة على اليسار. كما تعرّضت لإيران وحمّلتها مسؤولية التدخل في شؤون العراق، ودعم الفصائل المسلحة التي باتت جزءًا من البرلمان والحكومة وأجهزة الأمن. وقد هاجمت جموع المحتجين مقرّات هذه الأحزاب والفصائل، وأحرقتها وأزالت رموزًا وملصقاتٍ مؤيدة لمرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئي، وصولًا إلى مهاجمة قنصلية طهران في البصرة وإحراقها.
شكلت احتجاجات البصرة سابقةً تمثلتها تظاهرات بغداد والفرات الأوسط الأخيرة، حيث غابت أيضًا الأحزاب والقوى السياسية، وتمت مهاجمة مقرّاتها، وظهر بوضوح الحضور الطاغي لجيل الشباب الجديد من الفئة العمرية (16 إلى 30 عامًا) الذين يتسمون بضعف ولائهم للمنظومة الطائفية والعشائرية، وعدم درايتهم بالصراع السياسي الذي كان سائدًا في عهد حزب البعث ونظام صدّام حسين، أو اهتمامهم به، فضلًا عن أنهم ولدوا في فترة الانفتاح الكبير في عالم المعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعي الذي يجعلهم أكثر تأثرًا بالتحولات العالمية وتعاملًا مع اللغات والثقافات الأخرى.
أبعد من ثورة جياع
يمكن قراءة ما حصل في البصرة قبل نحو سنة، وفي بغداد والفرات الأوسط والجنوب في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، باعتباره جيلًا جديدًا من الاحتجاجات العراقية لا تتوقف مطالبه
عند توفير الخدمات وتحسين الظروف الاقتصادية والتخلص من فساد الطبقة السياسية، بل يتميز أيضًا في كونه نابعًا من شعورٍ عميقٍ بالانتماء إلى وطنية عراقية صاعدة، تؤمن بأن الاستقلال السياسي عن أي محور إقليمي ودولي هو مدخل لتغييراتٍ لا غنى عنها لتحقيق بقية المطالب، وتمهد لإصلاح سياسي يبدو مستحيلًا في ظل طبقةٍ سياسيةٍ يتم التحكّم بها من الخارج، وفي ظل اقتسام المغانم بين الفصائل المسلحة والجماعات الدينية في الداخل.
وفي هذا الإطار، يمكن تفسير الالتفاف الشعبي حول شخص الفريق المقال عبد الوهاب الساعدي، باعتباره رمزًا للوطنية العراقية التي هزمت "داعش"، وتسعى إلى الاستقلال عن تدخلات إيران.
التعامل مع الاحتجاجات
تعاملت النخبة السياسية الشيعية الحاكمة مع هذه الاحتجاجات باعتبارها تهديدًا وجوديًا لحكمها، ولا سيما الأطراف المحسوبة على إيران، والتي اتهمت التظاهرات بأنها موجهةٌ من الخارج ضد حكم الشيعة، علمًا أن الاحتجاجات قامت في المحافظات الشيعية، وجل المشاركين فيها هم من الشيعة. ويعضد هذا موقف الجهات الإيرانية الرسمية التي سارعت، على خلاف العادة، إلى اتهام المتظاهرين بأنهم جزءٌ من مؤامرة.
وتبدو خطورة هذه الاتهامات عبر تحديد رقعة التظاهرات التي تركزت في الأحياء ذات الكثافة السكانية والغالبية الشيعية في بغداد، ومحافظات جنوبية شيعية مهمة أخرى، مثل النجف وذي قار والديوانية والمثنى.
وإذ ينتمي الطرف الذي مارس الاتهام وتورّط بالقمع إلى الهوية المذهبية نفسها للطرف المحتج، فقد كان لافتًا حجم القمع المستخدم، حيث سقط قتلى وجرحى كثيرون بين المحتجين، فيما جرى قنص الناشطين، وتمت حملة اعتقالات واسعة، حتى في البصرة التي لم تنخرط في التظاهرات هذه المرة رغم وصفها بعاصمة الاحتجاجات في العراق. ونظرًا إلى أن النخبة الشيعية الحاكمة تعاملت مع الاحتجاجات بأنها تهديد وجودي، فإن ذلك يفسّر شدة القمع الذي شهدته الحركة الاحتجاجية، والذي مثل تحولًا نوعيًا في القمع والعنف الذي تمارسه السلطة ما بعد عام 2003، فضلًا عن الاعتقالات، وقطع الإنترنت، وتقييد الحركة، ما ظهر لكثيرين أن ردة فعل السلطة هذه تطيح بمكتسبات الحرية النسبية التي حازها العراق بعد عام 2003.
من أطلق النار؟
ساد الارتباك المواقف الحكومية والحزبية، بعد تصاعد أعداد الضحايا في احتجاجات تشرين الأول/ أكتوبر على نحو غير معتاد؛ إذ كان كل يوم من أيام التظاهرات الستة يحمل عددًا أكبر
من القتلى والجرحى، على نحو اضطر الحكومة إلى الاعتراف بوجود قناصة مجهولين طلبت من الجمهور مساعدتها في التعرف إليهم؛ ما أثار موجة من السخرية والغضب. وعلى الرغم من أنه ليس ثمة رقم رسمي لأعداد الضحايا، فإنه يقدّر، بحسب أرقام الطب العدلي، بـ 160 قتيلًا، وأكثر من ستة آلاف جريح.
وبرزت أولى الروايات، حول الجهة المتورطة بهذا المستوى من إطلاق النار المميت، من الجمهور نفسه؛ إذ كثر الحديث عن ملثمي الفصائل المسلحة، فيما راجت رواية أخرى عن وجود عناصر إيرانية تطلق النار على المتظاهرين. وجاءت إشارة قيادة العمليات إلى وجود قنّاصة مجهولين، لتعزّز فرضية وجود خرق أمنى على نحو ينزع القرار الأمني من يد الحكومة، في ظل وجود ميليشيات منفلتة لا تخضع لسلطة رئيس الوزراء.
ولكن إزاء تصريحات قادة العمليات في القوات النظامية، ظهر مستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، بخطاب يتهم فيه جهات خارجية بتنظيم التظاهرات، ويتحدّث بطريقةٍ توحي بأن المؤامرة التي يتحدّث عنها اضطرت الحكومة إلى إطلاق النار، متوعدًا، في الوقت ذاته، بالقصاص. وظهر رئيس الحكومة أكثر حذرًا في توجيه الاتهام، واكتفى بالقول إن استخدام العنف كان متبادلًا بين قوات الأمن والمتظاهرين، قبل أن يحوّل الموضوع بعيدًا عن تحديد المسؤولية في استخدام العنف المفرط ضد المحتجين، من خلال بذل الوعود بمنح مالية ووظائف. أما رئيس الجمهورية، برهم صالح، فقد برّأ الجهات الأمنية من مسؤولية استخدام العنف، وتحدّث عن مجرمين ارتكبوا خرقًا أمنيًا وتجب محاكمتهم.
ومع أن خطابًا لاحقًا لرئيس الحكومة تجاهل موقف رئيس الجمهورية كليا، فإن المرجعية الدينية اتفقت، في خطبة يوم الجمعة في تشرين الأول/ أكتوبر، مع موقف رئيس الجمهورية، واتهمت عناصر مجرمة بارتكاب القتل وإطلاق النار، لكنها زادت عليه بأن ذلك حصل أمام أنظار القوات الأمنية، بحيث لم تدع أي فرصة لتهرّب الحكومة من إجراء تحقيق. وذهب المرجع الأعلى، علي السيستاني، على لسان ممثله في خطبة الجمعة في مدينة كربلاء، إلى أن مهلة أسبوعين تبدو معقولةً أمام تحقيق رسمي يكشف للرأي العام حقيقة الجهات غير الحكومية التي قتلت المتظاهرين، وجرحت آلافا منهم، في سابقةٍ أخرى، لم تشهدها سنوات الاحتجاج الطويلة الأخرى.
خاتمة
نتيجة العنف الشديد الذي ووجهت به، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، هدأت الاحتجاجات، لكنها لم تنته على الأرجح؛ إذ لا تزال الأسباب التي أدت إليها قائمة. وتشهد وسائل التواصل
الاجتماعي دعواتٍ إلى تظاهراتٍ كبرى في أول جمعة ما بعد زيارة الأربعين؛ أي يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر، تتم الدعوة إليها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي، للمرة الأولى في تاريخ الحركة الاحتجاجية في العراق، أداة مهمة في الحشد والتعبئة؛ ذلك أن القمع المفرط الذي مارسته السلطة، وحالات الإعدام خارج إطار القانون جرى فضحها عبر مئات الفيديوهات التي صوّرتها كاميرات الهواتف المحمولة، وجرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
والمهم، هذه المرة، أن الحركة الاحتجاجية تجاوزت الشعارات المطلبية العادية إلى مطالب سياسية بإصلاح النظام أو حتى تغييره، من خلال إطلاق اسم "ثورة" و"انتفاضة"، على مثل هذه التحركات. من هذا الباب، يمكن اعتبار الاحتجاجات الراهنة بوصفها الحركة الأهم في مسار الحركة الاحتجاجية العراقية منذ عام 2003.
ظهرت خلال أيلول/ سبتمبر 2019 على وسائل التواصل الاجتماعي صفحات مجهولة بإعلانات مموّلة تدعو إلى الخروج بتظاهرات كبيرة ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي. وعلى الرغم من أن القوى السياسية التي درجت على تنظيم مثل هذه الاحتجاجات تبرّأت من هذه الدعوات، ولم يأخذها كثيرون على محمل الجد، كان لافتًا تصريح صدر عن قيس الخزعلي، زعيم "عصائب أهل الحق"، وهي من أكبر فصائل الحشد الشعبي، في أواخر آب/ أغسطس، حذّر فيه من حصول تظاهرات تنطلق مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، متهمًا إسرائيل والولايات المتحدة وأطراف عربية، بالوقوف وراءها.
وهناك عوامل عديدة ساعدت في جعل الأول من تشرين الأول/ أكتوبر موعدًا لخروج المحتجين إلى الشوارع، إذ شهد الشهر الماضي احتجاجاتٍ قطاعيةً نظمها أطباء، وأخرى لحملة الشهادات العليا العاطلين عن العمل، وثالثة لجنود مفصولين من الخدمة، وغيرها. لذلك، عندما انطلقت الحركة الاحتجاجية مطلع تشرين الأول/ أكتوبر في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، التحقت بها التظاهرات القطاعية القائمة.
إقالة الساعدي
رافق تصاعد عملية التحشيد نهاية أيلول/ سبتمبر أجواء سياسية معقدة، وخلافات متصاعدة داخل هيئة الحشد الشعبي، بين فصائل محسوبة على قوى عراقية وفصائل تدين بولائها لإيران،
وقد ازداد الاحتقان مع صدور قرار مفاجئ من رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، بنقل أبرز قادة المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وهو الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، من منصبه قائدا رفيعا في قوات النخبة وجهاز مكافحة الإرهاب، إلى دائرة الميرة والمحاربين؛ ما يعني تجريده من دوره العسكري، ومنحه وظيفة إدارية، تعد بمنزلة تجميد لضابط كبير.
ويمثل الساعدي لدى شريحة واسعة من العراقيين رمزًا لصعود الشعور الوطني العابر للانقسامات الطائفية، حيث برز دوره في لحظة استعادة الجيش مكانته بعد انتكاسة عام 2014 التي أظهرته عاجزًا أمام مقاتلي تنظيم داعش، ومحتاجًا إلى دعم فصائل مسلحة يرتاب الجمهور من مصادر تسليحها وتدريبها وتمويلها ومن مشاركتها في النزاع في سورية.
لذلك أصبحت إقالة الساعدي، قبل بضعة أيام من الاحتجاجات، عامل غضب وتحشيدًا إضافيًا. وقد لوحظ رفع صور له في ساحة التحرير، رافقتها شعارات واتهامات لإيران بالمسؤولية عن قرار استبعاده. وعزّزت ذلك تصريحات لقادة من فصائل الحشد تتهم الساعدي بالتآمر، والتحريض على التظاهر. وقد زاد رئيس الحكومة الوضع سوءًا، عندما صرّح إن هناك ضباطًا في الجيش يتمرّدون ويترددون على سفارات أجنبية؛ ما ترك انطباعًا بأن الساعدي قد يكون جزءًا من محاولة انقلاب عسكري تطيح الطبقة السياسية الفاسدة، وهو أمر يلقى صدى بين شريحة بارزة من المتظاهرين الناقمين على أداء السلطة.
تحول في المطالب وجيل جديد من المحتجين
أدّى التهديد الأمني الذي مثله تنظيم داعش منذ صيف 2014 دورًا كبيرًا في تغييب القضايا
شكلت احتجاجات البصرة سابقةً تمثلتها تظاهرات بغداد والفرات الأوسط الأخيرة، حيث غابت أيضًا الأحزاب والقوى السياسية، وتمت مهاجمة مقرّاتها، وظهر بوضوح الحضور الطاغي لجيل الشباب الجديد من الفئة العمرية (16 إلى 30 عامًا) الذين يتسمون بضعف ولائهم للمنظومة الطائفية والعشائرية، وعدم درايتهم بالصراع السياسي الذي كان سائدًا في عهد حزب البعث ونظام صدّام حسين، أو اهتمامهم به، فضلًا عن أنهم ولدوا في فترة الانفتاح الكبير في عالم المعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعي الذي يجعلهم أكثر تأثرًا بالتحولات العالمية وتعاملًا مع اللغات والثقافات الأخرى.
أبعد من ثورة جياع
يمكن قراءة ما حصل في البصرة قبل نحو سنة، وفي بغداد والفرات الأوسط والجنوب في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، باعتباره جيلًا جديدًا من الاحتجاجات العراقية لا تتوقف مطالبه
وفي هذا الإطار، يمكن تفسير الالتفاف الشعبي حول شخص الفريق المقال عبد الوهاب الساعدي، باعتباره رمزًا للوطنية العراقية التي هزمت "داعش"، وتسعى إلى الاستقلال عن تدخلات إيران.
التعامل مع الاحتجاجات
تعاملت النخبة السياسية الشيعية الحاكمة مع هذه الاحتجاجات باعتبارها تهديدًا وجوديًا لحكمها، ولا سيما الأطراف المحسوبة على إيران، والتي اتهمت التظاهرات بأنها موجهةٌ من الخارج ضد حكم الشيعة، علمًا أن الاحتجاجات قامت في المحافظات الشيعية، وجل المشاركين فيها هم من الشيعة. ويعضد هذا موقف الجهات الإيرانية الرسمية التي سارعت، على خلاف العادة، إلى اتهام المتظاهرين بأنهم جزءٌ من مؤامرة.
وتبدو خطورة هذه الاتهامات عبر تحديد رقعة التظاهرات التي تركزت في الأحياء ذات الكثافة السكانية والغالبية الشيعية في بغداد، ومحافظات جنوبية شيعية مهمة أخرى، مثل النجف وذي قار والديوانية والمثنى.
وإذ ينتمي الطرف الذي مارس الاتهام وتورّط بالقمع إلى الهوية المذهبية نفسها للطرف المحتج، فقد كان لافتًا حجم القمع المستخدم، حيث سقط قتلى وجرحى كثيرون بين المحتجين، فيما جرى قنص الناشطين، وتمت حملة اعتقالات واسعة، حتى في البصرة التي لم تنخرط في التظاهرات هذه المرة رغم وصفها بعاصمة الاحتجاجات في العراق. ونظرًا إلى أن النخبة الشيعية الحاكمة تعاملت مع الاحتجاجات بأنها تهديد وجودي، فإن ذلك يفسّر شدة القمع الذي شهدته الحركة الاحتجاجية، والذي مثل تحولًا نوعيًا في القمع والعنف الذي تمارسه السلطة ما بعد عام 2003، فضلًا عن الاعتقالات، وقطع الإنترنت، وتقييد الحركة، ما ظهر لكثيرين أن ردة فعل السلطة هذه تطيح بمكتسبات الحرية النسبية التي حازها العراق بعد عام 2003.
من أطلق النار؟
ساد الارتباك المواقف الحكومية والحزبية، بعد تصاعد أعداد الضحايا في احتجاجات تشرين الأول/ أكتوبر على نحو غير معتاد؛ إذ كان كل يوم من أيام التظاهرات الستة يحمل عددًا أكبر
وبرزت أولى الروايات، حول الجهة المتورطة بهذا المستوى من إطلاق النار المميت، من الجمهور نفسه؛ إذ كثر الحديث عن ملثمي الفصائل المسلحة، فيما راجت رواية أخرى عن وجود عناصر إيرانية تطلق النار على المتظاهرين. وجاءت إشارة قيادة العمليات إلى وجود قنّاصة مجهولين، لتعزّز فرضية وجود خرق أمنى على نحو ينزع القرار الأمني من يد الحكومة، في ظل وجود ميليشيات منفلتة لا تخضع لسلطة رئيس الوزراء.
ولكن إزاء تصريحات قادة العمليات في القوات النظامية، ظهر مستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، بخطاب يتهم فيه جهات خارجية بتنظيم التظاهرات، ويتحدّث بطريقةٍ توحي بأن المؤامرة التي يتحدّث عنها اضطرت الحكومة إلى إطلاق النار، متوعدًا، في الوقت ذاته، بالقصاص. وظهر رئيس الحكومة أكثر حذرًا في توجيه الاتهام، واكتفى بالقول إن استخدام العنف كان متبادلًا بين قوات الأمن والمتظاهرين، قبل أن يحوّل الموضوع بعيدًا عن تحديد المسؤولية في استخدام العنف المفرط ضد المحتجين، من خلال بذل الوعود بمنح مالية ووظائف. أما رئيس الجمهورية، برهم صالح، فقد برّأ الجهات الأمنية من مسؤولية استخدام العنف، وتحدّث عن مجرمين ارتكبوا خرقًا أمنيًا وتجب محاكمتهم.
ومع أن خطابًا لاحقًا لرئيس الحكومة تجاهل موقف رئيس الجمهورية كليا، فإن المرجعية الدينية اتفقت، في خطبة يوم الجمعة في تشرين الأول/ أكتوبر، مع موقف رئيس الجمهورية، واتهمت عناصر مجرمة بارتكاب القتل وإطلاق النار، لكنها زادت عليه بأن ذلك حصل أمام أنظار القوات الأمنية، بحيث لم تدع أي فرصة لتهرّب الحكومة من إجراء تحقيق. وذهب المرجع الأعلى، علي السيستاني، على لسان ممثله في خطبة الجمعة في مدينة كربلاء، إلى أن مهلة أسبوعين تبدو معقولةً أمام تحقيق رسمي يكشف للرأي العام حقيقة الجهات غير الحكومية التي قتلت المتظاهرين، وجرحت آلافا منهم، في سابقةٍ أخرى، لم تشهدها سنوات الاحتجاج الطويلة الأخرى.
خاتمة
نتيجة العنف الشديد الذي ووجهت به، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، هدأت الاحتجاجات، لكنها لم تنته على الأرجح؛ إذ لا تزال الأسباب التي أدت إليها قائمة. وتشهد وسائل التواصل
والمهم، هذه المرة، أن الحركة الاحتجاجية تجاوزت الشعارات المطلبية العادية إلى مطالب سياسية بإصلاح النظام أو حتى تغييره، من خلال إطلاق اسم "ثورة" و"انتفاضة"، على مثل هذه التحركات. من هذا الباب، يمكن اعتبار الاحتجاجات الراهنة بوصفها الحركة الأهم في مسار الحركة الاحتجاجية العراقية منذ عام 2003.