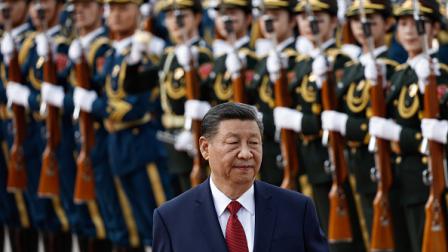وإذا كان من المبكر الحكم على تبون وسياساته من خلال المائة يوم الأولى فقط مع فرض التطورات المتسارعة المتعلقة بأزمة النفط ووباء كورونا تغييراً جذرياً في أولوياته وفي الأجندة السياسية، فإن هاتين الأزمتين تحديداً إلى جانب الحراك الشعبي، تمثل امتحاناً حقيقياً ومبكراً لتبون وحكومته الأولى، وتختبر قدرته على إنقاذ البلاد من شبح إفلاس مالي وأزمة وبائية طارئة وطرح رؤية إصلاحية مقنعة. مع العلم أنه أبدى منذ بداية تسلمه مهماته انفتاحاً نسبياً على قوى المعارضة واستعداداً للحوار وإقامة ما وصفها بـ"الجزائر الجديدة"، والتركيز على حل مشاكل المناطق الداخلية والحزم في الإنفاق العام وتغيير طريقة الحكم العام والحكم المحلي والسياسات الاتصالية.
في الأيام المائة الأولى من حكم الرئيس الجزائري، برزت بوادر ثاني أخطر أزمة نفطية ومالية في تاريخ البلاد بعد أزمة عام 1986، إذ انخفضت أسعار النفط تدريجياً إلى أن بلغت أدنى مستوياتها منذ عقود، وبدا أن البلاد متجهة إلى حالة من الشحّ المالي، تحديداً مع تراجع احتياطي البلاد إلى أقل من 60 مليار دولار. دفعت هذه الأوضاع إلى تضييق هامش المناورة بالنسبة لتبون وحكومته، بما أدى إلى إغلاق ما يمكن اعتباره "باب شراء السلم الاجتماعي" باستخدام الأموال وعائدات النفط، بالطريقة نفسها التي كان يستخدمها الرئيس المتنحّي عبد العزيز بوتفليقة.
وبالإضافة إلى أزمة أسعار النفط، فقد أطلت أخرى أكثر خطورة، وهي انتشار وباء كورونا الذي يضرب البلاد منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في 24 فبراير/ شباط الماضي. واستدعت الأزمة تحويل جزء من موازنات الدولة لصالح قطاع الصحة واستخدام المخزون الحيوي للبلاد من الأموال لاقتناء المعدات الطبية والمواد التموينية وتسريح نصف عدد الموظفين على عاتق الدولة وتعطيل الدورة الاقتصادية، وتعبئة الموارد البشرية للأمن والجيش للمساعدة في إدارة الأزمة.
لكن تبون لا يواجه هاتين الأزمتين فقط، فقد ورث أيضاً وضعاً سياسياً مضطرباً بسبب استمرار الحراك الشعبي (قبل تعليقه بسبب كورونا)، وتمسك المكونات السياسية والمدنية في الحراك بموقفها الرافض للتعامل مع الرئيس الجزائري والسعي لعرقلة خطط الإصلاح السياسي والدستوري التي يرغب في مباشرتها. وعلى الرغم من أن الحراك الشعبي والطلابي الحالي أقل عددياً مقارنة مع حراك فبراير 2019، إلا أن مكونات الحراك الشعبي أبدت في الأسابيع الأخيرة قدرة جدية على التعبئة في الشارع. كما عادت كتلة شعبية إلى الحراك (بعد مغادرته سابقاً) بسبب معارضتها لسياسات حكومة تبون وبعض توجهاتها.
وفي حال كان من الممكن المقارنة بين الفترة الأولى لحكم بوتفليقة وحكم تبون، فإن الأول حصل على مزايا عدة بدلاً من الأزمات التي يواجهها تبون. فقد سمح قانون الوئام المدني الصادر عام 1999 بتحقيق استقرار أمني كبير، وانعكس ذلك على الاستقرار السياسي والاجتماعي النابع من رغبة الجزائريين في الخروج من العشرية السوداء (1991 ـ 2002). كما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية وتدفقت المليارات إلى الخزينة. لكن توفر عوامل الاستقرار السياسي والاجتماعي والوفرة المالية لبوتفليقة، لم تكن بالضرورة عاملاً مساعداً في تحقيق منجزات اقتصادية واجتماعية، بل إن تبون ورث تراكمات كبيرة من الفساد السياسي والمالي، التي هي من مخلفات حكم بوتفليقة وسوء إدارة المال والمقدرات العامة. ويبدو ذلك واضحاً في القطاع الصحي على سبيل المثال في أزمة وباء كورونا.
ويرى الكثير من المتابعين أن الأزمات، ما عدا الحراك الشعبي المعلّق، تمثل امتحاناً حقيقياً لتبون وحكومته بشأن كيفية إدارة الأزمة ووضع خطط لتدبير الشأن العام في ظل انهيار أسعار النفط وتراجع المداخيل المالية للبلاد، التي تعتمد خزينتها العامة على عائدات النفط، فضلاً عن تآكل احتياطي الصرف المتوفر في الوقت الحالي وأزمة كورونا التي فرضت تعطيلاً للدورة الاقتصادية وتسريح نصف عدد الموظفين، ما حمّل على عاتق الدولة أكلافاً مالية إضافية.
في السياق، يبدي المحلل السياسي إبراهيم حاج ناصر، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، اعتقاده بأن الأقدار تقف ضد تبون، غير أنه إذا أحسن إدارة الظرف ونجح في إخراج البلاد من الأزمة الراهنة بأقل كلفة، فأظن أٍنها ستكون أساساً جيداً يبني عليه في حكمه، وفرصة لإثبات قدرته وحسن نواياه، وبالتالي تعديل مواقف الكثير من قوى المعارضة، خصوصاً القوى التي تربطها أزمة ثقة مع النظام أكثر من تبون نفسه. وبرأيه، فإن "الخلفية الإدارية لتبون، الذي شغل منصب وزير في الحكومة منذ التسعينيات وأدار قطاعات هامة ذات صلة بالشأن العام في عهد بوتفليقة، يمكن أن تساعده في حسن إدارة الأزمة الوبائية وأزمة أسعار النفط وتراجع المداخيل، على غرار قراره مراجعة الكثير من الموازنات الحكومية لتمويل خزينة الدولة ومواجهة الأزمة. أعتقد أن الرئيس تبون وُضع مباشرة في امتحان وأمام قدر سياسي ومجتمعي من دون مقدمات، وسيكون ذلك محدداً رئيسياً في تقييم عهده".
على صعيد آخر لم تُحدث فترة الـ100 يوم الأولى من حكم تبون فارقاً كبيراً في تعامل السلطة مع الحراك الشعبي وفي مجال الحريات، مقارنة بالفترة التي سبقت توليه الرئاسة، إذ ظلت الأجهزة الأمنية تمارس الأساليب نفسها في قمع واعتقال الناشطين في الحراك الشعبي والمعارضين، تحت عناوين مختلفة. وينطبق الأمر أيضاً على قطاع الإعلام الذي تُحكم السلطة والأجهزة الأمنية قبضتها عليها وتوجه سياساتها التحريرية، فضلاً عن قطاع القضاء رغم وجود مقاومة جدية داخله ضد هذه الممارسات.
في هذا الإطار، يعطي الحقوقي عبد الغني بادي تقييماً سلبياً للأشهر الثلاثة الأولى من حكم بوتفليقة، قائلاً لـ"العربي الجديد"، إن "الاعتداء على الحريات في مرحلة تبون تجاوزت تلك التي كانت في عهد بوتفليقة الذي كان يحظر التظاهر مثلاً في العاصمة، لكنه في المقابل لم يسجن خصومه السياسيين".
في موازاة ذلك، ثمة مؤشرات إيجابية على صعيد طرح مسودة دستور جديد وتضمينه الكثير من التغييرات المؤثرة في نظام الحكم وإصلاح العلاقات بين المؤسسات، وكذلك الانفتاح على المعارضة. فقد بادر تبون في هذا الصدد، إلى كسر الجمود ملتقياً عدداً من رموز المعارضة، كمنسق مؤتمر المعارضة عبد العزيز رحابي، ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيسي الحكومة السابقين مولود حمروش وأحمد بن بيتور، وقادة أحزاب داعمة للحراك الشعبي. كما أقدم على إجراء تعديلات طفيفة في إدارة الشأن المحلي، وأرغم المسؤولين المحليين على إنهاء التأخير البيروقراطي في معالجة مشاكل المواطنين وحاجات المناطق التي يصفها بـ"مناطق الظل". كما قام بتفعيل ملف العلاقات الخارجية للجزائر، مع قيامه بزيارتين إلى الخارج: الأولى إلى ألمانيا للمشاركة بمؤتمر برلين المتعلق بالقضية الليبية، وذلك بعد 7 سنوات من الغياب الرسمي الجزائري عن الملف بسبب مرض بوتفليقة. أما الزيارة الثانية فكانت باتجاه السعودية، رغم عدم تحقيقها أي هدف. كما كان متوقعاً أن يزور تونس في 16 مارس/ آذار الحالي، لكن أزمة كورونا اضطرته لإلغاء الزيارة.