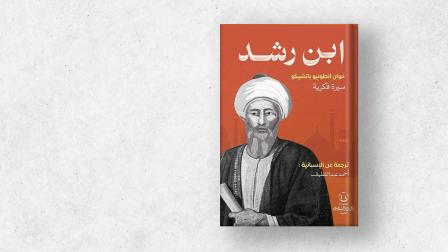في النسخة التي حققها من كتاب "الإشارات الإلهية"، وصدرت في القاهرة في خمسينيات القرن الماضي، أفرد أستاذ الفلسفة عبد الرحمن بدوي مقدمة طويلة عقد فيها مقارنة بين أبي حيان التوحيدي وفرانتس كافكا، وقد عنونها بـ"أديب وجودي في القرن الرابع الهجري"؛ فلا ننسى هنا أننا في فترة كان فيها تيار الوجودية يبسط فيها سلطانه على الفكر الفلسفي في العالم في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وكان بدوي واحداً من مبشريها في العالم العربي.
في هذه المقدمة، حاول بدوي تبيان العلائق النفسية بين التوحيدي وكافكا، باسطاً أسباب يأسهما البالغ بمقارنة أحدهما بالآخر، ذلك اليأس من الناس الذي حدا بأبي حيان مثلاً لإحراق كتبه، حتى إنه وضع رسالة يفسّر فيها لماذا أقدم على ذلك، رداً على رسالة تلقاها من القاضي أبي سهل عليّ بن محمد يعذله فيها على صنيعه.
"الإشارات الإلهية" مجموعة من الرسائل فيها اقتراب من عالم التصوّف تتجه لمخاطَب غير معيّن، تمت صياغتها في شكل مواعظ وعلامات طريق. وفي نسخة أخرى من "الإشارات" حقّقتها الباحثة وداد القاضي، وصدرت في بيروت مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، تقول المحققة في مقدّمتها: "تعتمد الرسائل جميعها بناءً متشابهاً في التركيب الأصلي، يقوم على ركنين أساسيين هما: المناجاة (أو الدعاء) ومخاطبة شخص ما. والرسالة غالباً ما تبدأ بالدعاء وتنتهي بالدعاء، وتتراوح في ما بين ذلك بين الخطاب والدعاء وأغراض أخرى، أبرزها شكوى الحال والزمان، وفي حوالي ثلثي الأحوال تنتهي بعبارة: يا ذا الجلال والإكرام".
من الذي يخاطبه التوحيدي في كتابه؟ لقد كُتبت الرسائل بصيغة المخاطَب "أنت"، و"الإشارات" بذلك كتاب فريد، إذ عُدّ أطول نص تراثي عربي يستخدم ضمير المخاطب لا كعلامة اتصال بين كاتب وقارئ، وإنما كجزء من صنعة النص نفسه، خبراً لا إنشاءً، وبلاغةً لا اتصالاً، بحسب خيري دومة في كتابه "أنت، ضمير المخاطب في السرد العربي".
لكنّ مخاطَب التوحيدي غير معيّن ولا معروف، ليس هناك من ملك أو أمير كُتب له الكتاب بشكل حصري، ولا كان إجابة على مسألة أو رداً على رسالة، وإن كان التوحيدي في رسائل قليلة جدا - من مجموع 54 رسالة - يخاطب شخصاً مجهولاً كما لو كان يطلب منه جزاء مادياً على كتابه، على ما تقول القاضي، والتي تضيف بأنه في خصوص بناء الكتاب "يبدو أبو حيان وكأنه يقف في نقطة متوسطة: مادّاً يده الواحدة إلى شخص مثله (أو أدنى منه) لينتشله مما ألمّ به من حَيْرة، أو مادّاً الأخرى إلى "شيخ" أو "قطب" يلتمس بركته ويتخذه وسيلته إلى رضى الله".
لكن هل هناك مريد حقاً من جهة وشيخ من جهة أخرى في واقع الحال؟ تعود القاضي متسائلة. ويمكننا أن نستخلص من إجاباتها أن هذه طريقة تأليفية اتخذها التوحيدي ليبني عليها كتابه. فإن كان التقليد المرعي في كتب التراث تأليفُها بناء على طلب ما، كما فعل التوحيدي نفسه في "الإمتاع والمؤانسة" حين كتبه لأبي الوفاء المهندس، فإنه هنا يتخذ هذا التقليد سبباً في الابتكار، إنها كتابة إبداعية بالمعنى الحديث، أي إنها كذب، ولا نقول "رواية" بحيث نعتقد أنه لكي نفهم التراث لا بد أن نقيسه على حاضر نعرفه، مع أن كلمة "رواية" للمفارقة كانت تختصّ بنقل أحاديث الرسول على شفاه أصحابه.
وفي قياس الماضي على الحاضر، يمكن لنا أن نورد بعضاً من مواقف بدوي من التوحيدي، والتي جاءت متعسفة في معظمها، ومن ذلك أنه حاول أن يجعل من التوحيدي وجودياً قبل نشأة الوجودية ذاتها، فهو مثلاً وإن كان يرى أن التوحيدي في رسائله "لا يخاطب إلا نفسه ما يعني أنه يقول بازدواج في نفسه"، إلا أنه يفسر هذا الازدواج بالقول "ومن هذا نستطيع أن نستخلص أن هذا العلوّ (transcendence) الذي يتجه إليه في هذه المناجيات أو الصلوات ما هو إلا نفسه، وبذلك نظل في داخل ملكوت الإنسان، شأن كل فلسلفة وجودية حقيقة. فلا يجب أن ننخدع كثيراً بتكراره كلمة: "إلهي" التي يستهل بها عادة فقرات هذه المناجيات، فقد تكون مجرد العادة اللغوية هي التي تحمله على استخدامها"!
سنرى أن القاضي اتفقت مع بدوي في أن التوحيدي ربما هو المعني بالخطاب في الرسائل حين تقول: "فهذا الصاحب الذي يدعوه أبو حيان للهداية هو الإنسان عامة، وهو أيضاً ذلك الشق من أبي حيان نفسه الذي لم يستطع أن يرتفع بصاحبه عن الدنيا وشهواتها ليجعله ديّناً فاضلاً وصافياً في علاقته مع الله، هو قرينه، قرين السوء". لكنها تضيف "أمّا الشيخ الصوفي فهو رمز للموقف الأسمى، أو للشخص الأفضل الذي يطمح إليه أبو حيان".
 هكذا إذن حين يقف مخاطَب التوحيدي عند وداد القاضي موقفاً وسطاً بين مريد وشيخ، بين نفسه وقرين سوئه، يتبعه بدعاء لله بعد أن شَغله وعظه العنيف لصاحبه بهموم الدنيا، ثم صارفاً نفسه عنها إلى المناجاة، فإنه عند بدوي يقف بين نفسه ونفسه الأخرى المتعالية بحيث إن اتجاهه في الصلوات والمناجيات ليس إلا لنفسه!
هكذا إذن حين يقف مخاطَب التوحيدي عند وداد القاضي موقفاً وسطاً بين مريد وشيخ، بين نفسه وقرين سوئه، يتبعه بدعاء لله بعد أن شَغله وعظه العنيف لصاحبه بهموم الدنيا، ثم صارفاً نفسه عنها إلى المناجاة، فإنه عند بدوي يقف بين نفسه ونفسه الأخرى المتعالية بحيث إن اتجاهه في الصلوات والمناجيات ليس إلا لنفسه!
من هنا فإن بدوي وإن كان لا يقول بزندقة التوحيدي على ما ذهب بعضهم، فإنه ليس بمستغرب رأيه في أن "المستقصي لمراميه البعيدة لا يعدَم أن يجد سنداً لاتهامه بأنه كان في القليل رقيق الدين، أو أنه كان يلوّنه بلون خاص به لا ينظر إليه أصحاب السنّة نظرة الرضا". تلك المرامي البعيدة التي استنبطها بدوي سلفاً ضاماً إياها إلى الفلسفة الوجودية، ونازعاً عنها بعدها الديني راداً إياها فقط إلى أبعاد إنسانية متعالية ومتجاوزة لِذاتها.
ربما يكون عند التوحيدي نفسه ما يمكننا من ردّ تأويلات بدوي، والميل لتفسيرات القاضي عن موقع التوحيدي بين نفسين إحداهما قرينة سوء، والأخرى مثل أعلى لنفسٍ أسمى، لكنها لا تأخذ مكان الإله مثلما عند بدوي، أو تتحد به على ما يذهب إليه في وصفه تصوف التوحيدي بأنه "تصوف اتحاد".
في رسالته سالفة الذكر إلى القاضي أبي سهل علي بن محمد يورد التوحيدي من بين الأسباب التي دفعته إلى حرق كتبه ما يلي "إنّ العلم، حاطك الله، يراد للعمل، كما أن العمل يراد للنجاة؛ فإذا كان العمل قاصراً عن العلم، كان العلم كَلّاً على العالم، وأنا أعوذ بالله من عِلم عاد كَلّاً، وأورث ذلّاً، وصار في رقبة صاحبه غُلّاً"، ثم يضيف أبو حيان واصفاً كتبه "على أني جمعت أكثرها للناس، ولطلب المثالَة منهم، وَلِعَقْد الرياسة بينهم ولمدِّ الجاه عندهم، فحُرِمْتُ ذلك كله، ولا شك في حسن ما اختاره الله لي، وناطهُ بناصيتي، وربطهُ بأمري، وكَرِهْتُ مع هذا وغيره أن تكون حجّة علي لا لي".
يقف التوحيدي محبطاً إذن بين أمل لم يحققه، وعلم لم يجد نظيره في عمله، كما لو أن حالته تلك كانت دافعه إلى تقريع نفسه في "الإشارات" من أجل تحقيق ذلك التوازن المبتغى، خصوصاً وأن الإشارات على ما يقول النقاد هو كتابه الأخير.
لكنه كذلك يائس من إهمال الناس له وانصرافهم عمّا كتب؛ إنه يطلق في "الإشارات" زفرات أسى ونداءات "أملٍ يائس"، فيصف الغريب كما لو كان يتحدث عن نفسه ويقول "الغريب من إذا قال لم يسمعوا قوله، وإذا رأوه لم يدوروا حوله. الغريب من إذا تنفّس أحرقه الأسى والأسف، وإن كتم أكْمَده الحُزن واللَّهف. الغريب من إذا أقبل لم يُوَسَّع له، وإذا أعرض لم يُسْأل عنه"، حتى نراه يقول: "فتعال حتى نبكي على حالٍ أحدثَت هذه النَفْوة، وأورثَت هذه الجَفْوة: لعلَّ انحدارَ الدَّمع يُعْقِبُ راحةً... من الوَجْدِ أو يَشْفِي نَجِيَّ البلابلِ".