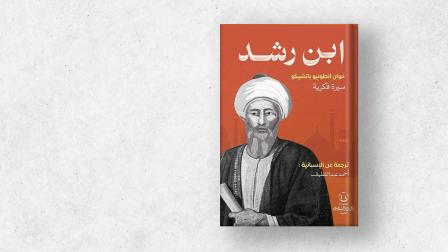أقمتُ لفترة قصيرة في مدينة غرناطة، في "كارمن دو لا فيكتوريا" تحديداً، وهو مسكن الأساتذة الزائرين في "جامعة غرناطة"، الواقع على مرتفع من حيّ البيازين Albaicín الشهير الذي يعود بأصوله وتخطيطه ومعظم مظهره واسمه أيضاً إلى الفترة العربية.
اسم "الكارمن" نفسه في غرناطة يحيلنا إلى ماضي المدينة العربي؛ حيث إنَّ الكلمة، التي تبدو اليوم إسبانية مئة بالمئة، ما هي إلّا اللفظ الإسباني لكلمة "كرمة" التي منحت اسمها لبيوت غرناطة النصرية أو الموريسكية التي تمتّعت كلّها بباحة نبتت في وسطها على الأقل كرمة أو أكثر، كما هي حال غالبية طرز البيوت ذات الباحة في العالم العربي بمجمله، والتي كان لكل منها شجرته المفضلة.
تتميّز "كارمن دو لا فيكتوريا" بأنها تواجه أعظم أوابد غرناطة وواحداً من أهم المعالم المعمارية الإسلامية في العالم، مدينة الحمراء، المدينة الملكية التي أنشأها وأقام فيها ملوك بني الأحمر أو بني نصر منذ تولّيهم حكم المدينة عام 1232 وحتى سقوطها عام 1492م. وقد عنى هذا أنّي تمتعتُ بمنظر ساحر من نافذتي كل يوم من أيام إقامتي هناك.
كما أن ذلك عنى أنّي مررت تحت أسوار الحمراء في صعودي ونزولي اليوميّين إلى مركز المدينة، أحياناً لأكثر من مرّة في اليوم الواحد. ولا أبالغ إذا قلت إنَّ هذه القلعة الحمراء العتيدة المزنرة بالأخضر اليانع بهرتني بجمالها وأبهتها كما بهرت كثيرين قبلي خاصة كما تظهر اليوم ليلاً بإضاءتها الدراماتيكية التي تُضفي عليها غلالة من السحر؛ إذ إنها تنزعها من محيطها الواقعي لتجعلها تبدو كما لو أنها تطفو على ما حولها من سفوح مشجرة خارج قواعد المكان والمادة.
ولكن الحمراء لم تكتف بإفعام إحساسي بالجمال والسحر كما لا يمكن الكثير غيرها من الأوابد المعمارية أن تفعل، بل ولم تنزل في وجداني منزل الحنين المتألّم الذي تنزله في وجداننا العربي المعاصر عادةً، بل أجبرتني على التفكّر في مآسينا العربية المعاصرة، خاصة في فلسطين التي تشهد اليوم تسارعاً محموماً إلى إنهاء قضيتها. ثمّة وجهة نظر أخرى أثارتها فيّ غرناطة والتأمُّل في تاريخها ومعناها يومياً، لعل في طرحها هنا فائدة أو على الأقل عبرة، كما كان الأقدمون يقولون.
فغرناطة هي المكان الأمثل للتأمل في معنى الهزيمة والنفي والهجر بالنسبة إلى العرب؛ فهي مُدرجة في ذاكرتنا الجمعية باعتبارها آخر مدينة في الأندلس تسقط في يد حملات الاستعادة الكاثوليكية التي بدأت قبل أربعة قرون بهدف طرد المسلمين من شبه الجزيرة الإيبيرية.
بسقوطها في بداية 1492 على يدي الملكين الزوجين، إيزابيلا ملكة كاستيللا وفرديناند ملك ليون، انتهى الوجود الإسلامي في إسبانيا، وانزاحت الأندلس من الواقع إلى الذكرى؛ حيث اكتسبت صفات خارقة من الكمال والأبّهة والتعايش والإبداع ما فتئت تزداد حدّةً بازدياد تدهور الواقع العربي المعاصر.
وبسقوط غرناطة أيضاً هُجّر آخر الأندلسيّين من بلادهم لينداحوا في الأرض، خصوصاً في مدن المغرب العربي، حاملين معهم ذكريات وأسلوب حياة وترفُّع لم يوهنه واقع حال الاغتراب والمنفى. أنشأوا أندلسات صغيرة في مدن غربتهم، حملت عموماً اسم الحي الأندلسي ولا تزال، وحفظوا تراثاً ازداد تألّقاً بتباعد هجرتهم وتيقّنهم بألّا عودة إلى الأندلس ما زلنا نجده في الموسيقى الأندلسية ورقص السماح، وربما الفلامنكو أيضاً، وفي الكم الهائل من قصائد الرثاء والحزن والنواح والتذكّر التي ألّفها آلاف الشعراء منذ يوم سقوط غرناطة وحتى اليوم.
لا تزال مدينة غرناطة تشهد على ذلك العصر الذهبي للثقافة الإسلامية في العديد من معالمها الأساسية التي وإن كانت قد حُوّرت وغُيّرت في القرون الخمسة الماضية، إلّا أنها ما زالت تحمل من ماضيها بقايا مترعة بالجمال. هناك طبعاً قصور الحمراء التي بقي منها اثنان من أصل سبعة أو ثمانية، وهما قصر الريحان وقصر الأسود. كلّ منهما يتميّز بعمارة خاصة. بركة مستطيلة طويلة لقصر الريحان تحيط بها غرف ضيّقة من الجانبين الطويلين، وقاعة عرش مبنية داخل برج لا تفوقها في دقّة ونمنمة زخرفها قاعة أخرى، لها سقف جملون خشبي مزخرف بالأشكال الهندسية المعقّدة والمتداخلة.
أما قصر الأسود، فله باحة في وسطها بركة ذات اثني عشر ضلعاً يحملها اثنا عشر أسداً تفور المياه من أفواهها، وتحيط بالباحة قاعات مختلفة تميزت أيضاً بالنمنمة الزخرفية، وبخاصة القاعتين المعروفتين اليوم بقاعتي الأختين وبني سراج اللتين تتميزان بقبتيهما المقرنصتين اللتين لا أعتقد أن هناك مثيلاً لهما في تعقيدهما الهندسي ثلاثي الأبعاد في العالم.
أمّا في المدينة ذاتها، فهناك قاعة المدينة التي كانت يوماً مدرسة أنشأها الملك أبو عبد الله محمد الخامس الذي حكم لفترة طويلة في القرن الرابع عشر، والذي زوّق المدرسة على غرار قصر الأسود الذي أنشأه هو أيضاً في الحمراء. وهناك أيضاً الخان المعروف بخان الفحم الذي يعود أيضاً إلى القرن الرابع عشر، وتُستخدَم فراغاته اليوم كمحترفات، إضافةً بالطبع إلى حيّ البيازين الذي يعانق التلة المواجهة لتلة الحمراء، والذي ما زال بفراغاته وغالبية منازله وقصوره وكنائسه (التي كانت يوماً مساجدَ) يستعيد أصوله العربية في تشكيلها وتخطيطها.
لقرون عديدة، استذكر الشعراء والكتّاب والوعّاظ العرب غرناطة، وخاصة قصور الحمراء، على أنها الجنّة المفقودة، المدينة الرائعة التي لم نتمكّن من الحفاظ عليها وخسرناها (جماعياً) لملوك إسبانيا الكاثوليك. تبلورت ذكرى الخسارة تلك في قصة خيالية على الأغلب عن آخر ملوك غرناطة من بني الأحمر، محمد الثاني عشر المعروف في الغرب باسم بوعبديل (أبو عبد الله)، الذي قيل إنه، وهو في طريقه إلى المنفى في المغرب بعد استسلامه، تلفّت إلى الوراء ليُلقي نظرةً أخيرة إلى الحمراء ويتنهد، وقالت له أمّه عائشة الحرّة (التي ما زالت بقايا قصرها قائمة في الجزء الشمالي من البيازين مقابل السور الزيري) العبارة القاسية: "ابك كالنساء مُلكاً لم تحافظ عليه كالرجال".
هذه اللحظة منحت بقعةً على تلّة خارج غرناطة يزورها السيّاح اليوم، اسمها "تنهيدة المور الأخيرة" (أي الموريتاني، العربي، الأسود) جرى تصويرها في العديد من اللوحات الأوروبية الاستشراقية من القرن التاسع عشر عندما كانت أوروبا تؤكّد لنفسها سيطرتها على الأرض والتاريخ. هذه اللحظة تُعتبر تجسيداً للاستسلام والحزن العميق واليأس، وهي كلّها نابعة من خسارة مدينة ومملكة لا يمكن تعويضها.
ظلّت غرناطة ذكرى غائرة عن الفقدان المتطاول لمدّة طويلة حتى فقدنا فلسطين في منتصف القرن العشرين. إثر هذه النكبة أضحت فلسطين الجرح الطازج، والخسارة الأخيرة الجديدة التي تتباكى عليها الركبان وينوء بثقلها وعي أجيال من العرب منذ ذلك الحين. يبدو أن "إسرائيل" والعالم الغربي وحلفاءهم العرب أضحوا قاب قوسين أو أدنى من محوه، ولكن غرناطة لم تُنس رغم تقادم الزمن ودمجها تماماً في الواقع الإسباني والأوروبي الأوسع. وهي ما زالت حاضرة في عدد لا يُحصى من الأعمال الأدبية والفنية التي تستعيدها بحمية وتعيد تخيّلها بشكل مثالي ورؤى مبالغ فيها عن عظمة الماضي.
لا أودُّ لفلسطين أن تذهب مذهب غرناطة، ولكنّني أيضاً لا أعتقد أنها ستُنسى.
* مؤرّخ معماري سوري وأستاذ كرسي الآغا خان للعمارة الإسلامية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا