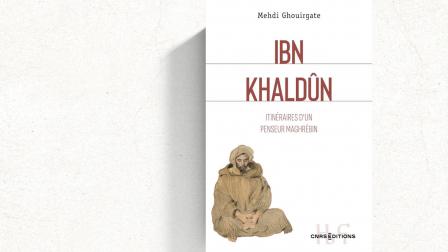لا يخفى على من يشاهد عرض "الماضي" للمخرجة الأرجنتينية كونستانزا ماركاس التعدّد الفني والثقافي الذي يقف خلفه. كانت ماركاس قد درست الرقص في بلادها قبل أن تنتقل إلى الحياة في أمستردام ثم نيويورك فبرلين، حتى أسّست، مع المسرحي كارمن ميهنرت، فرقة دوركي بارك (2003)، التي تراوحت أعمار أعضائها من 4 إلى 72 عاماً.
استفاضت ماركاس في التنوّع البصري والأدائي للعرض الذي أقيم على خشبة "شاوبونه" في برلين، ويعاد تقديمه على المسرح نفسه في آذار/ مارس المقبل.
يجمع "الماضي" بين مستويات متعددة من الذاكرة ويستحضرها على نحو مشوّش، إذ يشوب هذه الاستعادة الأدائية ضياع لفواصل إدراك الذاكرة، التي تتردد بين ما حصل حقيقة وما هو متخيّل أو ما هو مرغوب فيه، وفوق كل هذا الخوف من ممارسة فعل التذكّر نفسه.
يحاول أحد الممثلين على الخشبة صعود درج، بينما يشرح معنى الذاكرة وعلاقتها بالمتخيّل من دون أن ينجح في صعود السلّم. فكلّما صعد درجة وهو منهمك بالحديث عن الذاكرة يتعثر ويقع. إنه لا ينجح في صعود ثلاث درجات، ولا في أن يُفهم المتلقي ما يريد قوله فعلاً عن الفرق بين الذكريات والتخيلات.
أما الخشبة نفسها، فتبدو مكاناً مجهولاً ومبعثراً ولا يوجد في السينوغرافيا ما يحيله إلى مرجعية واضحة أو تصورٍ لما يمكن أن يكون عليه. هناك مجموعة من الآلات الموسيقية، وفي المؤخرة ثمة تصميم ضخم لشقق سكنية، هناك أدراج أيضاً والكثير من الأطباق اللاقطة على أسطح البنايات.
تدخل عازفة كمان وتبدأ العزف بشكل رديء، ثم يظهر شاب مزعج ونحيل من حقيبة في منتصف المسرح، ممعناً في استغلال نحوله الشديد، يقوم بتكبيل نفسه بيديه بطريقة غير مألوفة للجسد البشري، فيمشي وكأن أحداً ما يمسكه من خصره ويوجهه، إلا أن اليدين اللتين تمسكانه هما يداه هو نفسه.
بدأ مشروع مسرحية "الماضي" بمقابلات أجرتها الفرقة مع أشخاص عاشوا في مدن لم تعد موجودة في يومنا هذا، أو حدثت فيها تغيرات دراماتيكية غيّرتها تماماً. وبهذه المقابلات تحاول المخرجة أن تقول إن فهم الماضي، حتى الشخصي منه، لا يمكن أن يتم بمعزل عن التغيرات الكبرى من حولنا، أياً كانت أسبابها.
تقدم ماركاس المكان على أنه العنصر الأكثر تعلّقاً بالذاكرة سواء أكانت فردية أم جمعية، فهو حاضن للذاكرة، ولهذا تتشوش هذه عند اصطدامها بفراغ المكان ودماره لتولد انطباعات وصور مشتتة تارة ومبهمة تارة أخرى.
تحاول الذاكرة أن تجد المكان بمعناه الفيزيائي والمعماري إلا أنه بات فارغاً، الأمر الذي يقود إلى سرديات تمزج الذكريات بالانطباعات الفردية ومحاولات التخيّل والتوق إلى النسيان وأثر الحنين، ولعلها انطباعات تخصّ العديد من سكان المدن العربية الذين هجروا دمارها في وقتنا الراهن.
يستكشف عرض "الماضي" أشكالاً متنوّعة لاستحضار الذاكرة، فيرصد المجالس التي يحييها الغرباء ليتبادلوا الحديث عن مشاكلهم الراهنة وماضيهم البعيد. تظهر كذلك جلسات التحليل والعلاج النفسي. وتتنقل الكاميرا على الخشبة، ليدرك المشاهد أن ما تم عرضه ليس إلا جزءاً من عملية تصوير وتوثيق؛ فجأة تصرخ العاملة في تصوير الفيلم بأحد العمال الذين يمددون أسلاك المعدات لأنه ظهر في الكاميرا.
لا مجال لحدوث أي طارئ أثناء عملية التصوير أو استحضار الماضي، ولا مجال لحضور أي عابر يلوث لحظة الاستعادة التي يتم التقاطها. وبين السينما الساعية إلى التشذيب والمسرح المفتوح على كل شيء، تتداخل مستويات العرض مرة أخرى؛ لنخرج من عرض مسرحي يصبح هو أيضاً جزءاً من الماضي، لكن يبدو كما لو أنه سيظل محافظاً على راهنيته، إذ إنه يلتقط الصور للماضي المتجدد باستمرار.