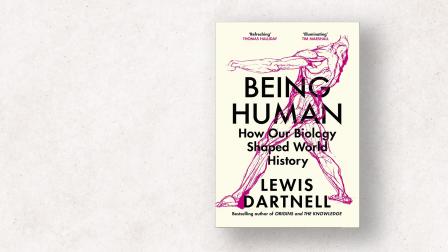لا يأتي الإنتاج المعرفي في حقل من الحقول إلا ضمن شروط محدّدة ينبغي أن تتوفّر في بيئة ثقافية ما. يسري ذلك على واقع علم الاجتماع في البلاد العربية عموماً، وفي تونس خاصة، حيث نلاحظ محدودية في الإنتاج المعرفي. ربما لهذا السبب، يجنح بعض الكتّاب والباحثين إلى تمرير آرائهم وتصوّراتهم عبر محامل أخرى مثل الأدب، والرواية تحديداً، مثلما هو الحال مع الكاتب التونسي نور الدين العلوي (1964). معه نقف على مفارقة تتمثّل في كون نتاجه الأدبي يفوق إنتاجه العلمي كباحث في علم الاجتماع، وهي وضعية لها دلالاتها التي تضيء الكثير من واقع هذا الحقل المعرفي.
يقول العلوي في حديثه إلى "العربي الجديد": "بدايةً، ليست المعرفة السوسيولوجية غريبة عن الكتابة الأدبية. الفكرة قادرة على تغيير شكلها لتصل إلى قارئ يُحسن التقاط الشذرات المعرفية دون لبوسها الأكاديمي المتعارف عليه. مثلاً حين نقرأ لعبد الرحمن منيف فإننا نعثر في خلفيات نصوصه الأدبية على قراءة سوسيولوجية عميقة للتغيّرات الثقافية والاجتماعية في مجتمعات الصحراء وهي تتحوّل إلى مجتمعات نفطية، وقس على ذلك أعمال نجيب محفوظ المتشبعّة بالفلسفة وبمعرفة دقيقة بالمجتمع الذي عبّرت عنه، وكذلك حنا مينه. أجد أن التكوين العلمي الذي حصّلته في اختصاص علم الاجتماع مع مجموع قراءاتي الأدبية والفكرية قد شكّل أرضية صلبة لنوع مخصوص من الكتابة أشتغل عليه: أبلور الفكرة بعلم الاجتماع وأخرجها في صياغة أدبية".
يضيف: "في نهاية الأمر، الخلفية السوسيولوجية ضرورية إلى حد كبير، فلا يتعلّق الأمر بمساري الشخصي أنا الذي يصنّف نصوصه ضمن الواقعية، والتي لا أتمثلها كحديث عن الواقع الاجتماعي بمعناه المتداول، فهذا الواقع يتضمّن بالنسبة إلي أيضاً أحلام الناس وخيباتهم وصراعاتهم المعلنة والخفية، وهي أمور تغيب لو قاربنا الواقع من زاوية البحث الاجتماعي وحده، وخاصة باعتماد المدرسة الفرنسية في علم الاجتماع المهيمنة على الجامعة التونسية فيما يتيح لها الأدب منافذ متنوّعة". يتابع قائلاً: "بالتالي لا أرى تناقضاً وإنما تكاملاً بين علم الاجتماع والأدب يساعد على الغوص في قضايا الناس، فكأنني أملك أداة التحليل وأضيف إليها أداة التعبير، فيكون هو مزجٌ بين العلم والأدب، ثم أترك للقارئ، ومن القرّاء نقّاد، أن يقيّم مدى إتقان هذه الرقصة بين حبلين".
يشير العلوي، هنا، إلى أن نصوصه شهدت مقروئية يعتبرها محترمةً إلى حد كبير، ولكن في المقابل لم تجد عناية من النقد الأكاديمي على رغم تراكم مؤلفاته على مدى عقدين، مشيراً إلى أن أهل الأدب يصنّفونه ضمن الباحثين في علم الاجتماع، بينما يصنّفه المشتغلون بعلم الاجتماع ضمن المشتغلين بالأدب، فلا هو من هؤلاء ولا من أولئك، بما يجعله يعيش "إقصاءً مزدوجاً". لعلّ هذه الوضعية تجد أسبابها في نصوصه، وهي التي تحمل شيئاً من الأدب وعلم الاجتماع، فهل يمكن تفكيكها دون مناهج هذين الحقلين مجتمعين؟ يجيب العلوي: "يأخذ الناقد عادة حريّته مع النص. لا يستطيع المؤلّف أن يكون متطلّباً مع الناقد فيُملي عليه قراءته لنصه الخاص، ولا ينتظر من الناقد أن يكون ملمّاً بعلم اجتماع ليعثر على علم الاجتماع في الرواية مثلما يعثر على الرواية في الرواية. إذا تحرّر الكاتب من موقف الناقد وكتب نصّه، فإن على الناقد أن يكون حرّاً إزاء النص الذي يقاربه، يتناوله كيف يشاء، ولكن لا توجد ضرورة لتصنيف الكاتب بطريقة وحيدة أعتبرها تقليدية ومحدودة الاطلاع".
وحول نظرته إلى موقعه في الساحة الأدبية التونسية خاصة والعربية عامة، يعتبر العلوي أنه "يجب أن ينخرط الكاتب في "لوبي" سياسي وأيديولوجي ليروَّج له ويرشّح للجوائز، أما الحفاظ على الاستقلال الفكري والسياسي فينتهي بالكاتب إلى النسيان في عالم قسّمته التيارات الأيديولوجية بينها واختارت فيه متاريسها وكتّابها وفنونها". يصنّف العلوي نفسه خارج هذه اللوبيات، لذلك لا يصل أدبه "إلا لقارئ يشبهني وهؤلاء لا سلطة لهم على الثقافة في بلدانهم".
 الأدب وعلم الاجتماع اللذان يجتمعان في مدوّنة العلوي كان يمكن أن يجتمعا في حقل علمي هو سوسيولوجيا الأدب، غير أنه على المستويين البحثي والتدريسي سنجد أنّ الكاتب التونسي قد انهمك في مشاغل أخرى (علم الاجتماع الثقافي، علم اجتماع السينما، سياسات الضمان الاجتماعي، السياسات العمومية، مناهج البحث الاجتماعي، الكيفية منها خاصة) وهو ما يجعلنا نتساءل عن هكذا خيارات.
الأدب وعلم الاجتماع اللذان يجتمعان في مدوّنة العلوي كان يمكن أن يجتمعا في حقل علمي هو سوسيولوجيا الأدب، غير أنه على المستويين البحثي والتدريسي سنجد أنّ الكاتب التونسي قد انهمك في مشاغل أخرى (علم الاجتماع الثقافي، علم اجتماع السينما، سياسات الضمان الاجتماعي، السياسات العمومية، مناهج البحث الاجتماعي، الكيفية منها خاصة) وهو ما يجعلنا نتساءل عن هكذا خيارات.
يقول: "في الحقيقة يعود ذلك إلى إكراهات يعرفها الباحث الشاب في بدايات مشواره الأكاديمي. أردت التخصّص في علم اجتماع السياسي وفي علم اجتماع الأدب، غير أنني وجدت صداً على مستوى التأطير، ثم حدث أن قبل أستاذ في علم اجتماع الحقوق الإشراف على بحوثي للدكتوراه فأنجزتُ أطروحتي حول إدارة الدولة لملف الضمانات الاجتماعية زمن الخوصصة، أو ما يُعرف بالإصلاح الهيكلي، أي أنني بشكل ما أُجبرتُ على الذهاب إلى ما هو تقني - معرفي، ثم وجدتني أمرّ على تخصّصات كثيرة أخرى ضمن المهام التدريسية. وبشكل عام، أقول إن الجامعة أجبرتني على التأقلم مع حاجتها، في الوقت الذي اخترت أن تكون فيه مساحة تطوّري الثقافي خارجها، أي في الرواية".
اللافت في تجربة العلوي أن أعماله الأدبية يمكن ان نستشف منها خيطاً ناظماً كما نراه لدى المشتغلين على مشاريع موسّعة في علم الاجتماع. كانت روايته الأولى بعنوان "ريح الأيام العادية" (1998)، وفيها اقترح شخصية يساري تائب انتهى به الأمر إلى شرطي. عن هذه الرواية يقول: "نشرها لي يساريون اعتبروا أنهم وجدوا فيها النقد الذي يريدون لتموقعات اليسار بعد 1981. إذن بدأتُ بنقد التموقعات الأيديولوجية التي تخون مبادئ الثورة والطبقة العاملة".
أمّا في روايته الثانية "مخلاة السراب"، فذهب إلى منطقة أخرى تماماً، بإضاءة واقع الريف. يقول: "خرجتُ من المدينة وجعلت من النص - هذه المرّة - نقداً لمنظومة القيم البدوية مثل الفروسية والشرف والمحافظة على الموروث والهوية. وقد جعلت بؤرة هذا النقد تشكيك جيل الشباب في قناعات جيل آبائهم". سيتخذ هذا النقد تركيبة أخرى في رواية "المستلبس" حيث قدّم شخصية "لا تستطيع لا الانتماء ولا الخيانة"، يشرح ذلك بالقول: "قدّمت بشكل ما أزمة الفرد في دولة الاستقلال التي يجسّدها أحمد العروس".
دخل العلوي بعد هذه الرواية في فترة من التوقف عن النشر ليعود في 2010 برواية "تفاصيل صغيرة" التي تبدو مثل حصيلة نقدية للصراعات داخل المدينة التونسية؛ "صراع قيم المدينة ومحافظتها في مواجهة الوافدين الجدد، والأجيال الجديدة، وبيّنتُ مقدار الهشاشة في جميع مواقف هؤلاء وهنا عملت على نقد النخبة الجديدة (نخبة المال والأعمال) ونخبة المدينة في حربها ضد كل تجديد ثقافي" كما يقول.
أما عن روايته "في بلاد الحد الأدنى"، فيقول: "انتقدت فيها فشل الدولة التونسية في تخريج جيل مؤمن بالقيم الوطنية والاجتماعية، وكنت وقتها أشير إلى أن انهيار المدرسة يعني انهيار الدولة، وما نعيشه اليوم هو نتيجة استمرار الدولة في تهميش المدرسة لتبدو مجرّد فضاء لارتزاق عدد من المعلمين". يضيف: "ناهضتُ تلك المقولة بأن المدرسة مجرّد مصعد اجتماعي لتدبير المهن، وطرحتها كفضاء لصناعة هويات الأمم، ورأيت أن انهيار المدرسة لا يعني فقط انهيار وسيلة الترقي الاجتماعي ولكن انهيار القدرة على إنتاج القيمة والمعنى والتي تجعل المنتمي إليها مؤمناً بأنه عنصر من مشروع أوسع وليس فقط مرشحاً إلى مهنة، علماً أن تدبّر المهنة دائماً ممكن من دون المرور من النظام التعليمي، وهكذا نقف على وضعية بأن التربية في تونس تنتج من يحملون شهادات ولا يُفلحون في شيء، إلا أن يكونوا موظفين صغارا يقدّمون هذه الخدمة أو تلك بدون إبداع ولا فهم".
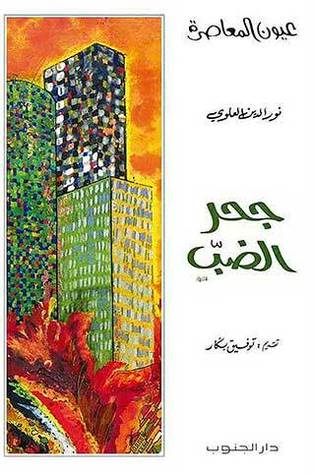 يكشف العلوي هنا أن الرواية الجديدة التي يشتغل عليها غير بعيدة عن آفاق "في بلاد الحد الأدنى" حيث إن موضوعها هو فقدان الخيال السياسي في مواقع القرار في تونس. يقول: "أنتقد ذلك الخطاب السياسي القائم على تدبير الخبز وليس تدبير الأحلام. لا يشتغل السياسيون على مشاريع تجعل الفرد ينتمي، بل هم يبحثون عن إدارة عيش الناس. أقول دائماً بأن مهمّة الرئيس ليست أن يعلّم الفلاح غرس الزيتون فهذا يتقنه الفلاح أكثر من الرئيس، يهمني أن يجعل الرئيس من غرس الزيتون فخراً لدى الفلاح، حين يضع الزيتون ضمن منظومة نجاح شامل". يتساءل هنا: "لكن لماذا لا يوجد هذا النوع من السياسيين؟ لأن منطق التفكير، منذ المدرسة، قد جعل الجميع رهين البحث عن الخبز، والخبز هو الحد الأدنى للمعيشة، ولذلك اعتبرتُ أننا نعيش في بلاد الحد الأدنى". سيكتمل هذا الطرح في رواية "الفقرة الحرام" حيث إن الحب فيها يبحث عن تجاوز الحسّي إلى المعنى فيفشل إذ يكون جمعهما مستحيلاً في بلاد تنتج الحس وتمجده دون أن تضعه في وعاء عاطفي أوسع من اللذة المباشرة.
يكشف العلوي هنا أن الرواية الجديدة التي يشتغل عليها غير بعيدة عن آفاق "في بلاد الحد الأدنى" حيث إن موضوعها هو فقدان الخيال السياسي في مواقع القرار في تونس. يقول: "أنتقد ذلك الخطاب السياسي القائم على تدبير الخبز وليس تدبير الأحلام. لا يشتغل السياسيون على مشاريع تجعل الفرد ينتمي، بل هم يبحثون عن إدارة عيش الناس. أقول دائماً بأن مهمّة الرئيس ليست أن يعلّم الفلاح غرس الزيتون فهذا يتقنه الفلاح أكثر من الرئيس، يهمني أن يجعل الرئيس من غرس الزيتون فخراً لدى الفلاح، حين يضع الزيتون ضمن منظومة نجاح شامل". يتساءل هنا: "لكن لماذا لا يوجد هذا النوع من السياسيين؟ لأن منطق التفكير، منذ المدرسة، قد جعل الجميع رهين البحث عن الخبز، والخبز هو الحد الأدنى للمعيشة، ولذلك اعتبرتُ أننا نعيش في بلاد الحد الأدنى". سيكتمل هذا الطرح في رواية "الفقرة الحرام" حيث إن الحب فيها يبحث عن تجاوز الحسّي إلى المعنى فيفشل إذ يكون جمعهما مستحيلاً في بلاد تنتج الحس وتمجده دون أن تضعه في وعاء عاطفي أوسع من اللذة المباشرة.
تحيلنا هذه الإضاءات حول عدد من أعمال العلوي إلى القول إنه حين تكون شروط البحث العلمي ضمن علم الاجتماع غير متوفرة يصبح الحقل الأدبي هو الملجأ المتاح، وهو رأي يوافقه العلوي، ويقول في هذا السياق: "من اليسير أن تلاحظ أن كثيراً مما كتبته أدباً كان يمكن أن يكون موضوع أبحاث علمية، غير أن إمكانيات موضوعية عدة لم تتوفر، منها الوقت والمادة وربما العمل الجماعي والذي أضع تحت سقفه أيضاً بيئة النشر. كلها عوامل جعلت من الرواية المَخرج الممكن والأنجع لأفكاري. حسبي أن كتاباتي قُرئت كروايات وتركت لدى القراء أسئلة سوسيولوجية".
سألنا العلوي إن كان الدرس الجامعي الذي يقدّمه يحاول الاستفادة من مرجعياته الأدبية، فيجيب: "لست ممن يملي درساً جاهزاً على طلبته، وأزعم أنني أحسن تنبيههم إلى الإشكاليات الكبرى. يبقى أن المصطلح العلمي لا يمر إلا من خلال لغة علمية، ينبغي دائماً معرفة المصطلحات داخل بيئتها من نظريات وأجهزة مفاهيمية، أما الإشكاليات فمن الممكن تمريرها بأساليب أخرى بحيث يمسك بها الطلبة بشكل أفضل".
هذا التفاعل مع الطلبة يمثل رافداً لتجربة العلوي، حيث يشير: "ما قلته بخصوص رؤيتي للمدرسة التونسية وواقعها كان نتاج ملاحظة في شريحة من الطلبة أجدهم يصلون إلى الجامعة وهم مُحبَطون، يسكنهم شعور بأن ما يفعلونه غير ذي جدوى. هنا أعرف أن المدرسة التي سبقتني لم تزرع فيهم سوى البحث عن المهنة وهم ينظرون إلى لحظة الاقتراب من التخرّج بخوف لأن آفاق المهنة بشروط الشهادة في علم الاجتماع قليلة. ما لا نقوله لهؤلاء هو أن التخرّج - بسبب المنطق المغلوط للمدرسة التونسية - ليس سوى نهاية وهم، فالمدرسة لا تستطيع أن تتدبّر لهم شيئاً. أبذل جهداً لطرد الإحباط ولا أفلح دائماً".
 يعود هنا العلوي بذاكرته، فيقول: "أقارن بين واقع التعليم اليوم وما عشته في سنوات تكويني، فأجد أنني كنت محظوظاً ليس لأن إمكانيات كثيرة توفرت لي، فهذا غير صحيح، ولكن لأنني مررت بكثير من المعلمين الذين غرسوا في نفسي الأحلام والأسئلة والإيمان بقضايا. ما أخشاه أن جيلي الذي يقترب اليوم من عقده السادس هو آخر جيل من الحالمين في تونس. فئات موسّعة من هذا الجيل كانت تناصر الثورة في 2011 لأن هؤلاء قد وجدوا فيها فرصة لاستئناف أحلام قبل أن يعود الجميع إلى إحباط جديد، لكن درس التاريخ يدعونا إلى أن نعيد إنتاج أحلامنا وتجديدها من حين إلى آخر وأن نمرّر ذلك إلى أجيال أخرى".
يعود هنا العلوي بذاكرته، فيقول: "أقارن بين واقع التعليم اليوم وما عشته في سنوات تكويني، فأجد أنني كنت محظوظاً ليس لأن إمكانيات كثيرة توفرت لي، فهذا غير صحيح، ولكن لأنني مررت بكثير من المعلمين الذين غرسوا في نفسي الأحلام والأسئلة والإيمان بقضايا. ما أخشاه أن جيلي الذي يقترب اليوم من عقده السادس هو آخر جيل من الحالمين في تونس. فئات موسّعة من هذا الجيل كانت تناصر الثورة في 2011 لأن هؤلاء قد وجدوا فيها فرصة لاستئناف أحلام قبل أن يعود الجميع إلى إحباط جديد، لكن درس التاريخ يدعونا إلى أن نعيد إنتاج أحلامنا وتجديدها من حين إلى آخر وأن نمرّر ذلك إلى أجيال أخرى".
بهذا الوضع الذي تعيشه الجامعة، كيف يمكنها إنتاج باحثين ومن وراء ذلك منجزات علمية؟ يقول الكاتب التونسي: "هنا نذهب إلى منطقة أبعد، وهي سياسة الدولة في البحث العلمي. ما الذي تخصّصه من إمكانيات؟ انظر مثلاً للزيادات في هذه الميزانية أو تلك، إنها تذهب منذ أن تُرصد إلى زيادات الرواتب وتأمين ضرورات من أعمال صيانة والحد الأدنى من البنى التحتية، فلا يبقى لتحريك دواليب البحث شيء كثير".
هذه العلاقة المأزومة بين الدولة وعلم الاجتماع تتناقض مع ما يتيحه هذا العلم من قراءات تساهم في بلورة سياسات ناجعة. يفسّر العلوي هذا التناقض بالقول: "ما يحدث في الغالب هو أن الدولة التونسية، والعربية بشكل عام، تقوم على توظيف العلماء وليس على توظيف العلم، ولنذكر سياسة زين العابدين بن علي في تفريغ الجامعة من الباحثين الأكفّاء باستقطابهم في مواقع الدولة، فخسرناهم كرجال علم وقلما استفدنا منهم كرجال سياسة". يضيف: "من جانب آخر لا نزال في منطق الدولة-النظام، وبهذا المنطق يكون أهل القانون هم المستقطَبين الأوائل في مواقع القرار قبل أهل المجالات العلمية الأخرى بل إن مجالاً مثل علم الاجتماع يراه بعضهم مفسداً لمسارات العمل لأنه يزرع بذرة النقد داخلها، بينما رجل القانون يكون عادة تقنيّ نصوص فيكون جاهزاً دائماً لصناعة حلول قانونية لمشاكل اجتماعية. وهذه الزاوية مهمة لنفهم بعض انتكاسات الثورة التونسية، فهي ثورة اجتماعية هبّت الدولة لعلاج مشاكلها بواسطة القانون وحده. فما الفرق بين الدستور القديم (1959) والدستور الجديد (2014)؟ أعتقد أننا لم نفعل أكثر من إعادة كتابة دستور قديم. رجال القانون فرضوا تصوّرهم عن حلول للثورة بالقانون لأنهم لا يتقنون غير هذا النوع من التصوّرات/ الحلول الجاهزة".
يعيد العلوي هذه النزعة إلى اللحظة التأسيسية لدولة الاستقلال في تونس، فيقول: "ألم يكن بورقيبة، الذي أراد احتكار لحظة التأسيس، رجل قانون؟ ثم أحاط نفسه برجال القانون في صياغة مؤسسات الدولة ولاحقاً في تصريف شؤونها. هناك طرفة كانت تروى في عقود سابقة تعبّر عن هذا التمشّي في بناء للدولة التونسية؛ لقد كان الذين يتنافسون على المناصب يحملون أكبر عدد من المجلات القانونية في محافظهم اليدوية، حتى حين كانت تمطر السماء يفتحون المحافظ لإيجاد نص قانوني يحميهم من الابتلال. هذا هو منطق الدولة عندنا، حتى مشاكل الطبيعة لو وجدوا لها نصوصاً لصاغوها وفرضوها".
بعيداً عن الدولة، كيف هي علاقة علم الاجتماع بالمجتمع؟ يقرّ العلوي هنا بأن "المجتمع التونسي - كنموذج يسري على مجمل البلاد العربية - لا يعرف بيئة البحث في علم الاجتماع ولا يصله منها شيء. إنها قطيعة كاملة ومحزنة. أصلاً، ترسّخ خلط بين الباحث في علم الاجتماع والمرشد الاجتماعي وهو عون اخترعته الدولة التونسية للإشراف على حسن تنفيذ سياساتها وخصوصاً سياسة التقليص من الإنجاب بتوزيع وسائل منع الحمل. إذن علم الاجتماع بشكل ما معرفةٌ مجهولة. الدولة اشتغلت - ولعلني أقول اجتهدت - من أجل جعل الباحثين مجهولين".
يضيف: "هذه مسألة لا تخص علم الاجتماع وحده، بل مختلف قطاعات المعرفة، فالطبيب الذي لا يعرف في علم الاجتماع وفي الفلسفة وفي الأدب، إنما هو تقنيّ علاج، تعطيه الأعراض فيعطيك أدويتها. لا يختلف الأمر مع نموذج رجل القانون الذي تحدثت عنه سابقاً، أحدهما لديه المجلات القانونية والثاني يفتح المجلات الطبية، وآخر يعود إلى مجلات اقتصادية، وجميعهم جزر معزولة لا يقدر طرف منهم على إدارة حوار مع الأطراف الأخرى. علماً أن هؤلاء هم من يشكلون أعمدة تسيير الدولة في تونس، وهكذا نرى انعكاس فشل الجامعة على الدولة بما يعني فشلها هي الأخرى".
 للعلوي مجال اشتغال آخر، وإن بقي في الظل بعض الشيء، وهو الترجمة حيث نقل إلى العربية مؤلفات لجان جاك روسو وتوكفيل، وآخر ما صدر له في هذا الصدد كتاب "اختلاق الآخر" (2015) للأنثروبولوجي التونسي المقيم في سويسرا منذر كيلاني. يقول العلوي: "فكّرتُ في الترجمة انطلاقاً من إعجابي بشخصية جان جاك روسو، العصامي، الفقير مادياً والغني معرفياً، والذي يخلق حالة من الاستغناء عن المجتمع ومنظومة المعرفة في زمنه، ومن هنا كان الأجرأ في القول بأن المعرفة لا تؤدي إلى الرقي الأخلاقي بل العكس أصح. كنت أطمح أن أنقل كامل مؤلفات روسو إلى العربية لولا أنني لم أجد مساعدة من الناشرين".
للعلوي مجال اشتغال آخر، وإن بقي في الظل بعض الشيء، وهو الترجمة حيث نقل إلى العربية مؤلفات لجان جاك روسو وتوكفيل، وآخر ما صدر له في هذا الصدد كتاب "اختلاق الآخر" (2015) للأنثروبولوجي التونسي المقيم في سويسرا منذر كيلاني. يقول العلوي: "فكّرتُ في الترجمة انطلاقاً من إعجابي بشخصية جان جاك روسو، العصامي، الفقير مادياً والغني معرفياً، والذي يخلق حالة من الاستغناء عن المجتمع ومنظومة المعرفة في زمنه، ومن هنا كان الأجرأ في القول بأن المعرفة لا تؤدي إلى الرقي الأخلاقي بل العكس أصح. كنت أطمح أن أنقل كامل مؤلفات روسو إلى العربية لولا أنني لم أجد مساعدة من الناشرين".
يضرب هنا العلوي مثلاً عن "إحباطات" التقدّم في مجال النشر، حيث جرى تقديم كتاب "رسالة في العلوم والفنون" في إحدى دورات معرض الكتاب ولم يدع كمترجم فضلاً على أنه لم ينل أي حق ولو رمزيا عن مجهوده في ترجمة أول نص لروسو.
وعن سؤال حول أولويات الترجمة إلى العربية، لو لم تكن مثل هذه العراقيل موجودة؟ يجيب العلوي: "أعتقد أننا نحتاج إلى استكمال نقل فكر النهضة الأوروبية إلى العربية. هناك ترجمات متشظية، مقسّطة، لا تفضي إلى بناء صورة شاملة. ما زلنا إلى اليوم مرتهنين إلى لغات أخرى لفهم هذه اللحظة التاريخية الفارقة. أن نقرأ النهضة الأوروبية بالفرنسية والإنكليزية يعني أن نسلّم بفرضيات هاتين الثقافتين على ما في العلاقة بيننا من توتر حضاري وتعال تجاهنا. أن نقرأ تراث النهضة الأوروبية بالعربية أعتقد أنه أمر جد مفيد وعامل لتحريك سواكن عدة".
يلفت هنا العلوي إلى أن "أحد أسباب تأخر ترجمة فكر النهضة يعود إلى الأكاديميين المتقنين للغات الأوروبية، فهؤلاء طالما اعتبروا تلك المدوّنة مثل رصيد تجاري، وأتاح لهم عدم الترجمة أن يبقوا وسيطاً بين ثقافتنا وفكر النهضة، حيث لا يخفى أنهم لو ترجم كل تراث النهضة سيفقدون دورهم كوسيط".