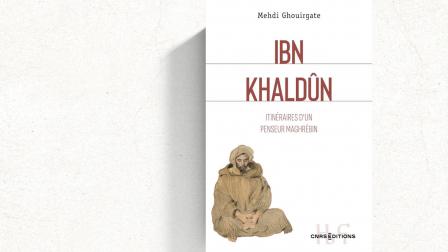يُفترض في الترجمة أن تعمل على إبراز شيء كان في أصله مُقتصِرا على لغة بعيْنها، وعلى ثقافتها وحدَها. لكنّ الإبراز يقتضي بالضرورة القيامَ بفعل لا يُمكن للترجمة أنْ تتحقَّق دونه؛ هو القراءة.
ولا يخفى أن الجاحظ لم يكن شاعرا، ولا مترجما، لكن لا أحد بِوُسعه أن يُنكِر تَميُّزَه ناقدا ومنظِّرا، أو أنْ يُجرِّده من امتلاكه ناصية السرد؛ في ما حكاه من أخبار ونوادر وغيرها. لقد قضى الجاحظ حياتَه يقرأ بشغف إلى أن قيل في حقه إنّ القراءة هي التي أسكتت نبضه، بانهيار الكتب عليه، ومع ذلك، فقد وصلتْنا أفكارُه متخطّيةً جدران الأزمنة والثقافات.
واشتُهِر عن بورخيس الشاعر والقاص الساحر والناقد البارع أنه كان أيضا مترجِما مرموقا، وأنه كان قبل ذلك كله قارئا نَهِما، اقترنَ اسمُه بالمكتبة، لدرجة أن هناك منْ عمَّده "بالقارئ الأخير" شأنه شأن الجاحظ.
وبلغ وَلَعُ بورخيس بالقراءة إلى أن غدا حسيرَ البصر، ثم فَقدَ تلك الحاسة بعد ذلك، لكنَّه وقتَها كان قد امتلأ قراءةً حتى قال عن نفسه "أنا الآن قارئُ صفحاتٍ ما عادتْ عينايَ تراها الآن". هل يعني هذا أن القراءة ليست حتما عُبورا بصريًّا على النصوص، وادعاءَ فهمِها؟
يبدو أن القراءة في جوهرها لقاءٌ بالعلامات، واجتهادٌ في فك شفراتها وإعادةِ تنظيمها ضمن عالم النص، الذي يُفكَّك ويُعاد تنظيمُه. ولا تتحقق القراءةُ الجيدة للنص إلا عبر الاقتراب منه كثيرا، والوقوف مليًّا عند كل كلمة فيه أو عبارة، وهي العملية التي تتميّز الترجمةُ بإنجازها بتفوق لافت، فتؤكِّد بذلك أنها تجربةُ قراءةٍ هي الأخرى.
وحريّ ألا يُفهمَ الاقتراب من النص بمعنى الالتصاق به؛ فآفة الاقتراب البصري تجعل الخطوط تتداخل فتتعذّر القراءة، وذلك ما يعرفه المترجمون الذين يُدركون أنه كلما كان الاقتراب من النص الأصل شديدا وحرفيا، كان الابتعاد عنه أشَدَّ، ويعرفون أيضا بأنهم أثناءَ اشتباكهم مع النص الأصْلِ يكونون بصدد بناء معنى للأخير، فتكُفُّ قراءتُهم للنص عن أن تكون مجرَّد فعل قراءة، بل تغدو صيغة للحياة وشكلا من أشكال الوجود، ويغدو المترجم قارئا بطلا يجترح للنص الأصل امتدادا في الحياة في فضاء ثان، ويضمن له حضورا في الثقافات الأخرى، ويفتحُه على اللانهائي، أي على التكاثر في لغات غريبة.
ومعلومٌ أن الناقد الأدبي يتميَّز بكونه قارئا مختلفا، يهتم بتحليل النص الأدبي وتقييمه، وبصياغة نص آخر يُعبّر عن موقف من العمل الأدبي الذي قرأه، بخلاف القارئ العادي الذي يظلّ غُفلا، ويصعب أنْ يُستدلّ على وجوده بشيء ملموس، في مُقابل القارئ-المترجم الذي يتركُ أثرا يدل عليه يُمثِّله النصّ المُتَرجَم.
لذلك استحقَّ المترجم أن يُمتدَح من قِبل الروائي أنطونيو مونيوث مولينا بكونه "القارئ الأعلى والقارئ الأكمل الذي ينتهي كاتبا كلمَةً كلمةً للكتابِ الذي يقرأ، فهو أو هي مَنْ يرصد الأخطاءَ والزَّلات، التي لم يرَها المؤلِّف ولم يُصحِّحها الناشرون، لأنه يجد نفسَه مجْبَرا على أن يقيسَ وزن كل كلمة ومعناها بارتياب أكبر من الروائي نفسِه".
يصير المترجم مُرسِلا ثانيا للنص بعد المؤلِّف مُرسِلِه الأوَّل، وقارئا فعليا للأصل، يساوقه حذو النعل بالنعل، أي بموازاته في سعي لإعادة إنتاجه وتمثيله، وأن يكونَ صوتا للمؤلف في اللغة المترجَم إليها، وصانعا لصورته فيها، ويحدث له، أحيانا، أنْ يتفوَّق بنصِّه الفرع على الأصل، نظرا لأنه يجتهد لكي يصير بدوره مقروءًا، لذلك فهو يبحث عن قارئه باختيار أجناس أدبية معينة وكُتَّاب مهمِّين.
ويمنح الأدبُ، من جهته، للمترجِم حضورا واسْمًا، ويُصيِّرُه بارزا ومرئيًّا، لأنه يقرأ النصَّ بصيغة مغايرة. لكن مهما كَدَّ المترجِم في التَّخفّي عبر اجتهاده في أنْ يكونَ شفيفا، فإن نصَّه الفرعَ يَكشف عن أنه صنيعةٌ مُعيَّنةٌ لقراءةٍ مختلفة.