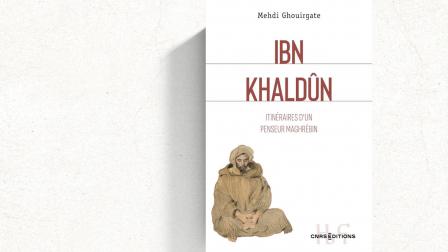فلسفة شوارعية؛ ذلك هو أصل الفلسفة مع سقراط، وهو ما سعى إليه الكاتب التونسي سليم دولة منذ كتاباته الأولى في ثمانينيات القرن الماضي. ورغم أنه انقطع عنها، على مستوى النشر على الأقل، مراكماً في الأثناء نشر المجموعات الشعرية، إلا أنها تظلّ دعوته الفكرية الأثيرة.
■ حين تنظر في مسارك، أي مؤثرات فكرية تعتبر أنها تركت بصماتها عليه؟
كلما فكرت في الأمر، يتبيّن لي أني أملك الكثير من الآباء؛ منهم من ينتمي إلى فضاء الشعر مثل المعرّي والشنفرى والمتنبي. ومنهم من ينتمي إلى الفضاء الفكري عامة، وأقصد طه حسين أول من جعلني أحب الفلسفة في كتابه "قادة الفكر" حين تحدّث عن الفلاسفة اليونانيين وعن "سقراط الشوارعي" تحديداً، ومنهم من ينتمي إلى التاريخ القديم كابن خلدون وتقي الدين المقريزي، ومنهم من ينتمي إلى الفلسفة المعاصرة كميشال فوكو؛ تلميذ الفيلسوف - الشاعر نيتشه.
ويعنيني الوقوف عند فوكو قليلاً، فقد شَكّل في حياتي الفكرية مُنعطفاً حاسماً، ويعود الفضل في ذلك لصاحب "الفلسفة الشريدة"، المفكر التونسي فتحي التريكي الذي كان من عرّفنا، نحن طلبة الفلسفة في الجامعة التونسية في سبعينيات القرن الماضي بكتابات فوكو، ولو لم تضِع مني عُروضي التي قدّمتها في الجامعة حول بعض أعماله، لكانت كتاباً من أول الكتب التي تهتم بصاحب "الكلمات والأشياء" في الثقافة العربية، غير أن حياتي تشتّتت في الوطن وجرّبت البطالة والتشرّد السكني، وزاد على ما بي تحرّش السلطة والتوعّك العاطفي.
في المحصلة، كان "تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي"، وأيضاً كتاب "المراقبة والمعاقبة"، قد حفزاني على أن أغيّر نظرتي للكتب بصفة عامة باعتبارها وثائق مهمة لإدراك تشكّل الخطابات وتقاطعها، مثل تقاطع الخطاب في مجال الفلاحة مع اللغة ومع القيم الجمالية، ومع تسمية المعادن والجواهر وغيرها، ومن وراء ذلك توجد علاقة تلازم بين المعرفة والسلطة، فكل معرفة مهما كانت بساطتها تشكل سلطة بمعنى مقدرة على التأثير.
هكذا تغيّرتْ، بعد التمرّس بأركيولوجيا فوكو وحفرياته المعرفية المرفودة بالنسابة (الجينيالوجيا النيتشوية) نظرتي للمحيطات المعرفية، فلم تعد المعرفة جُزراً منعزلة واكتشفت "المتشابك" و"المشتبك" والصريح والضمني، والصامت والصائب في الخطاب الواحد، وانتبهت إلى علاقة التلازم بين السلطة والمعرفة، ومن ثمّ تغيّرت مواقفي من الكتب القديمة والحديثة واستوت عندي من حيث الهاجس المعرفي الكتب "الصفراء" و"الحمراء"، وأصبحت أتصيّد تلك الكتب التي كنت أعتبرها في زمن التحصيل "تافهة" و"غير جديرة بالقراءة". كما صادف أن "الثورة الإيرانية'" كان لها أثرها في تونس نهاية السبعينيات، ومن ضمن أثرها تدفق الكتب "الغريبة" ونشر أمهات "المخطوطات الباطنية".
من كل ما تقدم نستنتج أن لكل كاتب أباً مُركّباً، وقد يكون ثمة أبٌ سرّي مُركّب في طية من طيات لا وعيه المعرفي والعاطفي، ولا تشي به الذات بسهولة كما شأني الشخصي مع فريدريك نيتشه أو جلال الدين الرومي، جنباً لجنب مع السّهروردي المقتول وعبد الجبار النفري. عموماً أنا لا أحب "الكاتب المبتور"، ذلك الذي يقيم في قطب واحد؛ شمالي أو جنوبي، عقلاني أو وجداني، فيكون كائناً "حانوتيّ" الذهن والعقل وفق المعجم النيتشوي. إذ تشكل "المعرفة العقلانية" مكوّناً واحداً من مكوّنات الذات الإنسانية، والاكتفاء بهذا المكوّن فقط يجعل الواحد من البشر يمر قُرب حياته، لا أن يحيا حياته، ولتكون حياته حيوات... من واجبه الجمالي أن يستحضر تناغمياً: المعرفة والعِرفان في آن واحد. شوق العقل للمعرفة واشتياق القلب للغائب الغامض.
من واجبه أن يتساءل: ما الحب؟ ما الموت انتحاراً؟ أو صبراً أو سُكراً؟ لماذا نحيا أصلاً؟ لماذا نموت؟ لماذا الملل؟ ما سرّ الألفة؟ كيف يأتي الشكّ؟ لماذا يأخذنا الاندهاش والانشداه أمام الغريب والعجيب؟ لماذا يعرف الإنسان الأشياء ولا يعرف نفسه؟ أحياناً تكون هذه الأسئلة هي ما يشدّ عمودنا الفقري ويحصّننا ضد الكسر والانكسار، فالدّمع والارتجاف والقشعريرة من المكوّنات السرّية للهويات الإنسية. طاف في خاطري الآن محيي الدين بن عربي وسورين كيركغارد وابن سبعين دفعةً واحدةً. يا "للأب المركّب" الذي لا يمكن إلا أن يكون أنثى على طريقته في الانبساط...
■ أن تكون إصداراتك الأخيرة شعرية أليس شكلاً من أشكال الصّراع مع هذا الأب المركَّب؟
أنا نفسي تساءلتُ كم من مرة لماذا لم أعد أرغب في نشر كتاباتي الفلسفية التي لم أكفّ عنها. قد يعود الأمر إلى محني الشخصية، فحينما أكتب الشعر فإني غير معنيٍّ أساساً بالتوجّه للعالم ولا للوطن، ولا للشأن العام مباشرة، وإنما أسعى إلى التداوي، وإذا صادف أن التقى الوجع الشخصي بالوجع العام فلا تكون تلك غايتي الأساسية. أنا مريض كما شأن كل "الموطونين" و"الموطونات"، المرضى والمريضات في الوطن بالوطن. في الشعر، ثمة موسيقى خاصة، حميمية، لحمية، خصوصية لا تدركها غير الذات الشاعرة. قد تبعدك الفلسفة عن حياتك بينما الشعر يرجعك إلى حياتك، وإن أنت تدرك أنك تمرُّ قربها أو حولها أو حيالها. ليس صدفة أن الزمن الذي نعيش يشهد عودة جميع المكبوتات متنكرة دفعة واحدة؛ الشعري والفلسفي والصوفي والسردي كما يشهد الإعلان عن موتها جميعها دفعة واحدة، مع أفول كل الهويات "الصلبة".
■ لو أنك فكّرت في إعادة طبع أعمالك التي صدرت في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، مثل "ما الفلسفة" و"الجراحات والمدارات" و"الثقافة والجنسوية الثقافية"، فهل ستعيد صياغتها أم ستترك النصوص كما كتبتها أول مرة؟
أنا الآن بصدد إعدادها في طبعات جديدة بمراجعة جذرية من حيث الأسلوب والتوثيق والصياغة، وتلافي الأخطاء المطبعية ما أمكن دون أن أحذف فكرة أو أتنازل عن موقف احتراماً للأمانة التاريخية. وقد أضيف لكتاب "الجراحات والمدارات" فصلاً يتعلق بـ"الجرح والمدار الأنثوي"، وملحقاً آخر بعنوان "مدارات حول كتاب الجراحات" يتضمّن النصوص التي كُتبت حول الكتاب بأقلام كل من الأعزاء محمد لطفي اليوسفي، وهاشم صالح، وفتحي المسكيني، الذي أنا مبتهج حقاً بنشاطه، ومختار الخلفاوي، ومحمد مومن.
■ هل من السهل الاشتغال بالفلسفة بعيداً عن الجامعة؟ ماذا ربحت من هذه الوضعية وماذا خسرت برأيك؟
إن التكوين الأكاديمي ضروري، وهو من أهم مهمات الجامعة ولكن ليس من مهمة الجامعة تكوين لا فلاسفة ولا شعراء ولا روائيين ولا مؤرخين، عليها فقط توفير الأدوات البيداغوجية التي من شأنها أن توقظك من "سباتك الدغمائي" كما يقول كانط.
أنا خرّيج الجامعة التونسية، وهو بَعد كل شيء، ورغم كل شيء، شرفٌ لي أني تخرجت منها، ولكني أيضاً طريدها السياسي، إذ مُنعت من مواصلة المرحلة الثالثة لا لاعتبارات علمية، بل لأمر بسيط هو أني لم أكن طالباً اجترارياً. كنت أُحرج أساتذتي كثيراً، وأكتشف وأكشف للطلبة عن المناهل التي ينهلون منها دروسهم سرياً ويخفونها عن الطلبة، ولم يسلم مني الفرنسيون من الأساتذة. لي تحية خاصة لروح أستاذة الفلسفة الراحلة فاطمة حداد، التي لولاها لطُردت من السنة الثانية من الجامعة، لروحها السلام ولروح سوزان باشلار لأنها أرادت أن توفر لي كل شروط الذهاب إلى فرنسا ومواصلتي الدراسة هناك، غير أن جيبي خانني وأنا لا أريد أن أعيش عالة على أحد. وكما تقول العرب: "من كثر حياؤه قلّ رزقه".
 باختصار، لم آسف على ما حدث لي في الجامعة التونسية، لكني مطمئن لما قمت به من تدريس في المدارس الثانوية، إذ اعتبرت نفسي مجرّد وسيط معرفيّ أمين بيني وبين مشاريع الطلبة، بل سعيت إلى تكوينهم لغوياً ومنهجياً ليكونوا حقاً طلبة يستأهلون الدخول إلى الجامعة، وذلك ما كان. كما أوصيتهم ألا يسلكوا الطريق الذي سلكت لئلا يحدث معهم ما حدث معي، وأخذت أذكرهم بعبارة رونيه ديكارت: "إني أتقدم بأقنعة"، وتلك لعلها التسمية الفلسفية للنفاق الأرستقراطي الفرنسي. قد تكون تونس قد ربحت، وأنا خسرتُ مسيرة جامعية، لكني اتجهت في مسالك أخرى، ولو توفّر لي الوقت لأنجزت المشروع الذي حلمت به؛ "فلسفة التدقيق والتحقيق" الذي استلهمته من تاريخ المدينة التي أنا منها وهي مدينة قفصة، وما كان قد نقش على أحد أبوابها إذ تقول المتون القديمة: "مدينة قفصة مدينة قديمة أزلية، وكان منقوشاً على أحد أبوابها كتابة من عمل الأُول تُرجمت وإذا هي: هذا بلد تدقيق وتحقيق". في ذهني، ليست أثينا أجدر من قفصة بالاستحضار الفلسفي - الحضاري. وإذا كان ليس للفلسفة من وطن فإن للفلاسفة أوطانهم، كما كنت أردّد هذه العبارة على الطلبة والطالبات.
باختصار، لم آسف على ما حدث لي في الجامعة التونسية، لكني مطمئن لما قمت به من تدريس في المدارس الثانوية، إذ اعتبرت نفسي مجرّد وسيط معرفيّ أمين بيني وبين مشاريع الطلبة، بل سعيت إلى تكوينهم لغوياً ومنهجياً ليكونوا حقاً طلبة يستأهلون الدخول إلى الجامعة، وذلك ما كان. كما أوصيتهم ألا يسلكوا الطريق الذي سلكت لئلا يحدث معهم ما حدث معي، وأخذت أذكرهم بعبارة رونيه ديكارت: "إني أتقدم بأقنعة"، وتلك لعلها التسمية الفلسفية للنفاق الأرستقراطي الفرنسي. قد تكون تونس قد ربحت، وأنا خسرتُ مسيرة جامعية، لكني اتجهت في مسالك أخرى، ولو توفّر لي الوقت لأنجزت المشروع الذي حلمت به؛ "فلسفة التدقيق والتحقيق" الذي استلهمته من تاريخ المدينة التي أنا منها وهي مدينة قفصة، وما كان قد نقش على أحد أبوابها إذ تقول المتون القديمة: "مدينة قفصة مدينة قديمة أزلية، وكان منقوشاً على أحد أبوابها كتابة من عمل الأُول تُرجمت وإذا هي: هذا بلد تدقيق وتحقيق". في ذهني، ليست أثينا أجدر من قفصة بالاستحضار الفلسفي - الحضاري. وإذا كان ليس للفلسفة من وطن فإن للفلاسفة أوطانهم، كما كنت أردّد هذه العبارة على الطلبة والطالبات.
ما يؤسفني هو أني أصبت كالكثيرين مثلي والكثيرات بما كنت قد أطلقت عليه "مرض التُّناس" (على وزن فعال)، والمتمثل في كوننا نطلق المشاريع والأفكار الكبرى، غير أن العوائق الموضوعية كما الذاتية تحول دوننا. الأهم عندي الآن إنما هو "سقرطة الفلسفة". يمكن اعتبار أن أفلاطون المريد الأمين لسقراط الحكيم هو من خلده ومن خانه أيضاً في نفس الآن. الاشتغال الفلسفي بالجامعة لا ينفي عنها "شوارعيّتها" الأكيدة. يوجد أكثر من مبرّر حضاري فعلي لسَقرطةِ الفلسفة كونياً.
■ ماذا تقرأ في السنوات الأخيرة؟
أتابع آخر ما يصدر ويقع بين يديّ، من الكتب والمجلات بالفرنسية والعربية من فلسفة ورواية واقتصاد وأنثروبولوجيا ولسانيات ومسرح. كما أني مولع بالمعاجم والمتون القديمة المحققة حديثاً، ويحدث أن أقرأ حول الموضة والإشهار، وغير ذلك. هذه الأيام، أعيد قراءة موسوعة "الفرج بعد الشدة" للتنوخي. أريد أن أكتب عن "سردياته في كتابة المحنة" لمتعتي الشخصية. وقرأت أخيراً آخر إصدار للمفكر الفرنسي الذي أحبّه شخصاً ونصاً؛ ميشال أونفري، بعنوان "الحكمة: العيش على حافة بركان"، وهو عمل أتمنى أن يجري تعريبه قريباً لتعميم الفائدة على الذين لا يحذقون اللغة الفرنسية. ومن قراءاتي القريبة الأخرى: "عزاءات الفلسفة: كيف تساعدنا الفلسفة في الحياة" (آلان دوبوتون، ترجمة يزن الحاج)، و"بطارنة الجريمة: المافيات الجديدة ضد الديمقراطية" لـ جون زيغلار، و"أسطورة الفحولة: شراك للجنسين" لأوليفيا غزاليي.
■ وهل تقرأ ما يصدره الباحثون التونسيون في الفلسفة؟
أقرأ للتونسيين والتونسيات لا في مجال الفلسفة وحدها لأن ثمة "أدباء فلاسفة" و"أديبات فيلسوفات"، وإن كانوا قلة مثل أم الزين بنشيخة وكمال الزغباني. ومن آخر ما قرأت كتاب "الزميلان الصغيران سارتر وآرون" لحسونة المصباحي، وكتاب "اللاعنف في النضال السياسي" لعواطف الزراد. أحبّ كثيراً أن أقرأ لصاحب كتابيْ "لماذا الفلسفة اليوم؟" و"قول الممكن فلسفياً"، صديقي مصطفى كمال فرحات، الذي يحلو لي أن أسمّيه "الفيلسوف الشهرزادي".
■ ضمن الراهن التونسي ومجمل البلاد العربية، ما الذي يمكن أن تقدّمه الكتابة الفكرية اليوم؟
لو سألتَ سياسياً فسوف يقول لك: "لا بد من إصلاح العقل السياسي". ولو سألت فلاحاً فسيدعو لإصلاح العقل الفلاحي، وسيقول التاجر بضرورة إصلاح العقل التجاري، أما اللغوي فيحدّثك عن إصلاح اللغة. وهكذا نرى أن كل "واحد" يريد أن يدير الإصلاح على مدار "المصلحة والمنفعة" المخصوصة التي تخصّه هو دون سواه. كل هذا لإعادة النظر فيه.
■ ألا تشعر أحياناً بأنه ليس هناك آذان صاغية للكتابات الفكرية؟
في كثير من الأحيان أردّد قول الشاعر الطّرماح: "لم أر كاليأس شافياً".
■ ما هي أهدافك القادمة في الفلسفة أو في الشعر؟ ما مستقبل مشروعك "فلسفة التحقيق والتدقيق"؟
أُعدّ للنشر ما تراكم لديّ من أوراق ومقالات وحوارات، وهو ما يستلزم فريق عمل بأكمله. لم يترك الأصدقاء والصديقات لي وقتاً لأرتّب فوضاي. والكل يتصوّر أنه الوحيد الذي يطلب مني هذه الخدمة أو تلك، زائد الاعتناء باليومي الذي يخصّني ويخصّ قططي من طبخ وتنظيف البيت، وتعهّد جاراتي الشجيرات والوردات الجميلات، إذ أعيش وحدي على طريقتي في عزلتي. الآن تذكّرت ما ذكره هيغل لطلبته: "كم من الطاقات الفكرية النبيلة صُرفت في اليومي فذوت.. وغابت".