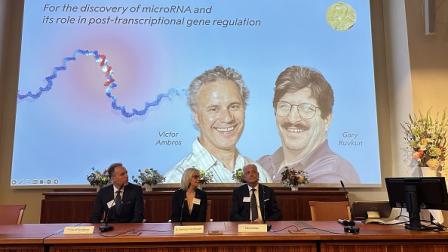خلال رحلته إلى الولايات المتحدة الأميركية، بعد انتخاب دونالد ترامب بيومين، قال الفيلسوف الفرنسي آلان باديو إنه بذل جهدًا لإعادة تركيب ترامب، لكي يتمكن من فهمه. في كتابه الأخير، الذي يحمل اسم الرئيس الأميركي "المخلوع" ديمقراطيًا، اقترح باديو عملية من ثلاث مراحل لإنجاز الأمر. المرحلة الأولى، فهم الوضع في العالم اليوم. المرحلة الثانية، تحديد أزمة ما يسمى "الديمقراطية" في السياسة، بوصفها شكلاً من أشكال قوة الدولة في العالم الغربي. أما المرحلة الثالثة، والأهم، فتقتضي الإجابة عن السؤال الأصعب دائمًا: ما العمل؟ الإجابة التي بين أيدينا حتى الآن هي كالتالي: "تويتر" حذف حساب دونالد ترامب إلى الأبد (في أسبوع واحد، حظرت مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى حسابات الرئيس لمدة غير محددة).
لن يبدو هذا كافيًا بالنسبة للمتضررين على أنواعهم. وعندما تقول وسائل الإعلام الغربية إن "الديمقراطية في خطر"، فهي غالبًا لا تقصد الديمقراطية بعينها، بل تقصد أن العمود الفقري للأنظمة الغربية في خطر. في حياتها، صعودًا ونزولًا، لم تكن الديمقراطية ذلك "الباراديغم" (النموذج) الذي يحكم العالم، أو يهدف إلى أن يكون حاكمًا، بل كانت أداة للتسيير في الداخل، والتشهير في الخارج. ولا يجب أن يقود هذا العرض، بأي شكل من الأشكال، إلى أي نقطة التقاء مع الاستبداد المنتشي بتمثيل جديد من تمثيلاته، من داخل النظام الديمقراطي نفسه، وهو دونالد ترامب. في الأصل، يمكن رصد نفور أميركي محلي من الميديا. وقد رجحت دراسات كثيرة أن يكون هذا النفور سببًا من أسباب وصول ترامب نفسه. في دراسات أخرى، باختلاف أهميتها، يتبين أن انتقاد وسائل الإعلام هي السمة الأكثر ظهورًا في تغريدات ترامب نفسه وبفارق واضح عن بقية المواضيع. حسب التعبير الأميركي، كان ترامب رجلًا يتحدث ويحب أن يسمع صوته بنفسه. ما يمكن إضافته، هو أنه كان يتحدث إلى أشخاص، يحبون أن يسمعوا أصواتهم بأنفسهم. يا لها من مصادفة غريبة، أن يحيل كل هذا إلى مصطلح "تغريد" بحد ذاته، في حالة تعمدنا سوء النية.
لوقت طويل، لم يكن النفور من "فوكس نيوز" بسبب التضليل الهائل خلال غزو العراق. وليس سبب ردة الفعل ضدّ "نيويورك تايمز" مساعدتها جورج بوش الابن في تمييع كل شيء، وإيهام الأميركيين بأن الخطر على البشرية ينبع من نهر الفرات. أما "بي بي سي" البريطانية التي تتصرف كما تتصرف معظم المحطات الغربية، كصانعة للحقيقة ومالكة لها، فتستمر بتجاهل دورها في دعم الاستيطان الصهيوني في فلسطين، كما يذكّرنا الفيلسوف الإيراني الأميركي حميد دباشي في إحدى مقالاته. ورغم ذلك، ليس هذا ما يجعل "الرأي العام" ينفر من الميديا، ويفضّل إيجاد منصاته مثل مواقع التواصل الاجتماعي. ما يجعل هذا "الرأي العام" يكتسب هذا النفور، من بين جملة مسببات أخرى، هو بالتحديد "الهوية الخاطئة".
رغم ذلك، لا تكفي الأحداث الأخيرة، من أرقام الانتخابات بين ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن، وصولًا إلى الهجوم على الكونغرس، لاستسهال التنظير عن "هشاشة" النظم الديمقراطية. كما أن استدعاء هذه الأحداث لردح نظريات عن احتمالات الانهيار يبدو تحليلًا طريفًا في أفضل الأحوال. ما يمكن الحديث عنه بالتحديد هو هذه "الهوية الخاطئة". لتفسير هذه الهوية، بأدوات معاصرة، يمكن افتراض فجوات كبيرة بين تشكّل الخطاب في فضاء عام افتراضي حيث يحدث التحريض، وبين تحول الخطاب إلى واقع على أبواب مجلس الشيوخ.
في مقاله الشهير عن الهوية الاجتماعية المنشور في منتصف السبعينيات، يحاول يورغن هابرماس تفكيك المجتمع الذي يعبّر عن نفسه بهوية أخرى غير هويته، وقد تكون محاولة مثل هذه هي الأنجح لقراءة مشهد "الصراع على الديمقراطية" في أميركا اليوم. كان هابرماس أول من أعاد استعمال مصطلح "هوية خاطئة"، حسب الأصل الهيغلي، للحديث عن المجتمعات التي تملك تصورات موهومة عن نفسها. وأخيرًا، بعد كل هذه السنوات، يبدو الحدث الأميركي مناسبًا لمعاينة التشظيات، وليس غريبًا أن يأتي هذا الحدث بعد سلسلة أحداث عنف مباشرة ضدّ الأميركيين من أصل أفريقي، والتضييق على المسلمين الأميركيين، وغيرها من منغصات الديمقراطية.
اتضح أن النفور من تداعيات "كامبريدج أناليتكا" واستخدام "تويتر" للتحريض لحصار الكابيتول هيل وغزو الكونغرس، يندرجان في هذا السياق الغربي – الغربي، أي محاسبة الإعلام عندما لا يمثّل مصلحة "السيستم"
بعد مرور الوقت، اتضح أن النفور من تداعيات "كامبريدج أناليتكا" واستخدام "تويتر" للتحريض لحصار الكابيتول هيل وغزو الكونغرس، يندرجان في هذا السياق الغربي – الغربي، أي محاسبة الإعلام عندما لا يمثّل مصلحة "السيستم" (النظام). فتويتر نفسه يستخدم للتحريض من الإسرائيليين، ومن أنصار بشار الأسد، ومن جميع ممن يسمون بالمتطرفين على أنواعهم. صحيح أن ترامب شخصية "عامة"، لكن جميع الموجودين على منصات التواصل الاجتماعي، هم شخصيات تكتسب صفة العمومية. حتى أن ترامب نفسه حرّض مرارًا. الفلسطينيون مثلًا، يذكرون تغريدته الشهيرة، في 14 أيار/ مايو، التي تقول: "في مثل هذا اليوم تحلّ الذكرى الأولى لافتتاح سفارة الولايات المتحدة في القدس، إسرائيل. سفارتنا الجميلة تمثّل تذكارًا يدعو للفخر، لعلاقتنا القوية مع إسرائيل، وبأهمية الوفاء بالوعد، والوقوف إلى جانب الحقيقة". هذا ليس تحريضًا على العنف، رغم أنه يعلن تباهيًا واضحًا بسلب المدينة والتاريخ، والتعامي عن التهجير الممنهج الذي يتعرض له شعب كامل. لكن "تويتر" لم يشعر بالحاجة إلى حظره آنذاك، وكان يعرف أن أحدًا لن يجبره على ذلك، لأنه (تويتر) يقدّم "هوية خاطئة" عن نفسه هو الآخر، كفضاء عام، وليس كأداة تسيطر عليها الرأسمالية والأيديولوجيا.
يجب إعادة تعريف الفضاء العام بمعنى أنه مكان التقاء العموم
رغم كل شيء، يجب إعادة تعريف الفضاء العام، بالمعنى الذي سيحيل دائمًا إلى صاحب الاجتهاد، أي يورغن هابرماس، بأنه المكان الذي ظهر متأخرًا. المكان الذي يلتقي فيه العموم. لطالما كان هذا المكان هو المقاهي وملاعب كرة القدم والساحات ووسائل النقل العام، وكل ما يمت إلى العمومية بصلة. ولكن على العالم أن يعترف في النهاية، بأن ثمة فضاء أكثر عمومية بدأ يتسع. ثمة فضاء رمزي بدأ يبدو وكأنه يلعب دورًا وسيطًا بين الدولة والمجتمع المدني. في هذا الفضاء يتاح للطبقات على أنواعها أنه تساجل الدولة في مسؤولياتها وسلوكها، وكل ما يتوجب عليها أن تفعله. وهذا، من وجهة نظر ليبرالية، يجبر الدولة بمراجعة أفعالها، وبالتالي فإن هذا الفضاء العام هو صوت هذا النقد. وهذا الفضاء ليس سائبًا، بل لديه قوانينه المحكومة بفعل تواصلي، يتدرج في المجتمع من مستويات صغيرة إلى مجالات منظمة ودقيقة. في هذا الفضاء، يحدث السجال حول المصلحة العامة، وتختار الجماعة/المجتمع قيمها. وإذا كان للفضاء العام تمثيلات جديدة تتمثل بالعالم الرقمي المفتوح، فهذا يعني أنه بدأ ينتج قيمه الجديدة، وأن هذه القيم تختلف بين الفضاءات العامة. بهذا المعنى، لا تعود الحالة الأميركية عصية على الفهم. بالنسبة للأميركيين، استوفى الفضاء العام الافتراضي هذه الشروط إلى حد كبير.
إلى ذلك، يبدو الاستسلام إلى هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي أشبه بعلاج الأوهام بالأوهام. ثمة إيحاء، شبه نهائي، بدأ يتبلور عند الرأي العام، مفاده أن ترامب خسر كل شيء بخسارة حسابه على "تويتر". يذكّر هذا بالحملات الطويلة خلال ولايته المبتورة، للبحث عن التدخل الروسي في نتائج الانتخابات، بعد رمي خصوصية المواطن العالمي الرقمي في البحر. يبدو الأمر، كما لو أن هناك من يطلب طي صفحة ترامب بكاملها، والاكتفاء بمشهد اهتزاز الديمقراطية عندما رفضها مناصروه بعنف، وبإغلاق حسابه على "تويتر". التنجيم ليس واردًا، وردة فعل "الاستابلشمنت" الأميركي ليست أمرًا يمكن تكهنه بسهولة، لكن يمكن الجزم بأن المساس بالنظام ممنوع، وأنّ هناك سقفاً للتعبير. بلغة هابرماس، يمكن النفاذ من هذا المأزق، والتأكيد على أن هذا السقف لا نهاية له، وهو المصلحة العامة، لكن شرط أن يكون سقفًا، على ألا تكون له نهاية. هذا في الغرب طبعًا، وضمن السياق الاستعماري الطويل. في حالات أخرى، يمكن أن يلتقي رئيس جمهورية الحريات الفرنسية مثلًا مع أكبر ديكتاتور عربي، وأن يكيل له المدائح، ثم يغرد عن اللقاء "المثمر" على منصات التواصل الاجتماعي، من دون أن يشعر أحد في العالم بعد ذلك أن "الديمقراطية في خطر"!