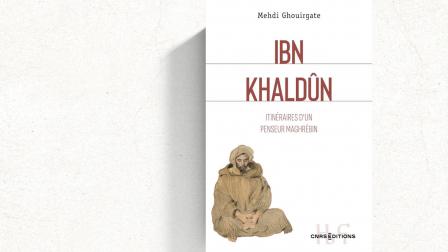إن كتابه هذا، بالنظر إلى المرحلة التاريخية التي زار فيها المغرب، يعتبر نظرة أخرى من الخارج، تسلط الضوء على شخوص المشهد السياسي في البلاد، الواقعة تحت انتدابين، الانتداب الإسباني في الشمال والجنوب، والانتداب الفرنسي في الوسط وباقي المناطق، مع حضور لعدد من الدول، مثل ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، والتي كانت كل واحدة من منها تحاول أن تضع لها موطئ قدم، لكن الحرب العالمية الثانية ستأتي بأوارها، وستقلب التحالفات والمعادلات، وتفتح الباب أمام المطالبة باستقلال البلاد.
وقد سجل الريحاني الكثير من الملاحظات، وأورد تفاصيل عن رحلته تلك، ورسم بورتريهات للشخوص الفاعلة في المشهد السياسي العام، بدءا من السلطة المركزية الممثلة في السلطان، مرورا بعدد من الوجوه التي كان لها أثرها الحاسم في تاريخ المغرب، ومنها على وجه التحديد عبد الكريم الخطابي وأحمد الريسوني، ووجوه أخرى من قناصل وممثلي البعثات الأجنبية وأحداث تاريخية ومعضلات اجتماعية كبيرة كان يعاني منها المغرب في تلك الفترة الدقيقة من تاريخه.
كما رسم تصورا جغرافيا لغنى المغرب ومدنه وسواحله ومواقعها الاستراتيجية والحربية، وتوقف عند العلاقة الحذرة مع الجارة إسبانيا، والتي بحسبه، بقدر ما هي علاقة تنافس وجوار، فإنها لا تخفي في صورتها العامة، عوامل الانفجار الكامنة، تجلت في العلاقة بين الأهالي والمستعمر الإسباني، وما فيها من جولات من الحروب والنزال، وكر وفر، ويقول إن المغاربة لن يركنوا إلى الاستسلام، وليس أمام المستعمر من خيار إلا الخروج.
من جانب آخر، يتوقف الريحاني عند البعد العربي الذي يحكم هذه المنطقة الجغرافية، وهو بعد واضح وجلي، بالرغم من حالة الانفصال الطويلة عن المشرق العربي، وحالة التجاهل من الجانبين، إلا أن ذلك لم ينه تلك الآصرة، بل قواها، وكان أن اشتعلت نار العروبة الخامدة في شريان المكون المغربي، خصوصا في فترة نضاله ضد الاستعمارين الإسباني والفرنسي.
وكما استوقفته طنجة وأصيلة وتطوان والعرائش، والقصر الكبير وشفشاون، فقد وقف مليا عند أهمية صخرة جبل طارق، تلك الصخرة التي تحمل اسم فاتح الأندلس القائد العربي طارق بن زياد. ولو أنها اليوم تحت الانتداب البريطاني، وتحاول إسبانيا استعادتها، فإنها ستبقى موشومة إلى الأبد بهذا الاسم الذي تحمله، اسم طارق بن زياد.
يكتب "من طنف غرفتي في فندق الصخرة، اللاصق ظهره بصدر الجبل، تحت هوله الخالد، أطللت على مشهد رائع من مشاهد الجمال الطبيعي، والعظمة الدولية، فمن الصنوبر الساحق النازعة أغصانه القديمة إلى الفوضى، إلى الأزاهير تحته في جنائن تتغنى بالوفر والنظام، إلى ساحات معبَّدة مسيَّجة، للعب الـ(تينس)، إلى طريق أسحم أملس بين البلدة وطرف البلدة وطرف الصخرة الشرقي، مظلَّل بالأشجار، مزدانة جوانبه بالأزاهير المتدلية من الجدران العالية؛ كل ذلك في انحدار غير انحدار الجبل إلى الفندق، في انحدار خفيف لطيف إلى البحر. وهناك على شاطئ البحر — الطبيعي والاصطناعي — في الأرض التي هي من الجبل والأرض الردم؛ مظهر من مظاهر العمران المدفعي، والعظمة الصناعية البحرية، المجردة كلها من جمال الطبيعة أو الفن.
هناك رمز العلم والقوة، هناك الأرصفة الممتدة إلى البحر، المكعبة والمثلثة فيه كأنها قضايا هندسية، وهناك أبراج وجسور وعمد من حديد للبرق والنور، ولرفع الأثقال ونقلها، وهناك المخازن والمستودعات والمرافئ والأحواض، والمكاتب والمختبرات، وهناك المصانع لترميم السفن، وللتنظيف والتجديد، وهناك المدرعات والغواصات والطرادات، وقد عادت من نزهة في البحر المتوسط، وهي متأهبة لدرء أخطار الحرب أو لخوض غمارها".
ويضيف في السياق نفسه: "هي بلدة قائمة بنفسها، وهي دوما في عمل، نار محركاتها لا تخمد، وأنوارها تصل الشفق بالفجر. هي صخرة الدولة البريطانية وعظمتها البحرية. هي هي جبل طارق! أما البلدة الأخرى، جبل طارق السوقة، فهي في الناحية الغربية، بني الباب الشرقي والمرفأ التجاري، وهي سوقها الكبير الأوحد، وجاداتها القصيرة الضيقة المتفرعة منه، لاصقة ها هنا بسفح الجبل، آوية هناك تحت صخوره، ومستلقية على الساحل وعلى الردم الذي أضافه إليه الإنكليز.
في هذه البقعة المنقبضة المنبسطة معا يقيم سبعة عشر ألفًا من السوقة، وفيهم التجار والصيارفة وأصحاب المقاهي والملاهي والحانات، من الأمم الغربية والشرقية، وهم يتراطنون بالإسبانية والإنكليزية، ولا يحسنون إحداها، لا يحسنون غير اللغة التي فيها رزق يومهم، ولذات الليالي. أهل جبل طارق ناس من جنس خاص بالصخرة، لا هم إسبان، ولا هم إنكليز. لا وطنية لهم تحملهم على المشاغب والفتن، ولا قومية تورثهم داءي الكد والاستعمار. هم بريئون من اليقظات القومية، والنهضات الوطنية؛ فلا يكلِّفون أنفسهم فوق طاقتها حق في عمل من أعمال الحياة، ولا يُكلَّفون إلا اليسير اليسير من الضرائب. يسميهم الإنكليز (عقارب الصخرة)، وإنهم في هذا الزمان المثقلة فيه كواهل الأمم بالضرائب، لأسعد (عقارب) الدنيا شرقًا وغربًا. فلا عجب إذا كانوا لا يكترثون — مثل صنف من الفلاسفة — بخزعبلات السياسة وأباطيل السيادة والمجد".
2- في ظل الصخرة
يحاول الريحاني تمثل هوية المكان، يكتب "إذا سألت أحدهم: أإسباني أنت؟ قال: لا. أإنكليزي أنت؟ أجاب: كلا. وما أنت؟ أنا جبل طارقي Gibraltarian. يقول هذا وهو لا يعلم لماذا سمي الجبل باسم طارق، ولا هو على شيء من مزايا طارق وجبله. فإن كنا نرثي لحال من لا وطن لهم ولا قومية، فالجبلطارقيون يرثون لحال من يجاهدون في سبيل الأوطان! ومن أين جاء الجبلطارقي؟ إنه ما جاء من مكان عبر البحر، فهل نشأ إذن في ظل هذه الصخرة مثل الحيوانات القديمة؟ أهو من نسل الرينو سود أو القردة المنقرضة؟
ليس في تاريخ الحيوان ما يثبت حقيقة هذا الافتراض أو ينفيها، أما تاريخ الإنسان — تاريخه الحديث — فهو ينير ويعين. هو يقول: إن الإسبان، سكان هذا الجبل قبل أن احتله الإنكليز في القرن الثامن عشر، هجروه بعد ذلك الاحتلال، ووقفوا في هجرتهم في منتصف ما يدعى الطريق، بينه وبني الجزيرة، فأسسوا لهم هناك البلدة التي تُدعى سان روكيه. ولا تزال سان روكيه، مثل شقيقتها (لالينا) lina La التي هي على الحدود الإنكليزية الإسبانية — وراء الصخرة — لا تزال مأوى لبعض أولئك النازحين من جبل طارق، وأولئك الذين لا ترغب فيهم السلطة المحلية، وأعني المتشردين والفقراء اللاحقين بهم. ولنذكر ها هنا أن السلطة الإنكليزية لا تريد أن يكثر سكان الصخرة، وهي حصنٌ وقاعدة بحرية فتعسر سبل العيش، بالأساليب القانونية والخفية، على أولئك الذين تتجهمهم الحياة فيتجهمونها، فيمسون على هامشها المتردم".
3- هويات أخرى
شكل جبل طارق ملتقى لعدد من البشر من هويات مختلفة، آخرهم الإيطاليون، الذين استقروا في الصخرة، يكتب الريحاني مؤكدا ذلك "كاد الكلام على سان روكيه ولالينا، ينسينا النصف الثاني من جواب التاريخ على سؤالنا. فبعد أن نزح الإسبان من جبل طارق حل محلهم قوم من الطليان، جاءوا على الأخص من جنوا، فرح الإنكليز بهم، فأقاموا في ظل الصخرة آمنين، وتاجروا مطمئنين، وتناسلوا فرحين، فكانوا الأجداد لسكان اليوم.
قلت إن في جبل طارق بلدتين: بلدة هؤلاء المتمردين من الطليان، وبلدة الدفاع البحري البريطاني، وليس بينهما خيط صلة من الحرير أو الشعر، بل إن البلدتين تختلفان في مزية أولية جوهرية، هي النطق الذي يميِّز الإنسان عن الحيوان؛ فالنطق كله، بعجره وبجره، عند الجبلطارقيين، والصمت كله، بذهبه ونحاسه، عند الجندية والبحرية ومن يلوذ بهما من الإنكليز، فإن كنت طالب علم، يهمك مقدار ما فيه من الصحة، فدونك الشارع الكبير الواحد تحدث التجار فيه وأصحاب الحانات، وإن كنت تبتغي التحقيق والتدقيق في ما تسمع، أو في موضوع يصله، ولو خيط من العنكبوت، بالصخرة الإمبراطورية وأسرارها العسكرية، فلا تدنو من أحد العاملين في تحصينها وإدارتها، فإنهم ومن يلوذ بهم لا يُحسنون على الإجمال غير لفظتين اثنتين: لا أعلم!".
4- حديث على مشارف الحرب
يسعى الريحاني إلى بناء علاقة مع المكان، لكنه يتأبّى عليه، هناك سوء فهم، أو حذر من الغريب، هذا ما يستشفه، وهو يحاول أن يبني جسرا تواصليا مع من التقاهم، وربما لأن الحديث ذاك كان يجري على مشارف الحرب العالمية الثانية، حيث لا شيء يسر، يكتب: "خرجت صباح يوم أمشي، ولا هدف غير ما تكشفه الطريق، فرأيت شجرة بين الأشجار لا أعرف اسمها، وأنا في هذه الحال على شيء من شذوذ الطبع فأغتاظ لجهلي، ولا أقف عند حد في فضولي.
قلت: أغتاظ ففرطت، فإن شجرة أجهل اسمها بين أشجار أعرفها حيثما أشاهدها، لشجرة مكربة مضنية. إنها لتضنيني. أقول ذلك بلساني الشرقي وإحساسي الموروث، وأما بلساني الغربي الذي تمرن على التدقيق في التعبير، وأحسن شيئًا منه، فأقول: إنها تفسد النزهة علي، ولست في ذلك مفرطا أو مفرّطا. وهاكها متحدية بين أشجار الصنوبر والسنديان. هي شبيهة بالسنديان وليست منه، وما هي كشجرة من عوامل الدفاع أو من أسرار الحصون والقلاع، فَلأسأل هذا الضابط يساعد في كشف غمي. صحبته واعتذرت، ثم سألته قائلا: ما اسم هذه الشجرة؟
فقال لي بلهجة مزنّقة: لا علم لي بالأشجار. ثم سألت رجلاً في ثوب مدني أنيق فتأسف وأجاب جواب الضابط! بعد ذلك بان لي في أعالي الجبل شيء غريب من البناء أنساني الشجرة، وكانت امرأة تدنو إذ ذاك مني، وفي وجهها الدميم نبأ التقوى والصلاح، فسألتها عن ذلك البناء، فأجابت بلهجة الضابط: لا أدري! ...
وهؤلاء الجنود الأربعة قد خرجوا على ما يظهر متنزهين، لا بد أن يكون واحد منهم، ذاك الرقيق الإهاب الضارب إلى الاصفرار، عالما بعلم النبات، فسألته عن اسم الشجرة، وكنت وا أسفاه مخطئًا في ظني. ثم سألت رفيقه عن اليوم الذي وصل فيه الأسطول إلى جبل طارق، فسمعت للمرة الرابعة أو الخامسة كلمة السر: لا أعلم. ولكن الحياة تأبى الإطلاق، وتنفر من القياس إنني لفي جبل الصمت والتكتم الواحد، فلا بد أن نلقى حتى في المقابر لسانًا ناطقًا، وها هو ذا تحت الشجرة التي كادت تفسد عليَّ نزهة ذلك الصباح.
كان الرجل يحرق بعض الأوراق، فسلمت، فرد السلام بإنكليزية سليمة، ولهجة كريمة، وقد أجاب عن سؤالي الأول جوابًا استبشرت به؛ فما هو من الجندية ولا من البحرية ولا ممن يلوذون بهما، إنما هو صاحب مغسل الجنود، وقد كان في تلك الساعة يلهو بحرق الجرائد التي تجيئه من بلاده. فقال وهو يزيد في نارها: تجيئنا جرائد لندن مرة واحدة في الأسبوع، ونحن نقنع، لا نريدها أكثر من مرة كل سبعة أيام. أهلنا هناك - في إنكلترا - يشقون كل يوم بذلك، بطيخة من الخوف والذعر: الحرب على الأبواب، تطبخها لهم الصحافة صباح مساء، ونحن ها هنا يجيئنا الخوف والذعر دفعةً واحدة مرة كل أسبوع، فهل تصلح هذه الجرائد لغير النار.
احرقها، وبرد نفسك! وعندما سألته عن اسم الشجرة أدهشني بثقافة عالية؛ فقد أعطاني الاسم وشفعه بنادرة تاريخية، ومثل لاتيني رواه باللغة الأصلية. عجيب أمر هؤلاء الإنكليز، فإنه يبلبل الباحثين الراغبين في الحقيقة نقدا وتقديرا. وقفت معجبًا بذلك الرجل كل الإعجاب، أمثقف في جامعة أكسفورد وصاحب مغسل للجنود بجبل طارق! سعدت دفعة واحدة بعلمه كما يشقى هو بجرائد لندن، وقانا الله الخير إذا طمى!".