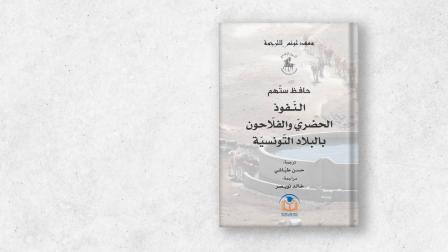الكتابة فعل تخثر دم الجروح التي تظهر فجأة على جلد الحياة، تستيقظ من النوم، فتنزف على غفلة من حلم. تصل متعباً من رحلة سفر قصيرة، فتنزف على أنين شجرة وحيدة في الطريق. تنتهي من موعد حب، فتنزف على وجع شهقة وداع لا لقاء بعده أبداً، فتكتب.
عندما تكتب، تستعيد أشلاءك المبعثرة على الجدران، تلتقط قلبك من على شفرة من شفرات المروحة المتدلية من السقف، أو قدمك التي التصقت في بوابة الخروج من البيت، أو عينك عن شرفة لا تفضي إلى لقاء ممكنٍ في هذه الحياة، تلملم نفسك، وتستعدُّ بها لتجربةٍ جديدةٍ من تجارب التشظي المتتابعة في الروح.
الكتابة فعل "طبطبة" على الأكتاف، تهديء الروع والروح، تمد عصىً من عصيّ الأنبياء: "هي عصاي أتوكّأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى" إليك، فتسير متمكناً، مستعداً عبر درب من دروب طويلة مظلمة وموحشة من حولك. تختارها بعناية الضرير المتشكك الذي لا يأمن للحقائق المختبئة أبداً.
إنها رحلة كشف وتعري تبدو ضرورية دوماً مع الذات، بالحد الأدنى لنا، نحن، سلالة أحلام القلق والخراب والحروب البعيدة.
مرة، وفي محاولة من محاولاتي الساذجة الكثيرة في الكتابة، كتبت نصاً أدبياً طويلاً، عني كالعادة، ختمته بعبارة: "ذاتك هاربة يا رجل". استوطنتني هذه الذات الهاربة، فصرت أحلم أنني أتجول في شارع من شوارع المدينة، وذاتي تنظر إليّ من مكان آخر، أمرُّ من أمام متجر لألعاب الأطفال، فأرى ذاتي، هذه الهاربة مني، تتفقد لعبة جميلة، وتسترق نظرة إليّ للحظة، ثم تكمل تحسسها وتفقدها لهذه اللعبة، وما إن أهم بإمساكها حتى تتحول إلى شخص آخر، لا دخل له بالموضوع إطلاقاً، فأستيقظ وأطرد هذا الحلم كمن يطرد ذبابة استلطفتْ فكرة الوقوف على إطار نظارته.
هذا تداخل مزعج، بين الفكرة والذات، حوّلت حياة "آرثر رامبو" قديماً إلى "فصل في الجحيم" في محاولة منه لإعادة موضعة الكتابة في الحياة، في حين يواصل معظمنا الانشغال بإعادة موضعة الحياة في الكتابة أو الأدب.
قبل أيام، أمضى طفلي الصغير دروسه الأولى في تعلم تفكيك وتركيب الكلمات الأساس في دروس القراءة والكتابة. تبدأ الدروس في تفكيك كلمات مثل بابا وماما. جرعات ذهنية متواصلة ذات لحن متمايز: "ب" و"ا"، "ب" و"ا" تصير بابا. "م" و"ا"، "م" و"ا"، تصير ماما، ثم تنسحب هذه القاعدة على كل الكلمات الممكنة، فتخضع كلمات مثل: سيارة وطائرة ومفاعل نووي لمنطق مماثل، فيبدأ من هنا مشواره مع الكتابة.
الكتابة تفكيك الممكن المعقد، لتكثيف البعيد البسيط، يبدأ الشعر مع الشاعر ممكناً بسيطاً ممسوكاً فيستحيل في نهايات التجربة نخبوياً، غامضاً وسوريالياً في أحيان كثيرة. وقد يحدث العكس.
في إجتياح لبنان 1982 أطلق الشاعر اللبناني "خليل حاوي" النار على نفسه. اجتاح الجيش الإسرائيلي بيروت، فلم يحتمل الأمر، وجده الناس منتحراً في منزله. عجزت اللغة أمام هزيمته الكبرى، فاختار طريق الموت بدلاً من معارج الشعر والكتابة، وكأن المعادلة كلها، يمكن تحويرها في مكان ما، ظرف زمان ما، إلى: إما أن نكتب، فنستعيد تلك القدرة المدهشة في تخثر الجراح السريع بفعل الهزائم الكبرى، أو يسقط القلم دفعة واحدة فترتج الأركان من وقع السقوط المهول، فلا يكون سوى الموت، خياراً جامحاً لا مناص منه.
والكتابة موسيقى بشكل ما؛ أضاف كل من "زرياب" و"فريد الأطرش" إضافات محسوسة على العود؛ زرياب الوتر الخامس والأطرش السادس، وهي إضافة هائلة على الجسم الفيزيائي لموسيقى العود.
ظهرت حاجة ما، جوع ما كبير في التأليف والتلحين لم تشبعها الأوتار الأربعة قبلها فصارت الأوتار ستة، لا يمكن فهم التحول المتسارع على أشكال كتابة الشعر ابتداءً من الشعر الجاهلي ومعلقاته، وانتهاءً بقصيدة النثر وما لحقها من إضافات تشد وترخي عود الكتابة، بمعزل عن الهوس الذي يقود إلى مواصلة ابتكار الأشكال المختلفة لها، ودون فهم كيف يمكن لها أن تكون: "فعل تخثر دم الجروح التي تظهر فجأة على وجه الحياة".
* كاتب من فلسطين