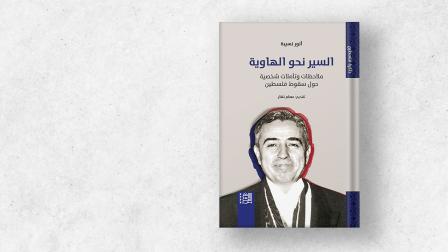الكتابة عن نصّ من نصوص الراحل محمد الأسعد (1944 - 2021) النقدية، هي إحالةٌ إلى كشفٍ جماليّ موازٍ. فالأسعد عندما يمارس النقد يستحضر عناصر شخصيّته الأدبية الحسّاسة؛ والحساسية التي نتوخّاها في توصيف اشتغالاته لا تعني تلك المُفتِّشة عن مواطن الجمال في النصوص التي تستقرئها فتقدّم وتؤخّر وتصنع الذائقة فقط، بل الحساسية المهمومة بتحقيق الإضافة بمعناها "التراسُلي" لو استخدمنا مصطلحه الذي نستعيره من عمله "حسرة الظلّ: تجارب في الشعرية النادرة والبساطة الجميلة"، والذي نعود إليه هُنا تحيّةً له في ذكرى رحيله الأُولى، تحيّةً لكاتب كان وسيبقى من طليعة كُتّاب القسم الثقافي في "العربي الجديد".
جهدَ الأسعد في نحت مفهوم "تراسُل الحواس"؛ بناءً على المدى الذي تبلغُه هذه الأخيرة من القدرة على إكساب اللغة وظيفةً غير معتادة. تظلُّ الوظيفة التواصلية قائمة بالطبع، إذ ليست الغاية من الأدب الذهاب إلى أُفق تجريديّ يتعذّر معه التواصل، على العكس، فالقبضُ المعقول على "أشدّ لوينات المشاعر رهافةً وجِدّة لا يتطلّب تعقيدات التجريد"، كما كان يرى. لكن في سياق النظر بنصوص الشعر العربي، المتأثّر بتراث كبير من القوالب والارتجال، امتدّت وصولاً إلى أعتى النماذج الحداثية تطرُّفاً وقطعاً مع الماضي، يصبحُ همُّ الناقد - حسب الأسعد - متمثِّلاً في إيجاد أسماء لعلاقاتنا وعواطفنا، في عصرٍ الكتابةُ فيه هي المركز، لا شفاهة الارتجال.
يحدّد الأسعد كتابَه بثلاثة أقسام، يقرأُ في كلٍّ منها تجربة شعرية بارزة، تحقِّق الشرط التراسُلي الذي هو محور بحثه؛ ولو أنّ العنوان يوحي بأنّ التجربة المَعنيّة هي تلك المُهمّش حضورُها في المتن الشعري: "حسرة الظلّ أنّه لا يقدر أن يصيرَ أكثر ظلّاً"، هكذا يكتب. وهذا فيه شيءٌ من الصّحة، فلا الحسرة ولا الظلّ يمكنُ أن يؤدّيا إشارةً أقوى من هذا الفهم المتوقَّع والمباشر، عدا ما في العنوان الفرعي من ثنائية تؤكّد وتَحكُم بالنُّدرة والبساطة. إلّا أنّ الإضافة في نقديّة الأسعد تتمثّل في الخلاصة التي قدّمها، واتّفاقها مع مقدّماته.
من شروط قصيدة النثر ألّا يتحوّل الشاعر إلى أداة بلهاء بيد النثر
التجربة الأولى، أو الحسرة الأولى، التي تُطالعنا في الكِتاب، هي تجربة الشاعر العراقي محمود البريكان (1931 - 2002) الذي يرى الأسعد أنّه "صانع الأسطورة". وهو يتحرّى تلك الأسطورية في عزلتها عن المشهد الثقافي في عراق الخمسينيات والستينيات، المتصادِي مع كلّ صيحات الحداثة الأدبية في عواصم مثل بيروت والقاهرة وحتّى بغداد، وما نالَ البَصرة - مدينة البريكان - من ذلك، بحكم كونها الميناء النفطي الذي يتلقّى أولى إشارات التواصل مع الخارج. إلّا أنّ البريكان ليس من البصرة التي هي، نوعاً ما، هامشُ بغداد - نقول نوعاً ما كي لا نخوض في حساسيات المُدن - بل هو ابن بلدة الزبير الواقعة تقريباً على حدود العراق والسعودية، بها يتكثّف صمتُ الصحراء وتماسُك التقليد بقيمِه العزيزة.
وبقدر ما انطبعت خصوصية المكان في شخص البريكان إلّا أنّ أولى صِداماته، كما يُنبّه الأسعد، جاءت مع نُخبة مثقّفة تسعى لتصفية آثار الشقاء والتعاسة من الأدب، ومن ثمّ مع تلك الخصوصية التقليدية والتساؤل عن أيّ تجاوز لها، وذلك في مقال له مغفل عن اسمه الصريح، عنونه بـ"تلك الأزمة" نشرته مجلّة "الآداب" في نيسان/ إبريل 1954: "أيّة حياة نضالية نقودها في هذه المرحلة التاريخية المليئة بمستوجبات النضال ضدّ العادات والتقاليد، ضدّ الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ضدّ القصور الثقافي الضارب أطنابه في عالمنا العربي؟ أيّة رسالة نحملها... ونفنى فيها لنجعل من حياتنا بكلّ دقائقها ومظاهرها شيئاً ذا معنى؟".
لكن كيف قبض الأسعد على تجلّيات تلك الروح الإنسانية في شعر البريكان؟ فالهامشية قد تبدّت من خلال هذه السيرة التي أوجزناها بزمانها ومكانها بوضوح، لا بل بنهايتها المأساوية أيضاً عندما قضى البريكان نحبَه على يد لصّ اقتحمَ بيته وانهالَ عليه بطعنات أردَته قتيلاً؛ فأين مكمنُ التراسُل في نصّه؟
يُقارب الأسعد إنسانية البريكان بمذهب الفيلسوف الروسي نيقولاي برديائيف (1874 - 1948) من حيث إنّه رفض أنّ الحقّ والعدالة يُقرّرهما الواقع الاجتماعي، بل هما في استقلال عن صراع البشر الطاحن الذي لا يفتُر، وهذا ما تجلّى في قصيدته "القوّة الطاردة": "ليس الحبّ مستحيلْ/ ولا الجمال خدعة، ولا ندى السحرْ/ خرافة/ لكن يفيضُ مرقص البشرْ/ بالعنف والعويلْ".
ليست غاية الأدب عنده الذهاب إلى تجريد يتعذّر معه التواصل
ليس هذا وحسب، بل إنّ الأسعد وجد أن المعرفة عند البريكان متعالية أيضاً مثل الحقّ تماماً، وليست هي الخبرة العقلية فقط، بل هي خبرة ذات مصادر لا صلة لها بالعقل تتدفّق وكأنّها حدسٌ صوفي قوامُه التجربة الحسية التي لا تبرّر نفسها منطقياً: "وحيداً أنتمي، حرّاً، إلى فكرةْ/ أرادت نحتها الموتى، ولم تُنحَت على صخرةْ/ إلى صوت النبوءات البدائي/ إلى الثورات قبل تجمّد الرؤيا/ إلى الحبّ السماوي الذي يرفض الدنيا/ إلى البرق الذي يكشفُ وجه الدّهرِ في لحظة".
في هذا السياق تأتي ترجمة البريكان لكتاب جلبرت هايت "جبروت العقل" (1954)، أو اهتمامه بمنحوتات السويسري جياكوميتي (1901 - 1966) والإنكليزي هنري مور (1898 - 1986)؛ هذه أشياء أقرب إلى اللغز من أن تكونَ مقولة منطقية. وككلّ الحالمين ذوي الحساسيات المرهفة الذين يلتقطون النبوءة ولا يقوون على الجأر بها، كان للواقع السياسي أثره على الشاعر بصعوده وأفوله، خاصّة مآلات ثورة (1958) التي أطاحت الحكم الملكي. ها هو يكتب: "أنا تخلّيتُ أمام الضباعْ/ والوحش، عن سهمي/ لا مجدَ للمجد، فخُذْ يا ضَياعْ/ حقيقتي واسمي".
ليس بعيداً عن البريكان بتراسله وحدوسه المتعالية، ينتقل الأسعد إلى عرض تجربته الثانية في كتابه، وهي تجربة الشاعر الياباني ماتسو باشو (1644 - 1694) الذي يُعدّ المثال الأوّل على قصيدة الهايكو. وانطلاقاً من سيرته حيثُ ينتمي إلى أسرة دون الطبقة الحاكمة، فإنّ طموحات الترقّي الاجتماعي التي اصطدمت بجدار الواقع، أثقلت روحه بكثير من الخيبة والقلق، الذي استحال في داخله إلى جملة من الأفكار والمبادئ المتمثّلة بإنكار الذات وترويضها، متأثّراً بالتاوية الصينية وبوذيّة الزن (التأمّل).
وعلى ما في هذه التيارات من تديُّن؛ إلّا أنّ القراءة الأدبية لنصوصها تشفّ عن نواة مفهوم "تراسُل الحواس" الذي يُوجزه الأسعد بمقولة لإليوت: "أن نشعر بفكرة كما نشعر بشذى وردة". لا يقول الهايكو كلّ شيء، إنّه وفق الأسعد: "القيمة اليابانية التي ترى الجمال في بدايات التفتُّح وأواخر الذبول، لا في الاكتمال الذي لا روعةَ فيه، وفي هذا تعبيرٌ عن نزعتين؛ الأولى إعطاءُ المُشاهد أو القارئ نصيبَه من المشاركة، والثانية البقاء على الحافة المنذِرة بكلّ الاحتمالات".
وفي هذا القسم من الكتاب يبدو فكرُ الأسعد سيّالاً متماهياً مع ما ينقد، يستلهمُ النص ويبني به، وكأنّه الانفتاح النقدي وقد تمكّن من ذاته، أو التراسُل وهو يمثّل نفسه دون الاستعانة بأيّة أصول. يكتب الأسعد: "حين يُقال عن شاعر إنّه كبير، قد يتبادر إلى الذهن أنّه أصبح فوق النقد، أو أنّه ـ بتعبير ساذج قرأناه صغاراً لعباس محمود العقّاد ـ 'يظلُّ جيّداً حتى في رديئه'، إلّا أنّ الأمر ليس كذلك بالنسبة للنقّاد اليابانيين، الذين رأوا في بعض قصائد باشو أنّها ترتكب جريمة أسوأ من الانتحال". فهذه قاعدة حسّية بسيطة من قواعد التراسل تمنعُ من ظهورها تعذّراتٌ منطقية مختلفة، إلّا أنّ الأسعد قبضها أو شعر بها كما يشعر بشذى الوردة.
ومن بين الشواهد اللافتة لباشو التي أوردها الأسعد، ومضةٌ تقاربُ ما استوقفَ الكاتب الراحل هادي العلوي ذات مرّة في كتابه "المستطرَف الصيني"، وهي ومضة معروفة بعنوان "حلم تشوانغ تزو": "هل أنا إمبراطور يحلم/ أنّه فراشة/ أم أنني فراشة تحلمُ/ أنّها إمبراطور؟". طبعاً قد يبدو الكلامُ ساذجاً هُنا ولا معنى له، فمن إحدى المآخذ على الهايكو أنّه ترتيب ضعيف للكلمات. ولكنّنا ونحن نقرأُ، توقُّفَ الأسعد عند هذه الكلمات، لا نستطيع تجاوُز الأمر من غير استحضار تجربة هادي العلوي في استقراء التراث الصوفي بأبعاده الكونية من نصوصٍ تنوسُ ما بين يقظة وحلم كهذا الحلم، وصولاً إلى مرويّات عبد القادر الجيلاني والنفّري. وكالعلوي تماماً، تأتي انسيابية نصّ الأسعد في انتقالها من البريكان إلى ماتسو باشو؛ لا تراتبية زمنية خطّية تحكمُ تتبّع النصوص، إنّما هو التذاهُن - أي التناص - وقد ألبسه هادي العلوي مفردةً صوفية من معجمه.
التجربة الثالثة في الكتاب تنقسمُ إلى ثلاثة تمثيلات، أو كما عنونها "دائرة شعرية في منتصف قرنٍ حائر"، وهي قراءة في شعر توفيق صايغ (1923 - 1971)، ومحمد الماغوط (1934 - 2006)، وأُنسي الحاج (1937 - 2014). ويرى الأسعد أنّ معنى الدائرة الشعرية عند هؤلاء الثلاثة يأتي من حيث أنّ "كلّ واحد منهم يجدُ معناه في إنجاز الآخر، وتحتفظ قصيدته بمعناها في إطار هذه الدائرة، وما إن نأخذها إلى دوائر أُخرى حتى تتنافر معها". ولو أنّ صايغ لم يقيّض له من وسائط الترويج كما الأخيرَين، حسب الأسعد.
أصدر صايغ في مسيرته الشعرية أعماله التالية: "ثلاثون قصيدة" (1954)، و"القصيدة ك" (1960)، و"معلّقة توفيق صايغ" (1963)، ثم أُلحقت بأعماله عام 1990 "صلاة جماعة ثمّ فرد: قصائد غير منشورة". ينطلق الأسعد في قراءة صايغ "أنّه لم يكن ذاهباً إلى صوغ معانٍ جديدة بقدر ما كانَ ذاهباً إلى تسمية مشاعر جديدة". أو من المقولة النقدية الطريفة لسعيد تقي الدين عن توفيق صايغ: "محو الباشوية في الأدب... وقرع الأجراس لقصائد توفيق صايغ... عندها ستبدأ معاييرنا بالتحسُّن".
الحكيم التاوي متفهّم ضعف البشر لا كاره لهم ولا متعال عليهم
يقف الأسعد عند قصيدتين، الأولى "بضعة أسئلة أطرحها على الكركدن"، فيها يبدو الشاعر أكثر وعياً بالتعامل مع الأسطورة، كما أنّها أسطورة عابرة للثقافات وتقوم على تعدّد صوتي (بوليفوني) بين وحيد القرن وهو يمثّل الصوت المثالي، إلى جانب صوت العذراء الدنيوي، وصوت السارد نفسه. وأهميتها عند الأسعد لا تأتي من تراجيديا المصير الذي لقيه وحيد القرن على يد الصيّادين، كما ذهب إلى ذلك الباحث عيسى بُلّاطه، بل من حيث "أن العذراء التي انتظرت كائناً من لحم ودمٍ تفاجأت بكائن من غيوم". أمّا القصيدة الثانية، "القصيدة ك"، فهي أسبق زمنياً على الأولى، وفيها تشكّلت الرؤيا البدائية عن أسطورة وحيد القرن: "وأُطاردُكِ إلى أن/ ينطلق السهمُ الكبير/ وأهوي وتهوين لاهثَين/ يجرّنا معاً صائدٌ/ أيدري؟ ليس يدري/ أيّ شيء يفعلُ بنا!". ومن تنبيهات الأسعد التي تردُ في سياق قراءته لهذه الثنائية بين الدنيوي والمثالي، أنّها ثنائيةُ تتامٍّ وليست تعالياً نيتشوياً، "فالحكيم التاوي هو المتفهّم ضعف البشر، لا الكاره لهم والمتعالي عليهم".
بالانتقال إلى الماغوط وتجربته، وما شجَر من آراء خلافية حولها، يعرضُ الأسعد بدايةً رأيين؛ الأوّل لنازك الملائكة (1923 - 2007) التي رأت في كتابها "قضايا الشعر المعاصر" (1962) أنّ شعر صاحب "حزن في ضوء القمر"، "خالٍ من أيّ أثرٍ للشعر"، والثاني لصبري حافظ الذي كتب في "مجلة الآداب" عن الماغوط "هذه القصيدة.. لا شعر ولا نثر".
الشاعر لا يعظُ ولا يصدرُ أحكاماً بل يركّز على التجربة
ويرى الأسعد في نقد الملائكة للماغوط فهماً مغلوطاً، لأنّ الأخير ـ كما صايغ بالضبط ـ لا يدعونا إلى فهم معنى بل إلى تلقّي شعور؛ "فالشاعر لا يعظُ ولا يعلّم ولا يصدرُ أحكاماً، بل يركّز جهده على تقديم تجربة". وهذا يتبيّن في قوله: "أيّها الربيع المُقبِلُ من عينيها/ أيّها الكناري المسافرُ في ضوء القمر/ خذني إليها/ قصيدةَ غرامٍ أو طعنة خنجر/ فأنا متشرّد وجريح/ أحبّ المطر وأنين الأمواج البعيدة". إلّا أنّ المفارقة التي خضع لها الماغوط، حسب الأسعد، هي الانتقال من "حزن في ضوء القمر" إلى "غرفة بملايين الجدران" و"الفرح ليس مهنتي"؛ انتقالٌ مثّل نسياناً لكونه شاعر البداهة، حيثُ الحواس هي مبدأ القصيدة، قبل أن يستنفد مخزونه من العفوية: "ولكنّني حزين/ لأنّ قصائدي غدت متشابهة/ وذات لحنٍ جريح لا يتبدّل".
ختام الدائرة الشعرية مع أنسي الحاج وتساؤله الشهير الذي قدّم به مجموعته "لن" (1960): "هل يمكنُ أن يخرجَ من النثر قصيدة؟". وبعيداً عن محاججة الحاج وانتظار جوابه بنعم، فإنّ الأسعد يرى أنّ البحث عن شروط لقصيدة النثر مهمّ "حتّى لا يتحوّل الشاعر أداة بلهاء بيد النثر، ولا يصير النثر أداة طيّعة بيد الشاعر"، وهذه الشروط عثر عليها روّاد القصيدة، ومن ضمنهم الحاج، في كتاب الفرنسية سوزان برنار: "قصيدة النثر من بودلير إلى أيّامنا" (1959)، وهي أن تكون موجزة، ومتوهّجة، ومجّانية.
ولمّا كانت الصفة الأخيرة هي الأكثر إشكالية، فالخلاف إن كان المعنى المقصود هو تجريد الشعر من الأغراض السياسية والاجتماعية، أم أنّ المجّانية تعني اللاهدفية، حيثُ تأخذ القصيدة حضوراً كما اللوحة يعلو على الزمان. لكنّ سوء الفهم والميل إليه بدافع الخروج من سجن التقاليد هو ما جعل تعبير صاحب "لن" يتشظّى، وفقاً للأسعد، و"يتساقط قبل أن يصل إلى بوابة أي معنى"، ومثل هذا قوله: "جاءتِ الصورة؟ لماذا تتأخّر! كلّا لم تجئ. لم تجئ؟ وَغد. الشتم مقفلٌ وعليّ اليباب. الضباب. الذباب. العذاب! أين؟ وراء. في الوراء. في وراء".
نظرَ الأسعد إلى السريالية العربية بوصفها تشوّشاً منقولاً عن طبعة غربية، وهذه الأخيرة منبتّة بدورها عن أصولها الشرقية كما قدمتها فلسفة التاو الصينية وبوذيّة الزن. ويذهب أيضاً إلى أنّ مفهوم "ما فوق الواقع" مصدرُه الوعي المتجاوز، وهو يتأتّى من إلغاء مناهج الفكر المنطقي المعتاد: "افعل بلا فعل وستنجز كلّ شيء"؛ هذا هو مبدأ الرؤيا عند المتصوّفة، ولكن بسبب "سوء الترجمة، ولسبب آخر يتعلّقُ بنزعة الغربي في التنكّر لكلّ نبعٍ وردَه، قدّمت السريالية الغربية نفسها كـ'كشفٍ أصيلٍ' للأذهان العربية" يكتب الأسعد؛ وبهذا، فقد "زجّوا اللغة العربية في لعبة المصادفة الطريفة التي مارستها الدادئية".
بمقولةٍ أخيرة، تَرَسّم الأسعد في كتابه خطّة تتحاشى تمجيد الرمزية، بل اعتبرها جزءاً من القوالب المنطقية والعقلانية، أمّا أمثلته التي اختارها، فقد جاءت شديدة المعاصرة، واستعانته بالهايكو كنموذج لا تُعَدّ قفزة فوق الموضوع، وفقاً لمذهبه. من جهة أُخرى، لم يبحث عن اجتراح نظريٍّ جديد، كوْنَ تيار الفهم الشعوري الذي رافعَ عنه في كتابه هذا، يؤمن أنّ الحكي بحدّ ذاته ليس شرطاً للحكاية حتى تُشهَر، إنّما هي ـ كما يقول المتصوّفة ـ تُذاق ولا تُحكى. كذلك هو الشعر والنقد.