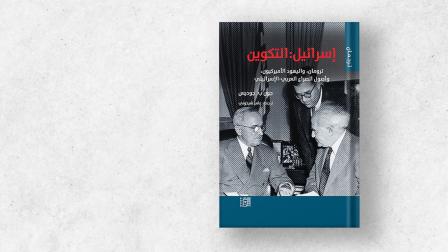في السابع والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، عقَد أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت (تمرُّ اليوم، الرابع من آب/ أغسطس، الذكرى الثالثة على وقوع هذه الكارثة التي ألمّت بلبنان كلِّه، لا العاصمة وحسب)، مؤتمراً في "نادي الصحافة" ببيروت، تحت شعار "من أجل العدالة والمحاسبة.. مستمرّون"، أعلنوا فيه عن برنامج تحرُّكهم في هذه الذكرى، انطلاقاً من أمام فوج الإطفاء، وصولاً إلى تمثال المُغترِب، قبالة ما تبقّى من أهراءات المرفأ، مُؤكِّدِين أنّ هذا اليوم ليس للعطلة، بل للحِداد الوطني.
نترسّم مع هذه الخريطة المُصغَّرة، التي حدّدها الأهالي، الكارثةَ في معالمِها وآثارها المُباشرة، مع إدراكٍ مُسبَق أنّها أبعد من تلك الحدود بكثير، سواء على المستوى الجغرافي أو النفسي. وهُنا نجدُنا نعود ثلاثة أعوام إلى الوراء، حين كانت المدينة - ونحن معها - تغرق في الإغلاقات وموجات الحظر نتيجة تفشّي وباء كورونا أوّلاً؛ وبعد أن طوَّق أربابُ المصارف وحُماتُهم من الأحزاب السياسية، ثانياً، انتفاضةَ 17 تشرين الأوّل الشعبيّة، والتي كانت قد انطلقت عام 2019. وبهذين العامِلَين وحدهما - ما كانا ليحتاجا عاملاً ثالثاً، كالانفجار الهائل الذي أزهق من الأرواح ما أزهق - كانت الحال الاقتصادية والاجتماعية عموماً، ومن ضمنها الفنّية والثقافية، قد بدأت بالتردّي في سنواتٍ متُسارعات، اصطَلَح بعضُ إعلامِ "بلاد الأًرْز"، على تسميتها بـ"الانهيار".
ولا شكّ في أنّه بعد هذه الأعوام الثلاثة، لم يبقَ الوضعُ على ما هو عليه، فالأوبئة قد انحسرت نسبيّاً، وعادت بيروت لتلتقط بعضاً من أنفاسها، وإنْ ما زال حزب المصارف (أُعلِن تنحّي رئيسه، عن حاكمية "مصرف لبنان"، أثناء كتابة هذه السطور)، يُنغّص على الكثير من اللبنانيّين حيواتهم، التي خلّصوها من بين فكّي الموت...
اكتفاء بجزئيات المشهد لأنّ الحدث أكبر من أن يُمثَّل
إلى هذه الحيوات المُرمَّمة التفتَ بعضُ الفنّانين من مسرحيّين وتشكيليّين وكُتّاب وغيرهم، طيلة الفترة الماضية، في محاولةٍ منهم لتمثيل هذا الواقع بأعمالهم، مع الإدراك أنّ هذه الأخيرة قد تُقصِّر عن مدى التمثيل وعموميّته أحياناً. بل إنّ حِسّاً سليماً يستطيعُ أن يُميّز بين ما هو صادقٌ منها بالفعل، وجَدِّي في مقاربته للواقع، وبين ما يستثمر بفاجعة إنسانية، في بلدٍ لا تخلُو طقوسُه الثقافية من تقاليد الاستثمار واحترافِه، على تعدُّد مُستوياته.
اضطرابُ ما بعد الصدمة، هو ما يؤسّس عليه المسرحي والتشكيلي أدهم الدمشقي عملَه المُعنون بـ"حديقة غودو"، الذي يُعرَض هذه الأيام، على خشبة "المونو". تستعيد المسرحيّة أجواء "عبيط" و"عصفور"، وهُما المعرضان التشكيليان اللذان كان الدمشقي قد وقّعهما العام الماضي، بحضُورٍ قويّ للطبيعة وحيواناتها، وبالأخصّ "غودو"، وهو كلب الفنّان الذي كان يَصحَبُه في نُزهة حين وقع الانفجار، ولتتحوّل بعدها حديقتُه إلى أثَرٍ مُدمَّر.
ينطلق الدمشقي في المسرحية، التي تضمّ فنّانين وفنّانات، منهم: ضنا مخايل، ويارا عماشة، وألكسندر معوشي وآخرون، من حالته النفسية بُعيد الانفجار؛ تجربةٌ ينقلها إلى الخشبة مستعيناً بقصّة حبّ مُوازية للحدث الأساسي، لا تلبث أن تتلاعب بها علاقاتُ القوّة بين الشريكَين، كما يستحضر فيها أيضاً، شيئاً من الفانتازيا (تكفي هذه الشراكة المعقودة، في الكتابة والتمثيل، مع "غودو") التي تُحرِّرنا، ولو قليلاً، من واقعٍ قاسٍ.
ليس بعيداً عن هذه الحديقة النفسية المُخرَّبة، تلتقط عدسة المُصوِّر ماتيو كرم، في معرضه "تجاهُل" (افتُتح أمس الخميس في "دار المُصوَّر"، ويتواصل حتى الحادي عشر من آب/ أغسطس الجاري)، أنقاضاً مكوَّمة: من سيارات وواجهاتِ مَحالّ، إلى أرصفة وشوارع وبيوت، كانت ذات لحظة تعجُّ بالحياة، قبل أن يُحوِّلها عَصْفُ الانفجار إلى رُكام. توثيقٌ بالأبيض والأسود، من تسعَ عشْرة صورة، يُعيدنا إلى شبَحية المشهد العام الذي كانت تعيشه بيروت، قبل ثلاث سنوات، حيث السكون المُريب لا يُنبِئ بأقلّ من كارثة تُغيّر وجه بلدٍ بأسره.
وإذا كان الدمشقي يبني في مسرحيته على حالة فردية، فإنّ في صُوَر كرم ملامح لبُعدٍ جَمعي مشحون بالجنائزية. مع ذلك فإنّ جوهر المادّة المُقدَّمة، في كِلا العمَلين، لا يبرح ما هو تجريبي. وهنا نعودُ لنتساءل، بشكلٍ عام، وبِغضِّ النظر عن المِثالين السابقين: إذا ما كانت المأساة عامة ومُجمَعا عليها، فلماذا كلُّ هذه المُؤاثرة في التوجُّه إلى مُعالجات تجزيئية، والإلحاح على سرد التجارب الشخصية - على أهمّيتها - واختزال المشهد من خلالها؟ هذا ولم نقُل شيئاً عن مشاريع (بربوزلات) الجمعيات الفنّية وصناديق الدعم المُرتبطة بموضوع انفجار المرفأ، والتي لم تشُذَّ عن سرديّة مُكرَّسة ذات مُفردات منسوخة عن بعضها البعض، مثل "الأنا"، و"الضحية"، و"التجربة الشخصية".
نعود إلى المسرح مع "أمتطي غيمة" هذه المرّة، والتي وقّعها المُخرِج ربيع مروّة السبت الماضي، في "بيت الفنّان" بحمّانا. أُنتِج العملُ منذ عشر سنوات تقريباً، ولا علاقة مباشرة له بالانفجار، بل بشيءٍ يُشبهه، هو أصلُه أو ربّما "جذرُه العميق"، أي: الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990)؛ حيث يتناول اغتيال المُفكِّر حسين مروّة، في 17 شباط/ فبراير 1987، وقصة ياسر (حفيده) ذي السبعة عشر عاماً، الذي ما إنْ سمع بالخبر حتى خرج ليتأكّد، ليُعاجِلَه القنّاص بطلقة في الرأس، فتناثرت لغتُه وذاكرته معاً.
استعاداتٌ من ذاكرة المدينة مُضمّنة بإشارات سياسية
يُحاول ربيع (وهو شقيق ياسر)، عرْضَ القصّة من خلال العودة إلى الشرائط التي سجَّلها أخوه كنوع من العلاج. تُعيدنا هذه المحاولة الإنقاذية الفنّية بين الشقيقَين إلى الواقع، فنفكّر بأهالي ضحايا انفجار المرفأ اليوم (على مختلف جنسياتهم: لبنانيّين وسوريّين ومصرييّن وفلسطينيّين وبنغلاديشيّين وفيلبينيّين وإثيوبيّين وسواهُم)، بالإضافة إلى المُصابين منهم (حسب التقديرات يفوق عددُهم ستّة آلاف مُصاب)، أولئك الذين ما زالوا يُلملمون - كياسر تماماً - شظايا ذاكرتهم ولغتهم، في غُرف العمليات، ورحلات العلاج المريرة.
هذا بعضٌ من حال المشهد الثقافي اللبناني إذاً - ولا يُمكن الادّعاء أنّه كلّه طبعاً - فمِن حرائق وانفجارات بصيغة الجَمع، كان آخرُها الحريق الذي ألمّ بمسرح "دوّار الشمس"، في السادس من تموز/ يوليو الماضي، إلى وجهٍ آخَر منها، بصيغة المُفرد، وهنا لا بدّ أن نلفت إلى "مهرجان ميزان السينمائي"، المُخصَّص للأفلام الوثائقية والدرامية التي تتطرَّق للاغتيال السياسي، والذي عُقِدت دورتُه الأولى، مؤخَّراً، في "مركز مينا للصورة"، أي ليس بعيداً عن مسرح الكارثة الأُولى، ولا عن خريطة تحرُّك الأهالي اليوم، ولا كذلك عن وجوه الضحايا المرسومة على جدران وسط المدينة، تُحدِّق بأعينها البريئة في ميزان العدالة المُنتظَرة.