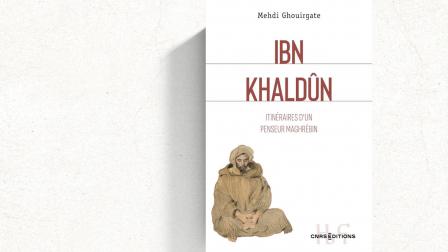- تتبع الرواية رحلة أرملة تسعى لتنظيف سمعة زوجها الراحل، مستكشفة التحولات الطبقية والسياسية، وتسلط الضوء على الفساد، الخيانة، واستغلال القضايا النسوية والحقوقية لمصالح شخصية.
- تُبرز التباين بين الماضي النضالي والحاضر المتحول، مع نقد للمرحلة التاريخية التي تُعيد تشكيل الهويات والولاءات في العالم العربي، مُشيرةً إلى دور الثقافة والمؤسسات الثقافية في تعزيز هذه التحولات.
على غير عادة الروايات، يَفتتح الكاتب الأردنيّ خالد سامح إصداره الروائي الجديد "بازار الفريسة"، (الثاني بعد روايته "الهامش"، وعدّة مجموعات قصصيّة) برسالة، تبدو عاديّة، ومفهومة، ومقبولة ضمن الأعراف الدبلوماسيّة المعمول بها في كلّ أنحاء العالَم، مُوجَّهة من مساعد وزير الخارجيّة الأميركيّ لشؤون الشرق الأوسط إلى سفير بلاده في العاصمة الأردنيّة عمّان.
لكنّ القارئ، وهو يمرّ سريعًا على هذه الرسالة، ويتعجَّب من كونها مدخلًا لرواية، يضع قدمَه مباشرة في حقل الألغام، ويتورّط، من الصفحة الأُولى، فيما أدّى إلى منع توزيع الرواية (صدرت عن "المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر" في 184 صفحة) في بلد كاتبها من دون إخطاره رسميًّا بكتاب رسميّ يُشبه تلك الرسالة، فـ السّرد الروائيّ، وهو يستلهم ويتخيّل، إنّما ينهل من واقع غير مُعلن لكنّه حقيقيّ، ومعروف، ومؤلِم؛ وبقدر ما تستند الحكاية على أحداث عاديّة ويوميّة وطبيعيّة في صيرورات السياسة في المنطقة العربيّة، يكتشف القارئ كم هي مُذلَّة ومؤلمة هذه العاديّة، وهذا الاعتياد، وإلى أيّ حدّ تمّ تطبيعها، واستفحلت، ليُصبح التعامل معها ومع نتائجها ومفاعيلها صعبًا ومعقّدًا.
حبكةٌ تنهَلُ من واقع غير مُعلَن لكنّه حقيقيّ ومُؤلِم
في الرسالة/ المُفتَتح، تُوجِّه الخارجيّة الأميركيّة سفيرها في عمّان إلى ضرورة فَتْح قنوات التواصل مع سياسيّين وصحافيّين، ورموز من القوى السياسيّة التي أفرزها حدثان مركزيّان في تاريخ البلاد: فكّ الارتباط مع الضفّة الغربيّة عام 1988، وهبّة نيسان الشعبيّة عام 1989 التي عالجتها السلطة سريعًا بإلغاء الأحكام العُرفيّة التي استمرّت عقودًا، ورفع الحظر عن الأحزاب، والدعوة إلى انتخابات برلمانيّة.
هي ضربة ذكيّة مُكثّفة من الكاتب، تلحقها ضرباتٌ أُخرى على شكل رسائل أُخرى تُفتتح بها كلّ الفصول التالية، لترسم خريطة طريق اختراق مجتمعاتنا، وشراء مثقّفينا، وإخضاع سياسيّينا؛ خريطة مسار القوّة الناعمة، ومدّ أذرُع الهيمنة الخارجيّة من خلال مؤسسات الدراسات و"المنظمات غير الحكوميّة" والتمويل المرتبط بالسفارات الأجنبيّة والمانحين، وبتسهيلات مباشرة من المجموعات الحاكمة التي تعرف عن مثل هذه المسارب، وتعتبرها نوعًا من الوصل المستمرّ بمراكز القوى، وبابًا خلفيًّا للتواصل معها وتلمّس مطالبها، بل إنّها - في أحيانٍ كثيرة - تنخرط هي نفسها في إنشاء مثل هذه المؤسسات المتموّلة للحصول على هذا التمويل، ورفد جيوبها به.
هكذا، تتحوّل رواية بسيطة الحبكة، تُلاحق من خلالها أرملةٌ سيرة زوجها الرّاحل القياديّ (سابقًا) في الثورة الفلسطينيّة، والمستقرّ (لاحقًا) في مركز دراسات بعمّان، إلى رحلة عامّة في الزواريب الخلفيّة للتبعيّة والخيانة والعمالة والفساد، ورحلة موازية خاصّة في كيفيّة تجاهل مثل هذه المنغّصات للاستمرار بالتنعّم بما أنتجته من ثروة وجاهٍ ومكانة، عبر رحلة صعود طبقيّ تكون (في المحصّلة النهائيّة) هي الغرض الرئيسيّ لنضالٍ يتمحور حول الذات لا حول القضيّة، مرسوم المسار سلفًا، ليمرّ عبر اتفاقيّات ومعاهدات سلام، يكون النضال السابق مُمهّدًا لها، والتنازل اللاحق نتيجة منطقيّة تتورّط أطرافه فيها وتدافع عنه بالأنياب والأسنان والجرائم.
شريحة مُنتفعة استعاضت عن "شقاء" الثورة برخاء الثروة
رحلة الأرملة (هالة، كاتبة ومخرجة مسرحيّة لبنانيّة، ورئيسة لمنظّمة نسويّة) وهي تنبش في سيرة زوجها (رشيد، كاتب ومالك مركز دراسات وأبحاث، ومناضل سابق نافذ في الثورة الفلسطينيّة) هي رحلة انتهازيّة وأنانيّة أساسًا، فالإشاعات التي بدأت تتناثر عن رشيد بعد موته كدّرت عيشها ونالت من سُمعتها ونغّصت عليها نعيم الاستفادة من الأموال والأملاك التي تركها لها، بعد أن مرّت، بمعيّته، من الشّقاء إلى الرّخاء من دون أن تسأل أو تتساءل، فهي تعيش الدّور أيضًا من خلال ترؤُّسها لجمعيّة تُعنى بحقوق المرأة، مُموَّلة بدورها من السّفارات إيّاها التي تموّل مركز أبحاث زوجها، تفتتح المؤتمرات عن "المرأة صانعة القرار" (نتذكر هنا صانعات القرار من نوع مادلين أولبرايت وكوندوليزا رايس وأمثالهنّ ممنّ شارَكن في صُنع قرارات مثل قصف ملجأ العامريّة وغزو العراق وتجويع نسائه وتمويتهنَّ بالحصار والأمراض، ودعم "إسرائيل" وإبادتها للفلسطينيّين، نساءً وأطفالًا ورجالًا)، والمشكلة عندها لا تتعلّق بتاريخ زوجها المشبوه، بل بأثر الفضيحة المتصاعدة عنه على حياتها المُرفَّهة.
تبرع الرواية في تصوير هذه الطبقة المناضلة (من أجل نفسها) والمتحوّلة طبقيًّا وسياسيًّا، والتي نُعاينها يوميًّا ونعرفها من قُرب، مثلما تبرع في تشريحها وهي تعود إلى الأصل الذي تخلّت عنه وباعته، من أجل معرفة نفسها، ومعرفة الحقيقة؛ فالمنبت هو المكان الذي ستتوجّه إليه هالة لتسأل عن الشُّبهات، وتحاول (من خلاله) أن تُنظِّف سُمعة زوجها، ثم سمعتها. لعبة الاستعانة بالمنبت/ الأصل، الماضي النضالي الوطنيّ للفاسد، لتنظيف سمعته، والتدليل على استمراريّةٍ ما مُشتقَّة منه للتعمية على القطع والتحوُّل، بل الانقلاب الحاضر، هي لُعبة ذكيّة أحسنَ الكاتب استغلالها واستعمالها والإشارة إليها في سياق عمله الروائيّ، وأحسن استخدامها لإظهار التبايُنات بين ما كان، وما هو كائن الآن؛ وسيشعر القارئ بنوع من الدّراية والمعرفة بمثل هذا النوع من الأشخاص والمآلات، وهو ما يحسب للرواية التي اختارت الاشتباك مع المعاصر، الآني، بدلًا من الشكل الرائج الآن من الكتابة الروائية، الذي يختار التاريخيّ للهروب من الاصطدام المباشر مع الحاضر، ومن ثم مع السّلطة، والإبقاء الدائم على فرص نيل حظوتها وجوائزها.
لعبٌ على إظهار التبايُنات بين ما كان، وما هو كائن الآن
تدخل "بازار الفريسة"، باعتبارها معرضًا كاشفًا للتحوّلات، إلى مآلات الجيل الثاني من هذه المجموعة المتحوّلة، فهُم جيل مُنبَتٌّ مقطوع الصلة إلّا بذواتهم ورغباتهم، يبحثون عن الملذّات الشخصيّة، ويغرقون في عدميّة ذاتيّة، فأحد أبناء رشيد وهالة مُدمن مخدّرات، والثاني (الأنجح) مُقيمٌ في دبيّ (بالتأكيد)، يُخطّط للزواج من مديرته الإنكليزيّة الأكبر منه في العمل لحيازة جنسيّتها، ولا يبدو مُهتمًّا لمصير أخيه أو أمّه أو الشبهات التي تُحيط بسيرة والده.
ولا تغفل الرواية، التي تقع أحداثُها في عمّان، عن مكانة هذه الأخيرة مقرًّا، ومستقرًّا، وموقعًا خلفيًّا، ينسحب إليه الثوريّون القدامى، وأبناؤهم، وزوجاتُهم، الذين صاروا (بحكم مواقعهم الجديدة) متعاونون مع عدوّهم السّابق، واتّخاذهم من أحيائها الرّاقية منازل وقصورًا ومقرّات للبزنس والتمويل، بعد أن كانت - في يوم صار بعيدًا - مقرًّا لتنظيماتهم الثوريّة؛ مثلما لا تغفل عن مصير الثوريّين الأنقياء الذين صاروا أشخاصًا هامشيّين منسيّين مُخلِصين لفَقرهم ونقائهم، وتُعرِّج على المؤسسات الثقافية التي هي - في حقيقتها - امتدادٌ للسّلطة، وذراعٌ من أذرُعها، تحتفي - بصورة أرتب وأكثر أناقة - بالمشبُوهين والمُحيطين بهم، مُسبِغة عليهم هالات إضافيّة كاذبة من الأهمّية والضرورة.
في جملة مركزية من جُمل الرواية، ثبَّتها الكاتب على غلافها الخلفيّ، يتساءل رشيد، وهو ينتقل من منزل إلى آخر أيّام الثورة، حاملًا معه خريطة فلسطين، "مُبروَظة" في إطار ذهبي، أهداه إيّاها أحد أقاربه: "ياااه، لمتى رح نبقى حاشرين فلسطين بخريطة، نحملها معنا، نصلبها على كلّ الجدران؟". تُحيل هذه الجملة مباشرة إلى مشهد شبيه في سياق الثورة الفلسطينيّة وتحوّلاتها اللاحقة، مشهد بوسترات الشهداء، الفقراء، الأنقياء، الأطهار، المُعلّقة على الجدران، مقابل الصورة التذكارية لقائد الثورة، مُصافحًا أحد جلّادي شعبه، في البيت الأبيض، مصافحةٌ سيذهب ثمنها المزيد والمزيد من أبناء شعبه الفقراء، والمزيد من أراضي وطنه، مثلما تُحيل إلى هواية رشيد بعد أن صار وتصوَّر: جمْعُ التحف والتماثيل والأنتيكات التي يتصالح هو مع تناقضات ما ترمز إليه تلك التحف، مثلما تصالح مع تناقضاته.
"بازار الفريسة" إذًا هي نوع من الإدانة الخافتة، لكنّها الماحقة والكاشفة، لمرحلة تاريخيّة أثبتت مآلاتها، وبالدليل التاريخيّ، أنها كانت مسارًا ليس بريئًا نحو التدمير الذاتيّ، والإثراء الشخصيّ، والسّلطة، فلا عجب إذًا أن يقوم "مَن على رأسه بطحة"، وفي هذه الأيام خاصة التي تتعرّض فيها غزّة لمجزرة رهيبة، بمنع الرواية التي ستدفعهم إلى التّحسيس عليها.
* كاتب من الأردن