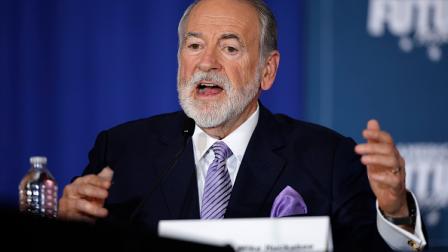ستشهد قرية بانمونجوم الحدودية، المنقسمة لشطرين بين الكوريتين، اليوم الجمعة، لقاءً تاريخياً، هو الثالث من نوعه بين زعيمي الشطرين، بعد قمتين سابقتين عامي 2000 (رئيس كوريا الجنوبية كيم داي ـ جونغ وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ ـ إيل) و2007 (رئيس كوريا الجنوبية روه مو ـ هيون وكيم جونغ ـ إيل). لقاء يفترض أن يحمل تحديات أكثر ثقة من أجل تحقيق الوحدة الكورية. وحدة من المفترض أن تتخطى أكثر التوقعات سلبية، وتعيد إلى الأنظار الوحدة التي حصلت بين ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية عام 1990. كما يأتي الحديث عن الوحدة في شبه الجزيرة الكورية، في خضمّ الكلام عن انشقاق دول وولادة دويلات في العالم، خصوصاً في الشرق الأوسط.
أهمية اللقاء المرتقب أنه يأتي بعد 68 عاماً على حرب السنوات الثلاث (1950 ـ 1953)، فبين هذين العامين، تمّ تحديد التقسيم بين الكوريتين، على خلفية اتفاقٍ بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة. شبه الجزيرة الكورية كانت محتلة لفترة طويلة من اليابان، وحين خسرت اليابان الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945)، ورث الأميركيون والسوفييت شبه الجزيرة الكورية، وعلى خط العرض 38، تم توزيع مناطق النفوذ. الأمر الذي لم يرضِ الشمال، فسعى للوحدة عسكرياً، غير أنه فشل بذلك، خصوصاً بعد إنزال أنتشون الذي قاده الجنرال الأميركي دوغلاس ماك آرثر، والذي وضع حداً للهجمات الخاطفة للجيش الكوري الشمالي، وفكّ الضغط عن سيول، عاصمة كوريا الجنوبية.
عليه، وبعد إنهاك المتقاتلين، أُعيد العمل بخط العرض 38 الفاصل بين البلدين، فانصرفت كوريا الشمالية إلى عزلتها وتمجيد الزعيم بشكل إلهي، وانفصلت عن الاتحاد السوفييتي معلنة الولاء للصين، خصوصاً أن جوزف ستالين، الزعيم السوفييتي الذي دعمها في حربها ضد كوريا الجنوبية، كان قد توفي، والصين كانت "عملاقا يولد". الخيار الكوري الشمالي، قابله خيار كوري جنوبي، باستمرار الاعتماد على الأميركيين، خصوصاً على صعيدي الأمن والاقتصاد. أسفرت هذه الحرب عن تأكيد الدور الأميركي في كوريا الجنوبية واليابان عسكرياً، وتراجع القوة السوفييتية إلى ما خلف كوريا الشمالية، وبدء العصر الصيني اقتصادياً، وتراجع النفوذ الياباني بشكل هائل. الخمسينات والستينات شكّلتا انعكاساً فاضحاً للتفاوت الاقتصادي بين الكوريتين، فكوريا الجنوبية بدأت وضع نفسها كقوة من بين ما أُطلق عليه تسمية "النمور الآسيوية"، وكوريا الشمالية باتت تعيش على الحدّ الأدنى من الاقتصاد. وهو ما استمرّ إلى السنوات الأخيرة. سيول باتت ركناً اقتصادياً هائلاً، وبيونغ يانغ تحوّلت إلى مكان فقير للغاية مرفقة بعقوبات اقتصادية أممية على برامجها الصاروخية والنووية فضلاً عن المجاعة التي ضربتها مرات عدة.
طيلة مرحلة ما بعد الحرب الأهلية الكورية، أي منذ 28 يوليو/تموز عام 1953 وحتى 21 ديسمبر/كانون الأول 2017، تمّ تسجيل 76 حادثاً بين البلدين، كغارات خاطفة، حالات فرار لجنود كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية، واختراقات تجسسية وصدامات بحرية وبرية، انتهت في ديسمبر الماضي، بهروب جندي كوري شمالي مصاب إلى الأراضي الكورية الجنوبية. حالات الفرار ليست قليلة، ومجدداً تعيد إلى الأذهان حالات الفرار من أوروبا الشرقية عبر ألمانيا الشرقية خصوصاً إلى الغرب. وفي كتاب "الهرب من كوريا الشمالية"، لميلاني كيركباتريك، الكاتبة السابقة في "وول ستريت جورنال"، تمّ تسجيل هرب أكثر من 24 ألف كوري شمالي منذ عام 1953 وحتى اليوم، سواء عبر الحدود، أو عبر المرور إلى دولة ثالثة، غالباً ما تكون الصين.
حالات الفرار دائماً ما تكون اجتماعية واقتصادية بالدرجة الأولى وسياسية بالدرجة الثانية. الكوريون الشماليون يدركون أنه لا يمكنهم الحصول على قوتهم في بلاد الزعامة الشخصية، وهو ما فهمه النظام الكوري الشمالي، ما سمح بإقامة منطقة اقتصادية مشتركة بين الكوريتين في كايسونغ الكورية الشمالية. وبدأت الشركات الكورية الجنوبية، كسامسونغ وهيونداي، في افتتاح مصانع لها هناك، يعمل فيها كوريون شماليون، في صورة مشابهة للمعامل الأميركية، على الحدود مع المكسيك، والتي يعمل بها ملايين المكسيكيين. تأثرت المنطقة بالنزاع السياسي، وهو ما أدى إلى إغلاق المنطقة لفترة.
أما "لمّ الشمل" بين العائلات المشتتة في الكوريتين، فحدث للمرة الأولى عام 2000، عقب القمة التاريخية الأولى بين زعيمي البلدين، الكوري الشمالي كيم جونغ ـ إيل، والكوري الجنوبي، كيم داي ـ جونغ. ومنذ ذلك الحين تُعقد لقاءات للمّ الشمل، وإن توقفت مراراً، لكنها استمرت في معظم الأحيان.
أما اللقاءات الرياضية بين البلدين، وخصوصاً في كرة القدم، فبلغت 16 مباراة، الأولى في عام 1978 في تايلاند وانتهت بنتيجة (0-0)، والـ16 في الصين عام 2015، وانتهت (0ـ0) أيضاً. والأهم أن منتخبي الكوريتين التقيا في بيونغ يانغ في 11 أكتوبر/تشرين الأول عام 1990، وفازت كوريا الشمالية (2-1)، ثم عادا والتقيا في سيول، في 23 أكتوبر 1990، ففازت كوريا الجنوبية (1-0). أما في الدورات الأولمبية، فغالباً ما دخلت بعثتا الدولتين تحت علم كوري موحّد، وآخرها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، في فبراير/شباط الماضي. وهي دورة مفصلية، حلّت فيها كيم يو جونغ، شقيقة كيم جونغ ـ أون، ضيفة في سيول، وعوملت كممثلة رسمية لشقيقها. الدورة كانت عاملاً مفصلياً في دفع المباحثات الثنائية بين البلدين قدماً.
هناك تحديات عدة بين البلدين في المرحلة المقبلة، فبعد القمة، هناك عنصر الاقتصاد، والذي يتوجب من خلاله أن تستوعب كوريا الجنوبية الاقتصاد المتداعي لكوريا الشمالية بفعل العقوبات الأممية، على أنها لا يمكن أن تنتظر إنهاء هذه العقوبات سوى بعد اللقاء المرتقب بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب، في يونيو/حزيران المقبل. كما أن مفهوم الوحدة الكورية يستلزم تعديلات مطوّلة، خصوصاً في سياق "العبادة الشخصية" في كوريا الشمالية. وهو ما يتطلّب مرحلة زمنية معيّنة، لخروج الشمال من ضبابية المرحلة. وقد يكون ذلك عبر تكريس دولة مشتركة من فدراليتين، تسمح في مرحلة أولى في استيعاب التغيير السياسي والاقتصادي، مع تفعيل العامل الاجتماعي. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تضعضع نسبي للاقتصاد الكوري الشمالي، لكن مرحلي، فنموذج كايسونغ في الأذهان، كأمثولة ناجحة اقتصادياً. الخاسر الأكبر في المعادلة ستكون اليابان، رغم أملها بامكانية تبيان اللقاء بين كيم وترامب، مسألة المخطوفين اليابانيين في كوريا الشمالية. أما الصين، ففي وسعها التطلّع لمدى أوسع اقتصادياً في كوريا ككلّ، بفعل اعتماد كيم عليها بشكل وافٍ. للصينيين حساباتهم في بحر الصين الجنوبي أيضاً. الأميركي، بالمبدأ، لن يخرج قريباً من كوريا الجنوبية، على أن خروجه مرتبط بالمكتسبات التي سيحققها في كوريا الشمالية. بالنسبة إلى روسيا، فإن تركيزها على المنطقة الاقتصادية الخالصة في جزر الكوريل مع اليابان، رغم تنازعهما على الجزر، وسيجمع "تحالف الخاسرين" في تلك البقعة من العالم، مع أن لا خاسر فعلياً في هذه الصفقة حتى الآن.