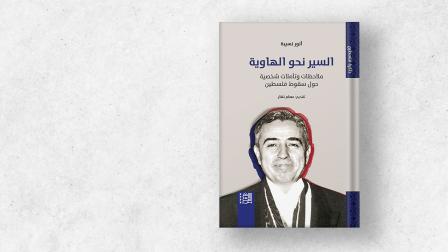بيرسا كوموتسي كاتبة ومترجِمة يونانية، مصرية بالولادة والنشأة. صدرت لها سبعة أعمال روائية، وجميعها تدور أحداثها في مصر، وهي مترجمة أعمال نجيب محفوظ إلى اليونانية. أبرز ما نُقل من أعمال كوموتسي إلى العربية: "الضفّة الغربية من النيل" بترجمة محمد حمدي إبراهيم، و"في شوارع القاهرة، نزهة مع نجيب محفوظ" بترجمة خالد رؤوف، والتي ننشر مقطعَين منها بمناسبة ذكرى ميلاد صاحب "الحرافيش" التي تحلّ اليوم. قريباً، تصدُر روايتها "أصوات سكندرية" عن "دار صفصافة" بترجمة خالد رؤوف.
■ ■ ■
"أن تؤمن وأن تعمل فهذا هو المثل الأعلى، ألا تؤمن فذاك طريق آخر اسمه الضياع، أن تؤمن وتعجز عن العمل فهذا هو الجحيم"
نجيب محفوظ
أكملتُ السير قليلاً وأنا يائسةٌ غائصة في أفكاري إلى أن وجدت نفسي أمام جامعه المفضّل، جامع الحسين، مكانٌ مقدّس وصَفَه مرّات عديدة في كتبه، ليس فقط كمكان موجود، ولكن كمكان له عمق في النفوس، حيث يلجأ إليه المرء أو يطلبه عندما يكون في حاجة ماسّة أو في لحظات اليأس والمعاناة.
وقفتُ قليلاً أمام هذا المسجد المهيب ذي الطراز المعماري الفريد. كان الرجال يخرجون من الباب الرئيسي لهذا الجامع الفخم ووجوههم مضيئةٌ من غبطة ووَرع الصلاة. كانوا ينحنون ويرتدون أحذيتهم بعد أن طهّروا نفوسهم لمرّة أخرى، وسيذهبون ليُكملوا يومهم، ربما في أحد المقاهي المكتظّة بالزبائن في الحي.
اشتقتُ لدخوله، ولو لقليل، كي أتطهّر أنا أيضاً بالهواء الصوفي الذي يملأ المكان، لكن فضّلتُ أن لا أفعل، إذ كنتُ وحدي.
في كُتب محفوظ، جرى ذكرُ هذا الجامع مرّات عديدة، لهذا كان مألوفاً جداً بالنسبة لي. فقد كان في أعماله دائماً، أو تقريباً دائماً، بالأخص في تلك التي تحمل قدراً كبيراً من التصّوُف، الكثير من الرموز الخالدة مثل هذا الجامع، وأيضاً قبور الأولياء والمنارات والزقاق. كل هذه الأشياء في أيدي الكاتب العبقري تتحوّل إلى عربة تحمل الرسائل والأفكار التي لها علاقة بالعبادة والطقوس الدينية.
الأماكن الإسلامية المقدَّسة، والتي يحوّلها المعلّم إلى رموز إنسانية، موانئ للإنسان المضطهد الذي يشعر أنه يعيش على هامش المجتمع بسبب فقره أو بسبب اختياراته الشخصية. الأزقّة في كتبه هي دائماً مثل السجون التي بُنيت حولنا من فرط الخوف، أو لنختبئ بداخلها مغلقين أعيننا عن الحقيقة.
ورغم كلّ هذا، يندّد المعلّم العظيم بكل أنواع التعصُّب وضيق الصدر في ما يخص العبادة وطقوسها، وليس فقط بالنسبة إلى مسلمي العالم. هناك دائماً في كتاباته احترام كبير نحو الإله، لكن هناك نقدٌ واضحٌ لمن يمارسون العقيدة بطرق خاطئة أو يفهمون الدين بطرق ملتوية.
مثال واضح على هذا هو هذا المقتطف الذي صادفتُه في روايته، السياسية بشكل أساسي، "ثرثرة فوق النيل". ورغم أن هذا العمل كُتب في الستينيات، إلّا أنه تنبّأ بتطوُّر تلك العقلية العقيمة.
"مشكلة المتديّنين العابثين، ليست في نقص الإيمان، ولكنهم يسلكون في الحياة العامّة مسلك العبث. فكيف تفسّر ذلك؟! أهو سوء فهم للدين؟ أم أنه إيمان غير حقيقي، روتيني، بلا جذور، يُمارَس تحت ستار أخسّ أنواع الانتهازية والاستغلال؟".
من المميَّز والجدير بالذكر أيضاً هو الارتباط بين الحياة اليومية والتاريخ نفسه والأحداث التاريخية التي أثّرَت في مصر ومنطقة الشرق الأوسط في أوائل القرن. لا توجد لحظة تاريخية هامّة لم يقترب منها ويحلّلها في أعماله بطريقته الفريدة، مبيّناً في مرّات عديدة مناطق في تلك الأحداث لم ينتبه إليها حتى الباحثون في التاريخ ولم يروا الصورة واضحةً. وأيضاً؛ الصغير والكبير، الشخصي والجمعي، المجتمعي وعلاقته بالتاريخي.
كلُّ هذه الأمور لقيت عناية من الكاتب. ودائماً الأحداث التاريخية والاجتماعية والسياسية التي عذّبت الشعب كانت هي الأساس، الشخصيةَ الأساسية أو ربما البطلَ أيضاً في قصصه، بينما في أحيان أخرى كان يبرز بوضوح وجه العصر كلّه، والذي كان له أثر كبير ليس فقط في مصر بل في العالم كلّه.
بعد ذلك، كان يُبرز صورة الشعب الذي يحمل رؤية تحرير الأمّة والحرية، وهي الرؤية التي أثّرت في مسيرة حياة كل أبطاله، وفي هذه الحالة هناك تطابق شديد مع شعوب أخرى، ومع نضالهم نحو الاستقلال وحقوق الإنسان والحرية.
 إن براعته هنا تكمن في أنه أبداً لا ينسى مصريته، ولا تاريخه وتراثه؛ وفي الوقت نفسه، يحوّل كل هذه العناصر - المحلية والغريبة بالنسبة إلى كثير من القرّاء - وصورة العالم في الشرق، إلى كون إنساني ومواقف يمكن أن نقابلها في كل ركن من الأرض.
إن براعته هنا تكمن في أنه أبداً لا ينسى مصريته، ولا تاريخه وتراثه؛ وفي الوقت نفسه، يحوّل كل هذه العناصر - المحلية والغريبة بالنسبة إلى كثير من القرّاء - وصورة العالم في الشرق، إلى كون إنساني ومواقف يمكن أن نقابلها في كل ركن من الأرض.
ومع كلِّ هذه الأشياء العامّة والجمعية، كان ينسج معها العواطف الإنسانية الفردية، والضعف الإنساني والظروف المعيشية القاسية بسبب الفقر أو الاستغلال من قبل القوى الأجنبية والسلطات المحلية أيضاً. يوضّح في الوقت نفسه الحماقة الإنسانية، والتخلُّف وضيق الأفق وانحياز الشعب أحياناً للأفكار المتخلّفة. كل هذه الأمور كانت الخلفية التي تحيط بالأحداث التي تعاني منها مصر بشدّة.
أما عن أبطال رواياته، كما أشرتُ من قبل، هم دائماً شخصيات فاتنة. شخصيات حقيقة كما هي الحياة، يحظون بجاذبية خاصّة لدى المتلقي، كلُّهم دون استثناء، حتى هؤلاء الذين لم تكن لهم جاذبية. رغم ذلك، سيقول الكثيرون أن شخصياته مألوفة ويسهل التعرُّف عليها، ليسوا نمطيّين. هي شخصيات عميقة ومركّبة ومتعدّدة الأوجه.
من الواضح أن المعلّم يحب الشخصيات التي يرسمها، يتوافق معها، لا يستنكرها، فقط يتفهّمها و يتألم معها.
غالبيتهم، أياً كانت طبقتهم الاجتماعية، هم شخصيات متفجّرة، قوية؛ لكن قوّتهم تنحني أمام موروثاتهم المكانية والحياتية. وبسبب هذا تحديداً، فإن غالبيتهم يشعرون أنهم محاصرون على هامش المجتمع المتحفّظ، فيلجؤون إلى التصعيد والهرب نحو الحرية، الحرية الروحية والاجتماعية أيضاً؛ حتى الشخصيات الهامشية في كتبه، وإن كانت تثير اشمئزاز المتلقّي؛ مثل شخصية زيطة الشهيرة، والذي كان عمله يتمثّل في تشويه الأطفال الصغار والدفع بهم إلى التسوُّل، وطبيب الأسنان المتجوّل النصاب في الرواية نفسها أيضاً، أو الطالب المتمرّد الذي يبيع كل مبادئه، حتى نفسَه لكي يعيش. في النهاية، يستطيع أن يجعل قارئه يتفهّمهم، ويسامحهم، بل ويحبّهم أيضاً في بعض الحالات.
نورٌ وظلام في لعبة أبدية. أليست هكذا هي الحياة على أية حال؟ مباراة دائمة ومستمرّة نحو العدل والرفاهية وتحقيق الذات... أليس الإنسان أحد المكوّنات الرئيسية للحياة؟
بالنسبة إلى المعلّم العزيز، الإنسان هو هذا المعنى العالمي المألوف، بغضّ النظر عن أفعاله، إذ أنه يحمل بداخله أشياء إيجابية، حتى وإن كانت مختبئة في أعماقه أو مغطّاة بطين خبراته السيئة، وما اكتسبه من قبح وقسوة داخليين، فهو يستطيع، أو هكذا يجب، أن يجد النور داخل روحه ليتخلّص من كل مساوئه. الشيء الوحيد المطلوب هو الخير والنضال لمعرفة النفس.
"ويوماً بعد يوم، فإن إيماني يرسخ بأن نقاء الإنسان يجيء من الخارج بقدر ما يجيء من الداخل، وأن علينا أن نوفّر الضوء والهواء النقي إذا أردنا أزهاراً يانعة".
إن عالمه هو صورة مصغّرة تُصوّر الحياة العالمية. لأننا لو نزعنا المحيط والعوامل الخارجية، سيقف القارئ منبهراً أمام الواقع الذي يتعرّف عليه أينما كان، وأينما عاش.
الصديق العزيز وشريكي في العمل، والذي قام بمراجعة جزء كبير من ترجمتي للكاتب الكبير في اليونان وعاشق من عشّاقه مثلي تماماً، السيد أ. ك. تساؤيسيس، قضينا معاً ساعات طويلة في مكتبه ومنزله نتحدّث ونحلّل أعمال الكاتب العالمي.
وفي إحدى مقدّماته الرائعة، كتب التالي: "إن أدب نجيب محفوظ العظيم يكمن في أنه يقرّبك من أسرار وجود ما، يعطيك بعض الخيوط. وإذا ما أردت تتبّعها، فستقودك نحو أسرار وجودية لشخصيات أعماله.
إن فكره الذي يتّضح في كتبه وأعماله، هو جزء خالص من الفلسفة الاجتماعية للكاتب، مبدأها الرئيسي هو أن الإنسان لا يستطيع أن يهرب من التزاماته أمام المجتمع. وبالطبع أيضاً أمام نفسه أياً ما كنت الحيل التي يلجأ إليها للهروب". هل يُمكنني أن أضيف: لكي يلغي مسؤوليته وشعوره بالذنب الذي يولّد عدم تفكيره ورفضه لما قد يتبع؟
لدي ثقة بأن تكثيف أفكاره في كل ما يتعلّق بالإنسان وفي حربه الضروس كي تنتشر الأخلاق في عالم يتّسم بالفساد والنفاق والخداع والكذب يمكن أن يتحدّد في آخر فقرة من روايته "مرآة الحياة". الكاتب هنا يشير إلى صادق عبد الحميد، صديقه القديم الحميم بالاسم ويقول: "وضقتُ بهمومي الأخلاقية وتذكّرت الكثيرين ممن يصفونها بازدراء بقولهم "برجوازية"، وقلت لنفسي إنه لمن حسن الحظ أنه لم يبق لنا طويل عمر في هذه الحياة المتعبة الفاتنة".
لم يفُتني قبل أغادر أن أمرّ من حارة الصناديقية العتيقة، والتي تنتهي بزقاق المدق الشهير الذي سمّى به الرواية الرائعة الشهيرة، ووصف المكان بأنه رائعة معمارية فريدة تعكس تاريخ القاهرة مثل نجم لامع. وحقيقةً، بقى هذا المكان راسخاً شامخاً، وكأن الزمن لم يمر عليه ولم يمسه تطوُّرُه:
"تنطق شواهد كثيرة بأن زقاق المدق كان من تحف العهود الغابرة، وأنه تألَّق يوماً في تاريخ القاهرة المعزّية كالكوكب الدريّ. أي قاهرة أعني؟ الفاطمية؟ المماليك؟ السلاطين؟ علمُ ذلك عند الله وعند علماء الآثار، ولكنه على أية حال أثرٌ، وأثر نفيس. كيف لا وطريقه المبلّط بصفائح الحجارة ينحدر مباشرة إلى الصناديقية، تلك العطفة التاريخية، وقهوته المعروفة بقهوة كرشة تزدان جدرانها بتهاويل الأرابيسك، هذا إلى قِدَمٍ بادٍ، وتهدُّم وتخلخل، وروائح قوية من طب الزمان القديم الذي صار مع كرور الزمن عطارة اليوم والغد!".
في رأيي المتواضع، لا يوجد هناك ما هو أكثر إثارةً من فتنة الأماكن، وبالأخص عندما تقاوم ولا تستسلم لتطوُّر العصر وتبقى كما هي على حالتها.
عندما عدت إلى اليونان من هذه الرحلة السريعة إلى مصر، جرى تكليفي بترجمة أحد أعماله الهامّة. كان عنوانه باليونانية، ويالها من صدفة الأحلام المفقودة في خان الخليلي.
■ ■ ■
"هبوطٌ، صعود، موت، بعث، مدني، عسكري، فلتسِر الدنيا في طريقها. أمّا أنا فإنني أستعد لرحلة أخرى"
نجيب محفوظ
عندما توفّي المعلّم، لم يكفّ هاتفي عن الرنين. كان الصحافيّون يتّصلون بي من كل الصحف من أجل لقاء صغير، وكذلك قرّاؤه ومحبّو أعماله. بالطبع كي يعبّروا لي عن حبّهم وتعاطفهم ومواساتهم لي، وأيضاً كي يحصلوا على مزيد من المعلومات، وكأنني كنت صديقته أو أنه أبي الذي أفقده للمرّة الثانية. قبلت تعازيهم بمهابة ونوع من الرفض في الوقت نفسه.
لم أشأ أن أصدّق وفاته. فعلى أية حال، المبدعون من هذه النوعية لا يموتون أبداً. يبقون دائماً أحياء يرشدوننا مثل فنار يضيء لنا الطريق بأفكاره، يوقظنا من خمول الحضارة الحديثة المزيّفة التي تريدنا سلبيّين وجاهلين ومنعزلين عن الفكر والتفكير، منصاعين لحتمية الظروف السياسية العالمية الزائفة وكأنها تسيطر على أقدارنا، وأيضاً على أفعالنا وأخطائنا.
وفي الحقيقة، مرّت سنوات على وفاته ولا يزال يسيطر على حياتي بكتاباته وفلسفته. وحتى اليوم، تجري ترجمة أعماله التي لم تُنشَر في العالم كله - هكذا كان غزير الإنتاج وواسع المدارك - بينما تتنافس دور النشر، حتى في اليونان، على حقوق نشر ولو كتاب واحد من كتبه. لكن، على الأخص، هذا الكاتب الكبير موجود دائماً في قلوب محبّيه وقرائه، والذين صار عددهم لا يُحصى في أرجاء العالم، وفي قلوب من أحبّوا فكره وتبنّوا أفكاره - تلك النفحات الفريدة - وفي قلبي، لنفس الأسباب وأسباب أخرى لا تحصى. كانت وفاته سبباً في أن أفكر في علاقتنا الغريبة التي استمرت ونمت خلال أكثر من أربعة عقود من الزمن.
في نهاية هذه الشهادة العجيبة للمسيرة الموازية والصدف التي ربطتنا للأبد، أودّ أن أضيف مقطَعاً من أكثر المقاطع التي تعبّر عنه في رأيي الشخصي، بعد عشرين عاماً تقريباً من انشغالي بأعماله، أظنّ أنه يلخّص ويختصر في سطورٍ فلسفتَه وحكمتَه. أعترف أن الاختيار كان شاقّاً لأبعد الحدود، أخذ مني وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً، إذ إنه كان عليّ أن أختار بين آلاف الصفحات المطبوعة بين يدي.
وبناءً عليه، أنتهي بهذه الفقرة التي اخترتها للنهاية: "لعلّك لا تؤمن بقولي، أو لعلّك تؤمن به كل الإيمان، ولكن ثِق أن عالم الروح حافل بالمجاهل كعالم المادة، وأن التنقيب فيه يَعِد الإنسان بانتصارات مذهلة لا تقل عن انتصاراته في غزو الفضاء، وأنه لا ينقصنا إلّا أن نؤمن بمنهج روحي كما نؤمن بالمنهج العلمي، وأن نؤمن أيضاً بأن الحقيقة الكاملة هي ملتقى طريقين لا غاية طريق واحد".
* من كتابها "في شوارع القاهرة، نزهة مع نجيب محفوظ"
** ترجمة عن اليونانية خالد رؤوف