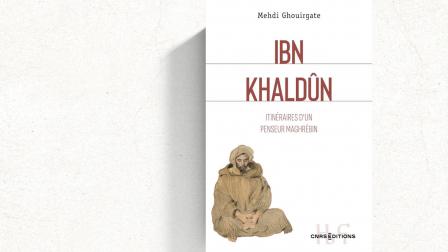تحت عنوان "نجيب محفوظ.. قراءة متجدّدة" أُقيمت، أوّل من أمس الخميس، ندوةٌ حول صاحب "الحرافيش"، ضمن سلسلة "مجدّدون" التي يُنظّمها "مركز الدراسات الثقافية" في "أتيلييه ضي للفنون والثقافة" في القاهرة، بالتعاون مع "منتدى عفيفي مطر".
افتتحت الجلسات بورقة للباحثة زينب العسّال بعنوان "سيميائية العنوان والفضاء الروائي والمعماري في رحلة ابن فطّومة"، وتناولت فيها رواية محفوظ التي تعتمد على فضاء مديني يتغيّر مع ترحال السارد قنديل محمد العنابي، من دار إلى دار، حيث قاربت "رحلة ابن فطومة" عبر المنهج السيميائي، لـ"غياب الدراسات التي تناولته وفق هذا المنهج".
ترى الكاتبة أن "فضاء النص مُترعٌ بالعلامات والعلاقات المهاجرة، والتي تشتبك وتتقاطع على نحوٍ دال وموحٍ، وتعطي زخماً إيحائياً لا يستند إلى ما يظهر على السطح، إذ ثمّة حقب تاريخية ينفتح عليها النص السردي، وحقب تاريخية غير محدّدة بوضوح، وإن كانت تؤكّد أن السارد ينتمي إلى العصور الوسطى".
وتُضيف أن الفضاء المعماري للنص يتقاطع مع فضاء النص السردي المحكي، لافتةً إلى البنى التشكيلية والبصرية، والحروف والخطوط والغلاف والهوامش، تؤكّد أن النص ذو شكل تراثي هو الرحلة، والذي اختلفت الآراء حول ما إذا كان ينتمي إلى الأدب، أم إلى نوع آخر من فنون الكتابة".
أمّا الباحث محمود قاسم، فقدّم ورقةً بعنوان "محفوظ والمخرجون"، وفيها تناول إقبال صنّاع السينما المصرية على روايات صاحب "ثرثرة فوق النيل" لتحويلها إلى أفلام، وهو أمر يعزوه إلى "عبقرية المكان والموضوع ومصائر الأشخاص" في تلك الروايات.
يقدّم الكاتب عرضاً تاريخياً لدخول أعمال محفوظ إلى السينما، والذي بدأ عام 1960 مع رواية "بداية ونهاية" التي أخرجها صلاح أبو سيف، وكانت التجربة التالية مباشرةً مع كمال الشيخ عام 1962 حين قدّم "اللص والكلاب"، ثم مع حسن الأمام الذي قدّم "زقاق المدق" وتبعه بالثلاثية.
ويخلص قاسم إلى أنه و"رغم أن اسم محفوظ كان في قائمة الممنوعين من دخول البلاد العربية، فإن المخرجين من الأجيال المتتابعة لم يتوقّفوا عن العمل على نصوص رواية "الحرافيش"؛ ومنهم نيازي مصطفى، وأشرف فهمي، وأحمد ياسين".
يضيف أن أعمال الكاتب "تشرّبت بنكهات متعدّدة، ومن مختلف مدارس واتجاهات الإخراج السينمائي في مصر. وعلى جانب آخر، فإن كتّاب السيناريو تهافتوا على كتابة أعمال محفوظ للسينما. رغم ذلك، لم يفكّر هو في إبداء رأي في هذه الأفلام أو الإعلان عن رغبته في تحويل أي من رواياته إلى عمل سينمائي".
بدوره، قدّم الأكاديمي يسري عبد الغني مداخلةً بعنوان "وما زال العم نجيب يعلّمنا"، تناول فيها حكمة الروائي وما تركه لقارئه من عبارات تظلّ عالقةً معه ومؤثّرة فيه، موضّحاً: "من خلال حوارات أبطال روايته "الحرافيش"، يقول لنا: من يحمل الماضي تتعثّر خطاه، والنجاح لا يوفّر دائماً السعادة، والحزن كالوباء يوجب العزلة، ولا توجد الكراهية إلّا بين الأخوة والأخوات، ومن الهرب ما هو مقاومة، ولن نمل انتظار العدل".
ولفت الباحث إلى حادثة الاعتداء على محفوظ عام 1994، قائلاً: "يجب أن نتذكّر دائماً ما جرى على امتداد السنين من محاولات متعدّدة لتكفيره منذ أن نُشرت روايته "أولاد حارتنا" (1959). وبسبب هذا الحادث الأليم، توقّفَت يده اليمنى عن إمساك القلم والكتابة به، ليدخل بعد ذلك بكامل إرادته في ما يمكن وصفه بـ"بداية جديدة"، في تدريب يومي شاركه فيه الدكتور يحيى الرخاوي، وذلك من أجل الكتابة من جديد".
وتحت عنوان "محفوظ علامة فارقة في تاريخ الرواية العربية والسامية"، تناول أستاذ الأدب العربي نجيب عثمان أيوب الكاتب بوصفه "ظاهرة أدبية فنّية نفت مزاعم وأثبتت أخرى، كما كان حجة دافعت بواقعية فعلية عن العرب والجنس السامي عامة؛ حيث كانت أعماله الروائية التي نالت "جائزة نوبل في الآداب"، والرواية بالتحديد، خير شاهد على أن الجنس السامي والعربي تحديداً، لم يكن بمنأى عن أقرانه من الآريين الذين زعمت بعض الدعوات العنصرية، احتكارهم الخيال الروائي والأداء الملحمي دون غيرهم".
وعاد الأكاديمي خالد عبد الغني إلى عمل "أحلام فترة النقاهة" في ورقة بعنوان "كيف جمع نجيب محفوظ بين العجائبي والاستبصار بالمشكلات الواقعية"، متناولاً مفهوم الحكمة عند محفوظ، واعتبر أنه "يعيد تكوين التوجّهات الفلسفية الإنسانية بشكل يلتبس فيه المدلول الثقافي الكامن بالظواهر الافتراضية الفريدة والشخصيات كعلامات غير قابلة للاختزال. ولذا، فهناك ثراء في النص المحفوظي لدرجة قابليته للكثير من التأويلات الممكنة".
يقف عبد الغني عند خصوصية شكل "أحلام فترة النقاهة" الذي وصفه بـ"التجريبي العجائبي للكتابة السردية، يبدو وكأنه عفوي ينطق على عمل مركّب يقوم على النظام والأمانة المطلقة، ويحرّر الموضوع والشخصية الحدث/ الفعل الإبداعي من آنية اللحظة وصدورها إلى أفاق المطلق ومداه اللانهائي واللاشخصي، والسرد هنا لا يسير في خط مستقيم بل هو أشبه بارتماء الأمواج على الشاطئ وانسحابها عنه، ويثمر هذا التكنيك نصاً متوهجاً محموماً ولكنه مكتوب بدقّة ورهافة، وهو في النهاية استكشاف وتأويل للمسكوت عنه والمضمر لأسرار الوجود والزمن والموت والعدم وفهم البحث عن تراجيديا الإنسان من المهد إلى اللحد".
وبعنوان "الشحّاذ بين الهوية والتعدّدية الثقافية"، شارك الباحث ماهر عبد المحسن، ليقرأ عالم محفوظ من المدخل الثقافي، مستفيداً من المنجز الذى تحقّق في حقل الدراسات الثقافية، فرغم خصوبة أعمال محفوظ ومرونة حقل الدراسات الثقافية، إلّا أن التساؤل عن مدى إمكانية إخضاع رواية ذات أبعاد فلسفية عميقة مثل "الشحّاذ" إلى أبجديات الدراسات الثقافية يظل مطروحاً، وفقاً للباحث.
يتابع عبد المحسن أنه "يُمكننا أن نُدرك مدى الصعوبة التي يمكن أن تكتنف مثل هذه المحاولات عندما نتعرّض إلى طبيعة العلاقة بين النظرية الأدبية والدراسات الثقافية، فهذه الأخيرة أخذت على عاتقها تجاوز البعد الجمالي في الأعمال الإبداعية على نحو ما كانت في النظرية النقدية التقليدية، والعمل على إزاحة النقاب عن العلاقات المتشابكة التي تحيط بالعمل وتؤثّر فيه أو تتأثّر به كمنتج ثقافي. وبهذا المعنى، يكون التركيز على علاقة العمل بدور النشر والدعاية واستجابات القرّاء على اختلاف مشاربهم".
يرى الباحث أن إعادة اكتشاف العمل في ضوء المفاهيم الثقافية الجديدة أمرٌ ممكن، إذ يمكننا أن نقرأ في "الشحّاذ" ما يتجاوز أبعادها الفلسفية الصريحة والمباشرة، لنكتشف رؤية محفوظ لمفاهيم أكثر معاصرة مثل الهوية، والتعدّدية الثقافية، والجنسانية والجنوسة، والعلاقة بين الفنون البرجوازية والفنون الشعبية، خاصة أن الرواية سبق قراءتها فلسفياً من قبل زكى نجيب محمود وحسين علي، وما زالت تحتمل المزيد من القراءات والتأويلات.
"فن القص بين التأصيل والتفكيك.. دراسة في البعد الثقافي"، عنوان ورقة للباحث حمدي النورج، وفيها تناول الرواية البوليسية العربية بالعموم، ثم يتطرّق إلى الحبكة البوليسية التي تجلّت في "اللص والكلاب" التي كتبها في أعقاب إطاحة النظام الملكي بعد ثورة الضبّاط الأحرار؛ حيث السعي إلى تحقيق الاشتراكية وإعادة توزيع الثروات بشكل يضمن للأغلبية حقوقها مع حياة كريمة وعادلة.
واعتبر المتحدّث أن دوافع "راسكو" في رواية "الجريمة والعقاب" لدستويفسكي، هي نفسها الدوافع التي حرّكت سعيد مهران بطل الرواية، غير أنّ المبرّرات الفكرية لدوافع ارتكاب الجريمة لا تقل عن الدوافع الاجتماعية والظروف المعيشية، بل إن رواية "الجريمة" لمحفوظ تذهب إلى أماكن أبعد من ذلك، عندما تتّخذ من الجريمة فكرة لتقويض نظام أو هز عرش رئيس ما.
 أشار الباحث، أيضاً، إلى فترة نشر "الجريمة"، بعد أن شهد الواقع المصري في أواخر القرن الماضي تحوّلات اجتماعية وسياسية وعسكرية بما تبعها من انهيار في الأنساق والمشروعات والقناعات المستقرّة، وفقدان الثقة في الذات، وفي أنواع الوعي القائمة، وكانت نتيجة ذلك الانكفاء الكامل على الذات للبحث عن منطق بديل لا يركن إلى يقين، ولا يستقر على نسق ثاب، بحسب النورج.
أشار الباحث، أيضاً، إلى فترة نشر "الجريمة"، بعد أن شهد الواقع المصري في أواخر القرن الماضي تحوّلات اجتماعية وسياسية وعسكرية بما تبعها من انهيار في الأنساق والمشروعات والقناعات المستقرّة، وفقدان الثقة في الذات، وفي أنواع الوعي القائمة، وكانت نتيجة ذلك الانكفاء الكامل على الذات للبحث عن منطق بديل لا يركن إلى يقين، ولا يستقر على نسق ثاب، بحسب النورج.
بدورها تحلّل الباحثة نهى يسري صورة "الأم في روايات محفوظ"، متطرّقةً في البداية إلى أم نجيب محفوظ التي كانت "مخزناً للثقافة الشعبية ودائمة التردّد على المتحف المصري، فضلاً عن غرامها بسماع أغاني الشيخ سيد درويش، حيث يعترف نجيب أن علاقته مع والدته كانت أوثق من العلاقة مع أبيه لأنه لازمها وأقام معها باستمرار من ناحية، ومن ناحية أخرى لأن العمر قد امتد بها طويلاً بعد وفاة الأب".
ترى يسري أن محفوظ يقدّم أمّهات حنونات طيّبات، وأمّهات منحرفات أو ممزّقات بين الأنوثة والأمومة، وأن عالمه الثري حافل بالأمّهات القويات المسلّحات بالإرادة الحديدية لمواجهة تقلُّبات وعواصف الحياة، متناولةً بالتفصيل شخصيات أمّهات عبرن في روايات محفوظ؛ منهن: حليمة، وسنية المهدية، والست عين، وأم حسن.
أمّا الأكاديمية أمل حسن، فتطرّقت إلى "البعد الفلسفي في كتابات نجيب محفوظ"، وعنه تقول: "المتأمّل لكتابات محفوظ لا بد أن ينتبه إلى القضايا الفلسفية التي يُثيرها على مستويَي الأحداث والشخصيات"، مضيفة: "من المعروف أن الكاتب درس الفلسفة، وكتب العديد من المقالات الفلسفية والأدبية، وقارئ مقالاته يلاحظ أنه كان محبّاً للفلسفة، متعمّقاً فيها. ورغم أنه لم ينغمس في الفلسفة وحدها، إلّا أنه حين تفرّغ للإبداع الأدبي، ظهر تأثّره جلياً بالفكر الفلسفي".
وتكمل: "يعتقد الباحثون أن ريادة محفوظ للفن الروائي وإبداعه ترجع إلى الإدراك الواعي والعميق لطبيعة المجتمع الذي نبع منه إبداعه، مع نظرة ذات بُعد فلسفي خاص. ممّا جعل بعض الأقلام تراه منتمياً إلى المدرسة الطبيعية الواقعية، التي قادها أدباء فرنسا؛ مثل إميل زولا، وغوستاف فلوبير، وهنري بلزاك". انطلاقاً من ذلك، قامت حسن بتحليل بعض النماذج الأدبية من روايات وقصص قصيرة كتبها محفوظ، من خلال رؤيته الفلسفية.
وحول "استقبال الإيطاليّين لأدب محفوظ"، قدّم الباحث إسلام فوزي قراءةً ثقافية، اعتبر فيها أن الإقبال على ترجمة محفوظ إلى الإيطالية بدأ بعد فوزه بنوبل عام 1988، حيث تُرجمت "الكرنك" في العام نفسه بعنوان "مقهى الدسائس"، وقد ترجمتها أستاذة الأدب الإيطالي دانييلا رامالدي، وصدرت هذه الترجمة بطبعة أخرى عام 2004، ثم تُرجمت أعماله "زقاق المدق"، و"ميرامار"، و"أولاد حارتنا"، و"بين القصرين".
ركّز فوزي، في ورقته، على "كيفية قراءة الإيطاليين للنص المحفوظي وتناولهم له، بل إدخال أجزاء منه في بعض الأنطولوجيات التي يدرُسها التلاميذ والطلّاب في المدارس والجامعات، وهذا يعكس، حسبه، "مدى الأثر الذي تركه محفوظ الذي استطاع الانطلاق من الإنسانية المصرية المحلية ليخاطب الإنسانية العالمية في كل أنحاء العالم".
من جهتهما، قدّمت الباحتان ناهد ونهلة راحيل ورقةً بعنوان "الترجمة في سياق ما بعد الاستعمار: ترجمة أعمال نجيب محفوظ إلى العبرية"، وقفتا فيها على أسباب ترجمة بعض نصوصه إلى العبرية، وبيان الفارق بين أهداف الترجمة ضمن المشروع الاستعماري من خلال ترجمة المستشرق مناحم كابليوك لرواية "اللص والكلاب"، وأهدافها في سياق ما بعد الاستعمار من خلال ترجمة بعض الروايات؛ مثل "الثلاثية" و"أولاد حارتنا" من قبل اليهود العرب؛ أمثال دافيد سجيف، وساسون سوميخ، وسامي ميخائيل.
تعتبر الأكاديميتان أنه "عند الحديث عن الترجمة بين اللغتين العربية والعبرية، لا نستطيع تجاهل السياق السياسي الذي نشأت داخله محاولات الترجمة بين الطرفَين، وكذلك الخطاب الاستعماري المهيمن الذي توجّهت به المؤسّسة الصهيونية إلى العرب واليهود العرب على حد سواء، في نطاق علاقات الأكثرية - الأقلية وما تفرضه من صراعات".
وتذهب الورقة إلى أن "خلفية الكاتب المعرفية وأيديولوجياته التي يتبنّاها هي المحرّك الأول في اختيار ترجمة نصوص بعينها، يبثّ من خلالها مقاصده وتوجّهاته. وإذا كانت الترجمة جزءاً من المشروع الاستعماري، كهدف لمعرفة الآخر ومراقبته وتكوين صورة شاملة عنه، فالأمر يختلف عند الحديث عن الترجمة في سياق ما بعد الاستعمار، والتي يكون هدفها استقصاء أشكال التمثيل (الآخر للنفس، والنفس للآخر)، وأهمية ذلك في بناء تمثيلات الثقافات المهمّشة من قبل الكيان الاستعماري".
بحسب الورقة "أخذ الكيان الصهيوني، بوصفه كياناً استعمارياً في المقام الأول، بأسباب الحضارة الغربية وألحّ على ضرورة الاعتراف بعدم قيمة العادات الشرقية والهوية العربية ومقوّماتها الثقافية داخل "إسرائيل"، وانتهج عدداً من الأساليب لتهميشها؛ لذلك كرّس عدد من الكتّاب اليهود ذوي الأصول العربية جهودهم المتواصلة لفرض هويتهم الثقافية ودمجها بالمجتمع الإسرائيلي، عبر خطاب بديل قوامه نشر أفكارهم، كترجمة نماذج من الأدبيات العربية ونقلها إلى العبرية".
أمّا الكاتب والباحث إكرامي فتحي، فشارك بورقة بعنوان "محفوظ وسؤال القيمة والبقاء رؤية جيل ما بعد المعاصرة"، حاول فيها رصد رؤية الجيل الحالي لهذه النقطة المحورية، لا سيما مع اتّسام هذه الرؤية المطروحة بسمات فارقة، تتمثّل في "البعد الزمني والتخلّص من إشكالية المعاصرة وحجابها، ثم التنوّع الثقافي للذوات المتحدّثة ما بين الإبداع والنقد والكتابة الصحفية، وصولاً إلى تباينها الشديد من حيث الصياغة اللغوية والمنحى الفكري؛ ما جعلها "عينة" جديرة بتمثيل واقعنا الثقافي الحالي".
واختُتمت الندوة بورقةٍ للأكاديمية والباحثة مروة مختار، حملت عنوان "الرواية المحرّمة وسوسيولوجيا التلقي"، متسائلةً "إن كانت عملية تلقّي أي عمل إبداعي حرّةً وفردية أم أن هناك ألواناً من التلقّي الجماعي تُحَجم هذه الفردية وتسعى إلى تأطيرها؟ هل التلقي حرّ أم أنه مجموعة من الدوائر المتقاطعة تتحرّك وتتفاعل بشكل معلن وخفي، بمجرّد تحريك محيط إحداها؟ هل واقع التلقّي أسير للنخبة الثقافية ورجال الدين وللساسة ـ باعتبارهم ممثّلين لتيارات ليست بقليلة ـ أم أن القارئ العام/ المتلقّي العام هو الفيصل في العملية؟".
ومن خلال تناولها كتاب "أولاد حارتنا سيرة الرواية المحرمة" لمحمد شعير، تتساءل مختار: "إذا كنّا اهتممنا لعقود بدراسة سوسيولوجيا الأدب، متى يكون لدينا كيف وكمّ موازيان لسوسيولوجيا تلقّيه تحاول أن تستبصر طبيعة حركتنا، هل حركتنا متّجهة نحو المستقبل أم نحو الماضي، أم هي حركة دائرية ونحن داخلها؟".