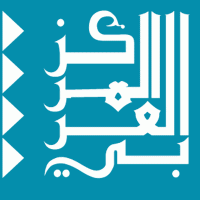12 نوفمبر 2024
معارك سورية.. المشهد الميداني ودلالاته السياسية
حققت المعارضة المسلّحة إنجازات في الجبهات الشمالية (الأناضول)
بعد سلسلة نكساتٍ عسكريةٍ، تعرّضت لها فصائل المعارضة السورية المسلحة على امتداد عام 2014، تمكنت، خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2015، من تغيير الوضع الميداني لمصلحتها؛ إذ بدأت مواقع النظام السوري تتهاوى على أكثر من جبهة، كما بدأت تظهر على قواته ملامح التعب والإجهاد، وغدت عاجزة عن وقف تقدم تلك الفصائل في أكثر المناطق أهمية وحساسية بالنسبة للنظام.
انقلاب في المشهد الميداني
يُعزى انهيار قوات النظام السوري أمام هجمات قوات المعارضة المسلحة، في أكثر من مكان على امتداد الجغرافيا السوريّة بشكل رئيس، إلى زيادة مستوى التنسيق بين هذه الفصائل، وإنشاء غرف عمليات مشتركة لتوحيد الجهد وقيادة العمل العسكري على الأرض. ففي حلب، مثلاً، تشكّلت الجبهة الشامية، في أواخر العام الماضي، نتيجة اندماج أهم الفصائل العاملة في المنطقة الشمالية، مثل الجبهة الإسلامية وجيش المجاهدين وحركة نور الدين زنكي وغيرها. وأدى هذا الاندماج إلى تراجع الخطر الذي مثله تقدّم قوات النظام وحلفائه في ريف حلب الشمالي، واقترابه من قطع "طريق الكاستيلو"؛ شريان الإمداد الوحيد لفصائل المعارضة في الجزء الشرقي من حلب. ونجحت الجبهة الشامية، خلال أسابيع قليلة من تشكيلها، في استعادة جميع المناطق التي خسرتها أمام قوات النظام والمليشيات المساندة له خلال عام 2014. أما داخل مدينة حلب، فقد نجحت فصائل جهادية (جبهة النصرة وجبهة أنصار الدين) وعناصر من الجبهة الشامية في منتصف أبريل/نيسان 2015 في خرق خط الدفاع الأخير للنظام غرب المدينة، عبر اقتحام مبنى المخابرات الجوية والمباني العسكرية المحيطة به.
وفي الجنوب، استطاعت قوات الجبهة الجنوبية، وهي ائتلاف عريض مكوّن من نحو 50 فصيلاً معارضاً، من تحويل النصر العسكري الذي حقّقه لواء "فاطميون"، وقوات من حزب الله، مدعومة بإسناد مدفعي وجوي من جيش النظام السوري (10 فبراير/شباط 2015) في محور تل عدس – تل المصيح - الناجي إلى هزائم متتالية، باعتمادها تكتيك حرب العصابات. ومثّلت سيطرة المعارضة على مدينة بصرى الشام، في 25 مارس/آذار 2015، ضربةً موجعةً أخرى للنظام وحلفائه، نظراً لأهمية المدينة، بوصفها حلقة الوصل بين محافظتي درعا والسويداء، ومركز عمليات حزب الله في حوران. ولم تمض أيام قليلة على الاختراق النوعي السابق، حتى باغتت فصائل المعارضة قوات النظام في معبر نصيب؛ لتسيطر بذلك (1 أبريل/نيسان 2015) على آخر معابر النظام الحدودية مع الأردن.
وبينما كانت مواقع النظام تتهاوى في حلب والمنطقة الجنوبية، كانت التحضيرات لمعركة إدلب قد اكتملت، بعد نجاح جبهة النصرة وأحرار الشام، أواخر العام الماضي، في السيطرة على معسكري وادي الضيف والحامدية، أكبر معسكرات النظام في محافظة إدلب، وإطباق الحصار بشكل تام على مطار أبو الظهور العسكري، وهو آخر المطارات العسكرية المتبقية للنظام في المحافظة؛ ما سمح بإطلاق عملية تحرير محافظة إدلب بشكل كامل. وقد ساعد تشكيل جيش الفتح في 24 مارس/آذار 2015، والذي ضمّ فصائل إسلامية وثورية عديدة، في مقدمتها أحرار الشام وجبهة النصرة وفيلق الشام وغيرها، في الاستيلاء على مدينة إدلب في مطلع إبريل/نيسان الماضي؛ لتبدأ بعدها معارك السيطرة على ما تبقّى من مدن المحافظة، ابتداءً بجسر الشغور وانتهاءً بأريحا.
وعلى وقع هذه الإنجازات، أعادت فصائل المعارضة إشعال جبهات هادئة من جديد؛ فبدأ مقاتلو جيش الإسلام في ريف دمشق معركةً استهدفت اللواء 39 في الغوطة الشرقية، ونجحوا في إطباق الحصار عليه، كما شنّ مقاتلو أحرار الشام هجوماً مفاجئاً على قوات النظام في ريف حلب الجنوبي، وسيطروا على عدة قرى محاذية لأوتوستراد حلب - خناصر، والذي يعد طريق الإمداد الوحيد لمناطق سيطرة النظام في الجزء الغربي من مدينة حلب. من جهة أخرى، استغلّ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" فرصة انشغال قوات النظام بالتصدي لتقدّم قوات المعارضة على أكثر من جبهة، وانهيار معنويات جنوده، للتمدّد في البادية السورية؛ فدخل مدينة تدمر في 20 مايو/أيار 2015 ليقطع الإمداد نهائياً عن قوات النظام المتمركزة في مدينة دير الزور ومطارها العسكري، وليهدِّد مدينتي حمص وحماة من جهة البادية.
واقع عسكري وسياسي جديد
لن تؤدي الانتصارات الأخيرة للمعارضة المسلحة إلى حسم الصراع مع النظام. ومع ذلك، فرضت واقعاً عسكرياً وسياسياً جديداً؛ فللمرة الأولى منذ بداية الصراع، يظهر النظام السوريّ مستنزفاً، وفي موقع الدفاع عن بقائه ووجوده، كما بدا هذه المرة عاجزاً عن إقناع أنصاره وحلفائه بإمكانية حسم المعركة لمصلحته. فلطالما تمسّك النظام بتحقيق الحسم العسكري الشامل، وعدّه شرطاً لازماً للبدء بالحديث عن أي حلٍ للأزمة. جاءت مكاسبه العسكرية خلال عام 2014، مع تدخّل حلفائه مباشرة لمساعدته، وتراجع الدعم الإقليمي والدولي للمعارضة، وتركيز الغرب على مواجهة تنظيم الدولة والجماعات الجهادية، بدلاً من حل الأزمة، لتعزّز اقتناعه بإمكانية تحقيق النصر. لكنّ التطورات الأخيرة دحضت هذا الخطاب، وبيّنت أنه بعيد عن الواقع، وأظهرت مدى الإنهاك الذي أصاب قوات النظام، بعد أربع سنوات من المواجهات، كما كشفت اعتماده المفرط على المليشيات الأجنبية.
وفضلاً عن ذلك، ترافقت الانتكاسات العسكرية مع تدهور الوضع الاقتصادي الذي تمثّل في التدهور الكبير في سعر صرف الليرة السوريّة أمام الدولار الأميركي، وعجز البنك المركزي عن فعل شيءٍ إزاء ذلك، على الرغم من استمرار عمليات الضخ الأسبوعية للعملة الصعبة في الأسواق، أملاً في وقف تدهور سعر الصرف. كما تصاعد هروب رؤوس الأموال والتجار والمستثمرين إلى خارج البلاد. وبرزت، في الأسابيع الأخيرة، مؤشرات على تنامي الخلافات داخل الحلقة الأمنية الضيقة للنظام، بعد وفاة رئيس شعبة الأمن السياسي رستم غزالي وعددٍ من القيادات العسكرية في ظروف غامضة. كما تسود حالة ترقبٍ وارتباكٍ ضمن حاضنة النظام، خصوصاً في منطقة الساحل السوري وحمص، بعد اقتراب فصائل المعارضة وتنظيم الدولة منها. وكان لافتاً، في هذا الصدد، ظهور الرئيس بشار الأسد نفسه، أخيراً، وسط مجموعة صغيرة من مؤيديه في محاولة لطمأنة قاعدة دعمه التي بدأت تتململ وتتخوف من مصيرٍ مجهولٍ؛ إذ طالبهم بالمساهمة في رفع معنويات جيشه، ومقاومة "المؤامرة الدعائية" التي تستهدف إحباط معنوياتهم، والتشكيك بقدرة الجيش على ما أسماه "حسم الحرب".
على المستوى الدولي، نجح النظام، خلال العام الماضي، في صرف الاهتمام عن الأزمة السوريّة وأسبابها الحقيقية، والتركيز على مقولة مكافحة التطرف والإرهاب، وطرح نفسه شريكاً في مواجهة تنظيم الدولة والحركات الجهادية الأخرى. كما أسهمت مقترحات المبعوث الأممي، ستيفان دي مستورا، حول "تجميد" الصراع في مدينة حلب، وترويج فكرة تفرّغ قوات النظام والمعارضة لمحاربة تنظيم الدولة، في صرف الانتباه عن عملية التسوية التي أقرها بيان جنيف لعام 2012. وبرزت في الغرب، ولا سيما بعد تفجيرات باريس، دعوات لإعادة تأهيل النظام دولياً، واعتماده شريكاً في مواجهة التطرف، بدلاً من المراهنة على معارضةٍ سياسية متشرذمة و"فصائل مسلحة معتدلة"، لا يمكن الاعتماد عليها في نظر من يروّج للاعتماد على النظام، وخصوصاً بعد أن جرى دحرها بسهولة، واستيلاء جبهة النصرة على مقراتها وعتادها. كما ثار جدلٌ كبيرٌ حول برامج تدريب المعارضة، وما إن كانت ستؤدي دوراً ناجعاً في القضاء على تنظيم الدولة، في ظل استمرار الخلافات بين الإدارة الأميركية وبعض حلفائها في المنطقة عن الدور المنوط بهذه العناصر المدربة وآليات حمايتها من هجمات تنظيم الدولة، أو النظام. لكنّ هزائم النظام في حلب ودرعا وإدلب وتدمر، واستعداد المعارضة للاستفادة من هذا الزخم، للقيام بهجمات باتجاه طرده كلياً من حلب، والتقدّم في ريف حماة وسهل الغاب، أدى إلى تغييرٍ كبيرٍ في هذا المشهد.
وبسبب التدهور السريع في قدرات النظام العسكرية، والخشية من استمرار تساقط مواقعه، سارعت الولايات المتحدة وروسيا إلى إحياء الاتصالات بينهما، بخصوص الأزمة السورية، بعد انقطاعٍ دام أكثر من سنة، إثر فشل مؤتمر "جنيف 2" واحتدام خلافاتهما حول أوكرانيا. كما عادت روسيا التي ما فتئت تشجّع النظام السوري على الحسم العسكري، وتساعده في الالتفاف على مقررات "جنيف1"، للحديث عن ضرورة إحياء مسار جنيف، والتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة. وبالمثل، سارعت الولايات المتحدة للتحرّك لإنقاذ النظام ومنع انهياره على ما تبقى له من الأرض السورية، خشية حلول جماعات جهادية محله، ما أدى بوزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إلى زيارة روسيا والاجتماع بالرئيس فلاديمير بوتين، للنظر في إحياء جهد التسوية.
خاتمة
قضت الانتصارات الأخيرة التي حققتها المعارضة المسلحة على فرص تعويم النظام السوري، وتحويله إلى شريكٍ دولي مقبولٍ في محاربة تنظيم الدولة، كما قضت على أي إمكانية لقيام النظام بفرض تسوية وفق شروطه وشروط حلفائه، بعد أن أصبحت فكرة الحسم العسكري جزءاً من الماضي. وفي وقت يتجدد الجهد الدولي لإحياء عملية التسوية، بعد القلق الذي أصاب حلفاء المعارضة قبل خصومها، تجاه إمكانية انتصارها وسقوط النظام، فإنه يترتّب على المعارضة السورية، السياسية تحديداً، أن تضع برنامجاً يقدم بديلاً سياسياً لكلٍّ من النظام وتنظيم الدولة، ويسرّع ببدء عملية انتقالية قائمة على المشاركة، ويتضمن، من بين أشياء أخرى، طمأنة العالم بشأن قدرة المعارضة على ضبط أي فوضى، يمكن أن تنشأ عن رحيل النظام، واستعدادها لدمج كل قوى المجتمع السوري في النظام التعددي القادم، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وسيادتها ووحدة أراضيها، ووضع البلد على طريق التحوّل الديمقراطي الذي يكفل حقوقاً متساوية لجميع مواطنيه، بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية أو الدينية أو العرقية، والبدء بعملية مصالحة وطنية شاملة، تستوعب الجميع، ومن دون أن تتهاون في تحقيق العدالة أو إعادة الحقوق. ولا بد أن تأتي مكونات أي حلٍ سياسي يحافظ على سورية، على شكل تسويةٍ تشارك في تقديم ضماناتٍ لتنفذها دول عظمى، مثل روسيا والولايات المتحدة، وكذلك دول إقليمية. أما البدائل الأخرى، مثل استمرار الصراع من دون نهاية واضحة، أو الانهيار المفاجئ للنظام، فلا تضمن شيئاً سوى استمرار الصراع الأهلي والمعاناة، وتوليد ردود فعل أكثر تطرفاً.