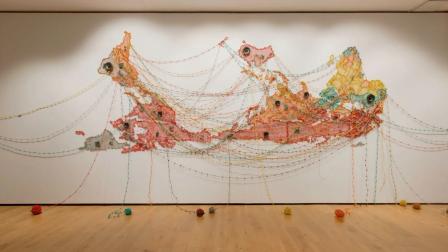ثمة أشخاصٌ يعبرون الحياة مثل الشهُب أو الريح مستعجلين الرحيل كما لو أنهم على موعد مع الحب أو مع قصيدة، يمتلكون أسرار الإبداع وسحره، يمنحونه ذواتهم وآلامهم مثلما يغمرون من يحيطون بهم محبة وصدقاً وعطاء ولا ينالون في حياتهم من مجد الفن إلا أوجاع السؤال وقلق الوقت ومكابدة الذات وريبة الآخر واتهاماته الغريبة.
هكذا عرفت الفنان المغربي محمد الإدريسي (1946-2003) -أو الدريسي بحسب ما شاع اسمه- كإنسانٍ وارتسمتْ حياتُه سيرة فنية مميزة في الذاكرة، كان اللقاء الأول سنة 1986 في معرض أقامه بالمركز الثقافي الفرنسي بتطوان، كان اسمه حينئذ قد بدأ يترسخ في المشهد التشكيلي المغربي كفنان متمرد ومغاير له خصوصيته المميزة التي تجعله غير قابل للاحتواء في القوالب التشكيلية السائدة آنذاك، ثم لأن الأشكال والأجساد والكائنات التي يبدعها في لوحاته كانت تقع تحت سلطة الثالوث المحرّم، خطاب تشكيلي يحتفي بالجسد وبعريه الذي يشي بتجاهل وقوع الجنسي تحت سلطة المحرّم؛ كائناتٌ ملامحها تعكس عتمة الوقت ومأساوية القدر الإنساني في رحلة مكابداته على الأرض.
لكن خلف كل هذه الأسئلة يبقى هنالك السؤال القيميّ في معنى العري والبؤس والتمزّق الذي كان كامناً في لوحات الدريسي. يقول الناقد التشكيلي المغربي شفيق الزكاري: "أعمال الدريسي من بين أهم التجارب المغربية الجريئة، التي رسمت معالمها دون قيد أو شرط أو رقابة أخلاقية معينة، فكانت عبارة عن تجربة كسرت حدود المسكوت عنه في الثقافة العربية والمغربية، ودشنت عهداً جديداً تجاوزت فيه مفهوم الحرية اصطلاحاً، سواء على مستوى الموضوع أو الممارسة.
هي تجربة يمكن تصنيفها بين التجارب التي تنضوي تحت اسم "التشخيصية الانطباعية"، لما تحتويه شكلاً من مفردات تشكيلية خاصة أولاً بالتقنية ثم بالموضوع الذي يعتبر موضوعاً آنياً يطرح عدة أسئلة بطريقة سردية على مستوى المشاهدة، لذلك وبعد مرور عقد من الزمن تم الاعتراف بشكل رسمي بهذه التجربة، بعد وفاة هذا الفنان الذي كان يجب أن يُحتفى به في حياته وهذا ما يحزّ في نفسي، لأن تجربته كانت تستحق المتابعة والاهتمام منذ بدايتها".
الآن وخلال هذه الفترة تعرض أعمال الحفر للفنان الدريسي بقاعة ثربانتس بطنجة في محاولة لإعادة اسمه للواجهة باعتباره فنانا كبيراً عانى من الإنكار، وقد كنت شاهداً على جزء من هذا التهميش، كنت أزوره في بيته بالمضيق في حي الزاوية الشعبي. بيت مغربي صغير عادي فوق تل يشرف على البحر، ومن نافذة الغرفة التي يستعملها الفنان كورشة لإنجاز أعماله الفنية كان يُرى الأفق اللامتناهي الذي تلتقي فيه زرقة السماء بزرقة البحر.
كان الدريسي متضايقاً من هذا التجاهل إن لم نقل التهميش الذي يعانيه في مدينته تطوان، وفي مدرستها الشهيرة التي أسسها أحد أعلام الفن والتربية في مغرب "الحماية الإسبانية"، الفنان الغرناطي ماريانو بيرتوشي، فقد كانت المدرسة تعترف فقط ببضعة أسماء مكرّسة معروفة لدى الجميع، وكان الفنانون الآخرون يحاولون أن يجدوا لهم فسحة بين الكبار.
كان الدريسي خريج مدرسة الفنون الجميلة يبدو نشازاً من حيث أعماله المغايرة لأسلوب المدرسة. ويذهب شفيق الزكاري إلى أن الدريسي لم يهمش في تطوان، يقول: "ليس هناك أي إقصاء أو تهميش للفنان محمد الدريسي، لأن تجربته فرضت ذاتها، زيادة على أنها بعيدة كل البعد عن تصورات ومنهجية مدرسة تطوان التي كانت تحتفي بما قد ترسب من تقنيات الغرب وتحديداً إسبانيا، والتي كانت تتجسد في طريقة اشتغال من أنشأ هذه المدرسة وهو الفنان الإسباني بيرتوشي، الذي كان مغموراً في بلده باستثناء منطقته الأندلس، حيث لم يأت بتصورات حداثية مسايرة لما كان يجري في الغرب في ذلك الوقت، ولهذا واستنادا للقيمة التاريخية التي تعرفها مدرسة تطوان، حظيت بهذا التصنيف الذي تمثله الواقعية بتقنياتها ومواضيعها التقريرية.
أما بالنسبة للفنان الدريسي فكانت تقنيته مختلفة تماماً، تحمل في طياتها بعداً فنياً، يتعلق بحضور الإنسان في بعده الوجودي بأسلوب خاص لا يشبه الأساليب الأخرى، سواء بالنسبة للأساليب السائدة بتطوان أو بالنسبة لباقي الاتجاهات العربية أو المغربية الأخرى".
لقد كان رحيل الدريسي إلى طنجة في رأيي بحثاً عن فسحة جديدة للإبداع، فسحة سمحت له بتنفّس هواء جديد، وإن كان قد واصل مساره الأول ذاته من خلال اعتبار الإنسان في تمزقاته وفي مأساوية وجوده حاضراً من خلال لمساته التشخيصية الانطباعية. لكن طنجة أيضاً ستفتح للدريسي فرصة اللقاء مع العديد من المهتمين بالحركة الثقافية والتشكيلية بالمغرب، وبالعديد من المبدعين والكتّاب لعل أهمهم صديقه محمد شكري الذي اقتسم معه بعضاً من بوهيميته وتسكعه، لقد كان الدريسي مثل شكري عصياً على الضبط، يؤمن بحريته التي يرفض أن تكون موضع مساومة.
أذكر لما التقيته بطنجة في أحد المعارض بعد سنوات على لقاءاتنا في المضيق، فقال لي: "أخبرني شكري أنك أتيت لتقيم في طنجة، هذا خبر جميل يسرني، أنت تعرف أنا لم أتغير، ما زلت كما عهدتني أيام كنت في تطوان، وأعطاني بطاقة فيها عنوانه ولوحة جميلة له، قائلاً: "هذا عنواني سأنتظر أن تزورني، لا أحتاج أن أقول لك من أنا، وكيف أرى الحياة والأشياء في هذا العالم، فأنت تعرف كل شيء، سأنتظر أن تزورني...".
تحدثنا عن أشياء كثيرة وضحكنا من العالم ومن البؤس، وانتهى لقاء المعرض. مرّت بضعة شهور قبل أن يفاجئني محمد شكري حينما كنت بصحبته في مطعم الريتز قائلا: عرفتَ الآن لماذا رفضت أن أذهب إلى إسبانيا لما عرضتَ عليَّ أن أحضر ذلك اللقاء الكبير هناك، هل عرفت ما وقع لمحمد الدريسي؟ سألته: ماذا وقع للدريسي؟، فأجابني: ذهب لباريس إلى "مدينة الفنون" لينجز مشروعا بمنحة تلقاها لكنه لم يصل مدينة الفنون، توفي في المترو بسكتة قلبية.
لم أصدق، نزل عليّ الخبر كالصاعقة، لكن شكري كان يتحدث بجدٌّ، قضيتُ تلك اللحظات منزعجا ثم اعتذرت منسحباً... لقد رحل عن عالمنا صاحب الكائنات التي تحتاج إلى دفء الصباح، رحل ببوهيميته وأحلامه الإنسانية التي لن تجد صداها إلا في الفن الذي لا يعرف الحدود، رحل الفنان الذي أغنى بتجربته في المعالجة التقنية للأجساد والأيقونات، وتصوره الجمالي من حيث الفكرة ومن حيث فلسفته في معالجة المواضيع ومن حيث مسيرة حياته بما تحمله من تمرد وشغب ومكابدة، شخصية لا يكتشفها إلا من اقترب منها أو على الأقل من أعمالها الفنية.