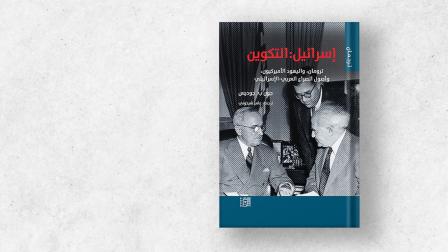يشغل الإسلام أكثر فأكثر حيّزًا كبيرًا في حياتنا، لأسباب لا تخفى على أحد. على أن الأفكار الرائجة عنه وحوله مؤخرًّا، لا تبدو أمينةً لانشغالات بعض الباحثين والأساتذة العرب، من حيث هم يحاولون تبديد صورة الدين الإسلامي التي يستغلّها الإعلام وبعض الشيوخ. فكان هذا اللقاء مع الدكتور، محمّد الحداد، أستاذ التعليم العالي المتخصص في دراسات الحضارة العربية والأديان المقارنة، وأستاذ كرسي اليونسكو للدراسات المقارنة للأديان، إذ يرى أن الدين الإسلامي قابل للتلاؤم مع الديمقراطية. يقول الحداد :"مع الأسف، تماهي الخطابات الغربية، اليوم، بين الإسلام والإسلام السياسي، وترى أن عدم التعارض مع الديمقراطية يعني قبول أحزاب الإسلام السياسي بالقواعد الشكلية للديمقراطية، أي أساسًا الانتخابات، لأن الديمقراطية الغربية ذاتها قد تحوّلت على مدى عقود إلى عمليّة شكلية محورها الانتخابات". وإذ يظهر كلامه هنا كانتقاد للديمقراطية الغربية، فإنه يستدرك قائلًا :"طبعًا الانتخابات أمر مهمّ. لكنها تستمد أهميتها من استقلالية المواطن وحريته ووعيه، أما إذا كان ينتخب بمقتضى فتوى أو أمر، ويعتبر الانتخاب مجرّد وسيلة لإقامة نظام سياسي لا يقوم على المواطنة بل ينفي قواعدها الأساسية، فلا يمكن التحدّث عن ديمقراطية. فأساس الديمقراطية المساواة المدنية والسياسية بين الجميع، ذكورًا وإناثًا، ومتديّنين بدين الأغلبية، ومتدينين بأديان الأقليّات، وأصحاب أملاك وعاملين كادحين. الإسلام يمكن أن يتلاءم مع الديمقراطية إذا استأنف مساره الإصلاحي الذي بدأ في القرن التاسع عشر وتركّز آنذاك على المواطنة، أمّا الإسلام السياسي فإنّ تعامله مع الديمقراطية يتّسم بالتذبذب والانتهازية لأن مرجعياته الأصلية مرجعيات غير ديمقراطية، وهو مطالب بالقطيعة الواضحة مع هذه المرجعيات والتحوّل إلى المرجعية الإصلاحية، أي بعبارة أخرى التخلّي عن كلّ منظّري المرجعيّة الأصولية".
ليس سرًّا تبنّي الدكتور الحداد الفكر المؤمن بحوار الحضارات، خاصّة في ظلّ الظروف الحالية التي لا تشهد الحوار بقدر ما تشهد عكسه، لذا يفضّل الحداد الحديث :"عن الحوار بين الأديان، وأعتقد أن هذه الفكرة تتراجع اليوم، ولا يمكن إلقاء المسؤولية على طرف بعينه، إلاّ أن مسؤولية المسلمين متأكدة من دون شكّ، شيوخ المسلمين يقيمون الدنيا ويقعدونها لرسم نشره شخص غير مسلم في صحيفة غير مسلمة، يقرأها أشخاص غير مسلمين، لكنهم لا يحرّكون ساكنًا أو يكتفون بأضعف وسائل الإدانة عندما يذبّح المسيحيون الموجودون في المجتمعات العربية قبل مجيء الإسلام ، ويهجّرون وتنتهك حرمات نسائهم وبناتهم. الحقيقة أن المسلمين يسكتون اليوم عن حملة تطهير عرقي تطال المسيحيين".
لطالما نادى الدكتور الحداد بتحرير المرأة، ودخل من أجل هذا في مواجهة مع المحافظين، كما أن محتده من أسرة الطاهر الحداد المصلح، الذي كان وراء سنّ مجلة الأحوال الشخصية في تونس، التي منعت تعدّد الزوجات ونظّمت حياة المرأة والأسرة، أثرت كلّها في ما يبدو على نظرته الخاصّة للمرأة وحقوقها، خاصّة وأنه كتب في أحد مؤلفاته أنها "ما زالت الصخرة التي تتحطّم عليها دعاوى التجديد وتنكشف من خلالها النزعة المحافظة في الفكر الديني المعاصر". بيد أن للدكتور حداد تفسيراً اجتماعيّاً إن جاز التعبير لوضع المرأة :"عندما يعجز الرجل العربي عن مواجهة أعدائه، فإنّه يوجّه نقمته إلى المرأة. هذه آلية دفاعية نفسية يستعملها الضعفاء. وبما أن إحباطات العربي والمسلم ما فتئت تتعاظم في العقود الأخيرة، فإن المرأة تتحمّل أكثر فأكثر نتائج هذا السلوك المَرَضي للرجل. والقضيّة في عمقها ليست قضية المرأة بل قضية الرجل العربي المقهور، الذي يعوّض نفسيًّا عن عجزه بدل السعي إلى تجاوز الأسباب الموضوعية لهذا العجز. فوضع المرأة كارثي في أغلب المجتمعات العربية والإسلامية، لكن هناك أيضًا نجاحات. على سبيل المثال، الدستور الجديد، الذي جاء معبّرًا عن إرادة القوى الحية والتقدّميّة في المجتمع أكثر من تعبيره عن الأغلبية السياسية في المجلس، ولم يكن ذلك متاحًا لولا مبادرات الحركة النسائية وحيويتها في تونس".
ومما لا شكّ فيه أن الدكتور الحداد يستند في كثيرٍ من أفكاره إلى معرفته بعلماء الدين العرب القدامى، ويرى فرقًا جوهريًا بينهم وبين علماء اليوم، خاصّة لجهة الإنتاج الفكري والمعرفي. يقول في هذا الصدد : "إذا أخذنا أبا حامد الغزالي مثلًا، بصفته شخصيّة دينية من العصر القديم، فإننا نجد له عشرات الكتب في علوم عصره، وكتابًا واحدًا في السياسة. أمّا إذا أخذنا بعض الشخصيّات التي تنسب إلى الدين اليوم، فلن نجد لها من إنتاج إلاّ الخطابة السياسية والمواقف السياسة، ولا نراها تقدّم أية إضافة بالمقارنة مع العلوم القديمة وأولى طبعًا أن لا يكون لها أي إسهام في العلوم الحديثة. المواقع (الدينية) يحتلّها اليوم الوعاظ أصحاب الخطابات السياسية التحريضيّة، وخطاباتهم انفعالية بحتة لا تقوم على منهجية أو مفاهيم مضبوطة، وهم إفراز لمجتمعات لا يحكمها العقل والعلم وتستورد كلّ حاجياتها من الخارج، ولا تساهم بشيء في الحضارة الكونية. أين نحن من عهد كان فيه كتاب "القانون" لابن سينا المرجع الأوّل في الطب شرقًا وغربًا وكان يدرّس باللّغة اللاتينيّة في الجامعات الأوروبيّة؟". ومع ذلك فإن في كلام الدكتور السابق ما يحيل إلى فكرة رائجة عن أن القرون الأولى التي تلت ظهور الإسلام كانت الأفضل، خاصّة على مستوى حرية التعبير. فهل حدث تقهقر على هذا المستوى أم أن القضية تُطرح بشكل آخر؟. ويميّز الدكتور الحداد هنا بين مستويين قائلًا :"المستوى الأوّل أنّ الفترة المشار إليها، كانت فترة بناء للدولة وللثقافة، ومن الطبيعي أن تكون فترات البناء أكثر انفتاحًا، ثمّ بعد ذلك تصبح الأمور مقنّنة ومضبوطة، وتقلّ إمكانيات الإبداع الفردي. لهذا السبب نرى أن تلك الفترة شهدت تعدّدًا كبيرًا في المذاهب، ومبادرات فكرية متنوعة وجريئة. وفي حدود القرنين الرابع والخامس للهجرة، أصبحت الثقافة الإسلامية مدوّنة ومقننة، وأصبح من يتعاطى علمًا من العلوم مضطرًا للخضوع للقواعد المسطرة سابقًا لهذا العلم، وهذا ما يفسّر لماذا فشلت مشاريع فكريّة جديدة، مثل فلسفة ابن رشد أو علم العمران البشري، الذي اقترحه ابن خلدون، أو فقه المقاصد، الذي عرضه الشاطبي في "الموافقات". فهؤلاء عاشوا بعد عصر التدوين، ولم تعد الثقافة القائمة مستعدة لمراجعة مساراتها ومقولاتها المؤسّسة، لذلك لم تجد مشاريعهم رجع صدى، وإنما أعيد إحياؤها في العصر الحديث بعد أن تهاوت الثقافة التقليدية، وفقدت سيطرتها على الفكر. أمّا المستوى الثاني، أي حرية التعبير الفردية، فإنها ترتبط بتصوّر العلاقة بين الفرد والمجتمع، هل ينصهر الفرد تمامًا في المجتمع أو في مكوناته الأساسية، مثل الأسرة والقبيلة والطائفة؟ أم أنه كائن في ذاته ولذاته لا يتحدّد فكره وتعبيره بانتمائه الجمعي؟. إن تغليب الفرد وحقوقه، ونشأة المثقف كشخص يعبّر عن رأيه، وليس عن ضمير جمعي، والتخفيف من الانتماء إلى المحسوس، مثل الأسرة والقبيلة والطائفة، مقابل الانتماء إلى المجرّد، أي الدولة، هذه كلّها مسارات نجد لها جذورًا منذ القديم، لكنها اتسعت أكثر وتطوّرت في العصر الحديث وأصبحت مكوّنًا رئيسيّا لما ندعوه الحداثة".
بيد أن المقارنة بين الماضي والحاضر، لا يمكن إلا أن تتجه نحو سمات هذا العصر، وتلك التوقعات القائلة بأن تؤدّي الحداثة
وانتشار مجتمع الاستهلاك إلى تحييد العامل الديني. بيد أن المختصين في علوم الأديان والأديان المقارنة، يلاحظون عودةً قوية للدين في حياة الإنسان، وهذا ليس موجوداً فقط في البلدان الإسلامية، بل هو موجود كذلك في البلدان الغربية، وإن كان الأمر متخفّياً في إهاب أحزاب يمينية ومحافظة تتبنى الإرث المسيحي، ومتخفّياً أيضًا في حركات يمينية متطرّفة تسوّق لأفكار على غرار الاختلاف بين الحضارات والتحصّن بالهوية. فهل الأمر مجرد رد فعل على سيطرة المجتمع المادي ومجتمع الاستهلاك أم أن القضية أعمق من ذلك؟. وللإجابة عن هذا يقول الدكتور الحداد :"وجد الدين في كلّ التاريخ، ومنذ بداية وجود الإنسان، وسيظلّ معطى موجودًا إلى نهاية وجود الإنسان على الأرض. لكن وظائف الدين وتجلياته تختلف من مرحلة تاريخية إلى أخرى. وفي العصر الحالي، أصبحت حاجة الإنسان للدين حاجة روحية أساسًا. لأن التقدّم البشري يجعل الإنسان قادرًا على الاضطلاع بنفسه بالجانب التشريعي. إن القضايا الكبرى، على غرار تأويل النصوص المؤسّسة للدين الإسلامي، بصدد التسلل من الجامعات والجوامع والمنتديات العلمية والفكرية المحصنة، التي لا يدخلها إلا من كان عالمًا ومفكرًا وفقيهًا، لتطرح أمام العموم من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية".
ليس سرًّا تبنّي الدكتور الحداد الفكر المؤمن بحوار الحضارات، خاصّة في ظلّ الظروف الحالية التي لا تشهد الحوار بقدر ما تشهد عكسه، لذا يفضّل الحداد الحديث :"عن الحوار بين الأديان، وأعتقد أن هذه الفكرة تتراجع اليوم، ولا يمكن إلقاء المسؤولية على طرف بعينه، إلاّ أن مسؤولية المسلمين متأكدة من دون شكّ، شيوخ المسلمين يقيمون الدنيا ويقعدونها لرسم نشره شخص غير مسلم في صحيفة غير مسلمة، يقرأها أشخاص غير مسلمين، لكنهم لا يحرّكون ساكنًا أو يكتفون بأضعف وسائل الإدانة عندما يذبّح المسيحيون الموجودون في المجتمعات العربية قبل مجيء الإسلام ، ويهجّرون وتنتهك حرمات نسائهم وبناتهم. الحقيقة أن المسلمين يسكتون اليوم عن حملة تطهير عرقي تطال المسيحيين".
لطالما نادى الدكتور الحداد بتحرير المرأة، ودخل من أجل هذا في مواجهة مع المحافظين، كما أن محتده من أسرة الطاهر الحداد المصلح، الذي كان وراء سنّ مجلة الأحوال الشخصية في تونس، التي منعت تعدّد الزوجات ونظّمت حياة المرأة والأسرة، أثرت كلّها في ما يبدو على نظرته الخاصّة للمرأة وحقوقها، خاصّة وأنه كتب في أحد مؤلفاته أنها "ما زالت الصخرة التي تتحطّم عليها دعاوى التجديد وتنكشف من خلالها النزعة المحافظة في الفكر الديني المعاصر". بيد أن للدكتور حداد تفسيراً اجتماعيّاً إن جاز التعبير لوضع المرأة :"عندما يعجز الرجل العربي عن مواجهة أعدائه، فإنّه يوجّه نقمته إلى المرأة. هذه آلية دفاعية نفسية يستعملها الضعفاء. وبما أن إحباطات العربي والمسلم ما فتئت تتعاظم في العقود الأخيرة، فإن المرأة تتحمّل أكثر فأكثر نتائج هذا السلوك المَرَضي للرجل. والقضيّة في عمقها ليست قضية المرأة بل قضية الرجل العربي المقهور، الذي يعوّض نفسيًّا عن عجزه بدل السعي إلى تجاوز الأسباب الموضوعية لهذا العجز. فوضع المرأة كارثي في أغلب المجتمعات العربية والإسلامية، لكن هناك أيضًا نجاحات. على سبيل المثال، الدستور الجديد، الذي جاء معبّرًا عن إرادة القوى الحية والتقدّميّة في المجتمع أكثر من تعبيره عن الأغلبية السياسية في المجلس، ولم يكن ذلك متاحًا لولا مبادرات الحركة النسائية وحيويتها في تونس".
ومما لا شكّ فيه أن الدكتور الحداد يستند في كثيرٍ من أفكاره إلى معرفته بعلماء الدين العرب القدامى، ويرى فرقًا جوهريًا بينهم وبين علماء اليوم، خاصّة لجهة الإنتاج الفكري والمعرفي. يقول في هذا الصدد : "إذا أخذنا أبا حامد الغزالي مثلًا، بصفته شخصيّة دينية من العصر القديم، فإننا نجد له عشرات الكتب في علوم عصره، وكتابًا واحدًا في السياسة. أمّا إذا أخذنا بعض الشخصيّات التي تنسب إلى الدين اليوم، فلن نجد لها من إنتاج إلاّ الخطابة السياسية والمواقف السياسة، ولا نراها تقدّم أية إضافة بالمقارنة مع العلوم القديمة وأولى طبعًا أن لا يكون لها أي إسهام في العلوم الحديثة. المواقع (الدينية) يحتلّها اليوم الوعاظ أصحاب الخطابات السياسية التحريضيّة، وخطاباتهم انفعالية بحتة لا تقوم على منهجية أو مفاهيم مضبوطة، وهم إفراز لمجتمعات لا يحكمها العقل والعلم وتستورد كلّ حاجياتها من الخارج، ولا تساهم بشيء في الحضارة الكونية. أين نحن من عهد كان فيه كتاب "القانون" لابن سينا المرجع الأوّل في الطب شرقًا وغربًا وكان يدرّس باللّغة اللاتينيّة في الجامعات الأوروبيّة؟". ومع ذلك فإن في كلام الدكتور السابق ما يحيل إلى فكرة رائجة عن أن القرون الأولى التي تلت ظهور الإسلام كانت الأفضل، خاصّة على مستوى حرية التعبير. فهل حدث تقهقر على هذا المستوى أم أن القضية تُطرح بشكل آخر؟. ويميّز الدكتور الحداد هنا بين مستويين قائلًا :"المستوى الأوّل أنّ الفترة المشار إليها، كانت فترة بناء للدولة وللثقافة، ومن الطبيعي أن تكون فترات البناء أكثر انفتاحًا، ثمّ بعد ذلك تصبح الأمور مقنّنة ومضبوطة، وتقلّ إمكانيات الإبداع الفردي. لهذا السبب نرى أن تلك الفترة شهدت تعدّدًا كبيرًا في المذاهب، ومبادرات فكرية متنوعة وجريئة. وفي حدود القرنين الرابع والخامس للهجرة، أصبحت الثقافة الإسلامية مدوّنة ومقننة، وأصبح من يتعاطى علمًا من العلوم مضطرًا للخضوع للقواعد المسطرة سابقًا لهذا العلم، وهذا ما يفسّر لماذا فشلت مشاريع فكريّة جديدة، مثل فلسفة ابن رشد أو علم العمران البشري، الذي اقترحه ابن خلدون، أو فقه المقاصد، الذي عرضه الشاطبي في "الموافقات". فهؤلاء عاشوا بعد عصر التدوين، ولم تعد الثقافة القائمة مستعدة لمراجعة مساراتها ومقولاتها المؤسّسة، لذلك لم تجد مشاريعهم رجع صدى، وإنما أعيد إحياؤها في العصر الحديث بعد أن تهاوت الثقافة التقليدية، وفقدت سيطرتها على الفكر. أمّا المستوى الثاني، أي حرية التعبير الفردية، فإنها ترتبط بتصوّر العلاقة بين الفرد والمجتمع، هل ينصهر الفرد تمامًا في المجتمع أو في مكوناته الأساسية، مثل الأسرة والقبيلة والطائفة؟ أم أنه كائن في ذاته ولذاته لا يتحدّد فكره وتعبيره بانتمائه الجمعي؟. إن تغليب الفرد وحقوقه، ونشأة المثقف كشخص يعبّر عن رأيه، وليس عن ضمير جمعي، والتخفيف من الانتماء إلى المحسوس، مثل الأسرة والقبيلة والطائفة، مقابل الانتماء إلى المجرّد، أي الدولة، هذه كلّها مسارات نجد لها جذورًا منذ القديم، لكنها اتسعت أكثر وتطوّرت في العصر الحديث وأصبحت مكوّنًا رئيسيّا لما ندعوه الحداثة".
بيد أن المقارنة بين الماضي والحاضر، لا يمكن إلا أن تتجه نحو سمات هذا العصر، وتلك التوقعات القائلة بأن تؤدّي الحداثة
وانتشار مجتمع الاستهلاك إلى تحييد العامل الديني. بيد أن المختصين في علوم الأديان والأديان المقارنة، يلاحظون عودةً قوية للدين في حياة الإنسان، وهذا ليس موجوداً فقط في البلدان الإسلامية، بل هو موجود كذلك في البلدان الغربية، وإن كان الأمر متخفّياً في إهاب أحزاب يمينية ومحافظة تتبنى الإرث المسيحي، ومتخفّياً أيضًا في حركات يمينية متطرّفة تسوّق لأفكار على غرار الاختلاف بين الحضارات والتحصّن بالهوية. فهل الأمر مجرد رد فعل على سيطرة المجتمع المادي ومجتمع الاستهلاك أم أن القضية أعمق من ذلك؟. وللإجابة عن هذا يقول الدكتور الحداد :"وجد الدين في كلّ التاريخ، ومنذ بداية وجود الإنسان، وسيظلّ معطى موجودًا إلى نهاية وجود الإنسان على الأرض. لكن وظائف الدين وتجلياته تختلف من مرحلة تاريخية إلى أخرى. وفي العصر الحالي، أصبحت حاجة الإنسان للدين حاجة روحية أساسًا. لأن التقدّم البشري يجعل الإنسان قادرًا على الاضطلاع بنفسه بالجانب التشريعي. إن القضايا الكبرى، على غرار تأويل النصوص المؤسّسة للدين الإسلامي، بصدد التسلل من الجامعات والجوامع والمنتديات العلمية والفكرية المحصنة، التي لا يدخلها إلا من كان عالمًا ومفكرًا وفقيهًا، لتطرح أمام العموم من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية".