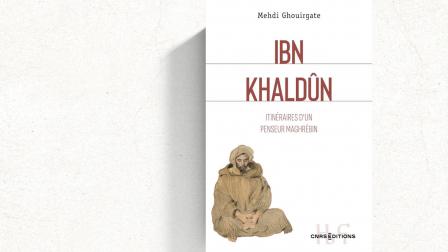تتعطّل أعمال الكرة الأرضية تباعاً هذه الأيام، وكأنها حانة تُطفئ أنوارها بعد ليلة مديدة. بدأ الأمر مع حركة الطيران، وسيلة تسلُّل الفيروس الأولى من الصين إلى العالم على رؤوس الأصابع، ثمّ طاول الأمر كلّ شيء، التعليم والمَعارض الفنية والمهرجانات الاحتفائية بالفن والعلم والمسرح، وصولاً إلى الصلاة وعوالم الرياضة والمناسبات الاجتماعية.
عليك فقط أن تُلقي أذنيك إلى أيّ مكانٍ على جغرافية الأرض الشاسعة لتسمع صفق أبواب تُوصد في كل حدب وصوب، لتُشكّل في نهاية الأمر سيمفونيةً للأبواب الموصدة والشبابيك المقفلة والدورة الأخيرة لعجلات المصانع، وصولاً إلى صوت آخر طائرة تحطّ على وجه الأرض وهي تجهل اللحظة التي ستُقلع فيها من جديد.
إنه موسم مغادرة كل شيء والعودة إلى البيت، إلى الجدران الأربعة؛ ملاذ البشرية الأخير، عندما أصبح التجوّل في الشارع مثل زقاق تقطعه في الحرب الأهلية وتحسم معه الخوف من الإصابة برصاصتين متخاصمتين في سيناريوهات الموت المحتم بالطلقات الصديقة المؤسفة قبل العدوّة المروّعة، ولعل أهمّ ما يحدث هذه الأيام أن شهوة اللجوء إلى بلاد أكثر رخاءً وأقل حرباً وقسوة باتت معدومة... انطفأ حلم حزم الحقائب والوداعات الممسوحة بالنشيج والحزن الذي يحدث قبل مطلع الفجر، واستبدلتها أو استَبدلت نفسها بالركون إلى الانتظار واللاشيء.
إنها اللحظة التي تساوت فيها عوالم الأرض الأولى والثانية، المتقدّمة والنامية، الأكثر ازدهاراً والمعدمة تماماً. أزاح الفيروس التقسيم الطبقي جانباً، وأزاح معه رؤساء دول وملوكها ووزراءها إلى الحجر الصحي والعزل المنزلي والعيادة في أعظم تجلّياتها، لا فروق طبقية وسياسية في احتمالية الاصطدام بوجه الفيروس حديث اللغات البشرية كلّها ومركز ذهنها.
إنها لحظة التوقّف عن الإبداع، عن التفكير في الجمال وتأمّله واقتحام مخابئه واستفزاز مكامنه لصالح جنون الخوف والهلع وخذلان الوقت لصالح التاريخ الذي يصرّ على تكرار نفسه واستدامة قدرته على منحنا المفاجأة التي أطاحت أوهام لحظة انتصار البشرية على الماورائيات لصالح العلم وفانتازيا التنبؤ وخيالات الإنسان الذي لا يموت أبداً.
لقد أعاد الفيروس البشرية إلى الهاجس الكوني الأول منذ الخليقة؛ الفكرة الموحّدة المستغلقة على ذاتها التي جلبت البشرية جمعاء إلى نقطة سوداء واحدة. لم ينجح شيء ومنذ الحرب العالمية الثانية في فعل ما فعله فيروس هذه الأيام، متسلّلاً بالبراعة المتخفّية وباليد الطويلة الماكرة، على طريقة الأشباح، من قارّة إلى قارّة ومن دولة إلى أخرى، ومن الأجساد المترعة بالرعب إلى الأجساد المستكينة للانتظار والاستسلام بلا توقّف أو كلل، راسماً خريطة جديدة للأولويات البشرية التي استغنت عن الخوف بقوّة المعرفة واستعاضت عن غرائز البطش بالتحاليل شديدة الدقّة وذود الأذى بالتطويع لكل شيء.
انقلبت الخريطة رأساً على عقب، وانقلبت معها حياة الإنسان إلى حياة تبحث عن حل، تتبع سيرة حياة الفيروس وردود أفعاله وكأنها تتبّع سلك التوصيل في القنبلة بالحرص والبطء اللازم والصبر.
لم يفرض الفيروس نفسه على جسد العالم ورئتيه وحسب، بل اقتحم ومن جملة ما اقتحم اللغة وما فيها من حوارات على قارعة الطريق وأحاديث ما قبل النوم ومكالمات ما بعد لازمة صباح الخير، واستدعى من جملة ما استدعى دروس الصف الأول ابتدائي عن النظافة الشخصية والوسيلة الأنجع لغسل اليدين والأسلم للعطس، ولعلّ أهمّها اقتصاد المصافحة وبروتوكول القبل الاجتماعية وموضة الكمّامات، وفرض من جملة ما فرض منظومة جديدة للمسلكية الاجتماعية في المناسبات العامة، وكأنّ الفيروس وهو يقدّم نفسه هذه الأيام وباءً عالمياً تأخّرت "منظّمة الصحة العالمية" عن إعلانه لأسباب تخصها، يقدّم نفسه مربّياً جديداً لا يعرف الرحمة للقطيع البشري ابن القرن الواحد والعشرين، فارضاً قوانينه الجديدة عليه بالكثير من الحسم والحزم والقليل الشحيح من العفوية والاندفاع.
لقد أقصت الحالة الجديدة التي فرضها الوباء العالمي الفردية المفرطة وتمثّلاتها من المعيش اليومي والخطابة والسلوك، ولو مؤقّتاً، وما تشتمله هذه الحالة من أنانية ترضى بالذات وتكتفي بها وتتوجّس من المجموعة وتنفر منها، لا تتأمل كونياً ولا تسبر أغوار شيء، لتحلّ محلّها المجموعة الجامعة المحمولة على الكل وما تنطوي عليه من رغبة بالتضامن وسعي أرحب للخلاص.
حضرت فكرة الفناء، وهي فكرة سوداء متعجّلة، جاهزة هذه المرّة، لا على شكل نيزك على رأي المتندّرين بالسخرية من الواقع الأليم، والمستسلمين بالضحك المستحيل على الهزيمة الفردية، بل جاء بكامل هيبته على شكل فيروس يجري في الجسد مجرى الدم، لا تهزمه العضلات ولا الهراوات ولا الصواريخ. لقد جاء بالصدمة المكثّفة التي تلزم "القائمين عليها" بالهدوء والتأمل والتفكير والبحث والعمل تحت وقع الضغط والضربات والصعقات من أجل حل لم تنتظر البشر شيئاً آخر مثله.
* كاتب من فلسطين