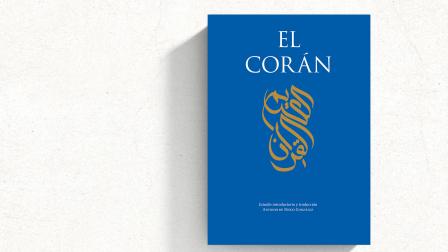بورتريه شخصي للفنان الفرنسي بول غوغان (Getty)
ولد الأمير الفارس في شيزر، ونشأ شاعراً وفارساً ومحارباً ونبيلاً يُشار إليه بالبنان. لم يقوَ "الغرباء" على مسقط رأسه شيزر المنيعة المرتفعة، لكن الطبيعة القويّة زلزلت الأرض قرب نهر العاصي، فاندثر المكان إلى الأبد. فارسٌ ورحالةٌ هو الأمير، تنقل في ربوع بلاد الشام، وقصد مصر إلا أنه عشق دمشق، وفيها مات. يكنيه المستعرب الفرنسي أندريه ميكيل، ضيف ملحق الثقافة لهذا العدد، بالأمير السوري. ولميكيل فضائل كبرى على ثقافتنا، من إحداها ترجمة كتاب "الاعتبار" لأسامة بن منقذ.
أسامة الذي وُلد حين أطلق البابا أوربانوس في كليرمونت خطابه الذي قدح زناد "الغرباء" ليتجهوا صوب أرض العرب، توفي في دمشق بعد أقل من سنة على استرداد القدس من الصليبيين بيد صلاح الدين الأيوبي. كذا قُيض للرجل الذي عاش قرابة مئة عام، أن يرى "عدلاً" ولو قليلاً في حياته المنطبعة بالحروب الصليبية. في كتابه المذكور، انتقد الأمير السوري التفاوت "التقني" لو جاز التعبير، في أسلحة الحرب بين العرب والغرباء. وكتب عن طباع هؤلاء "الفرنجة"، هو الذي عاشرهم وعرفهم وأقام بينهم.
اقرأ أيضاً: المعهد الفرنسي بدمشق
ليس المقال في مديح الأمير السوري، وهو يستحق ما أعلى من المديح، بل في خيار المستعرب الفرنسي ميكيل، الذي أراد من خلال ترجمة "الاعتبار" إلى لغة موليير، وضع الرواية الموازية للمدونّة الصليبية الغربية الهائلة، التي برّرت باسم الدين المسيحي، غزوها للأرض العربية، وإقامتها خصوصاً عند الشاطئ النحيل للبحر الأبيض المتوسط، "مواقع صليبية".
للدين حال كان "كوضع السيف في موضع الندى"، ضررٌ لا يخفى، ربّما من أجل هذا كان الشعراء العرب إبّان الحروب الصليبية نبلاء في استعمالهم للمفردات، إذ كانوا واقعين في رهان عسير؛ الغزاة يحملون الصليب ويحتكرون الدين المسيحي، وأهل المكان طوروا هوية شعرية مقاوِمة، قامت على الإكثار حدّ الإفراط في استعمال المفردات الدالّة على الإسلام. شيءٌ كردّ فعل، شيءٌ تقوم به الجماعات الأضعف. لكن أهل المكان أدركوا واقعهم البشري المختلط أجناساً وأعراقاً وأديان. فحاذروا في شعرهم، المعبّر عن هويتهم، الإساءة إلى إخوانهم في المكان؛ المسيحيين العرب. النظر في تلك القصائد العربية إبّان الحروب الصليبية، ينمّ عن "كياسة بلاغية"، فهذا الشعر الحربي المقاوم، ميّز الغزاة بأسماء ابتدعها لهم ؛ الفرنجة، وبنو الأصفر، وربطهم بالصليب - مثلما شاؤوا - وبمفردات الكفر والشرك وغيرها، لكنه حفظ للمسيحيين العرب، الواقعين في مرمى "التخوين"، مفردات وقصائد تفصل المسيح عن الصليبيين، فنجده تحت اسمه العربي؛ عيسى. وفي غير ما قصيدة وُضع المسيح لصق النبي محمّد، وتم الإعلاء من شأن "معجزته" في إحياء الميت.
وليس الأمر فعلاً من قبيل "الكياسة البلاغية" وحدها، بل هو أيضاً وليد الوعي بتجنب استعمال ما يسيء للأخوة في المكان. وعيٌ نفتقده اليوم بالطبع وقد غزا "غرباء" من كلّ لون سورية، وصار من المقبول والمتعارف عليه استعمال مفردتي الطائفية والأقليّات في الإعلام. لفظان "حديثان" يفتقران إلى الكياسة والتهذيب، على أقلّ تقدير، فاللفظ العربي التراثي المستعمل في وصف جماعات متآلفة ضمن رقعة جغرافية محددة، هو البلدانيّات. أما مصطلحا "الجغرافيا البشرية" و"الجغرافيا الإقليمية"، فمصطلحان غربيان حديثان منبثقان عن تشعب مجالات علم الجغرافيا في القرن العشرين، والأوّل منهما هو الذي استعمله الفرنسي أندريه ميكيل عنواناً لأحد أهمّ كتبه: الجغرافيا البشرية في العالم الإسلامي حتّى القرن الحادي عشر؛ القرن الذي شهد قدوم الغزاة إلى أرضنا. وكان ميكيل وما زال مفتوناً بـ "أكبر جغرافي عرفته البشرية قاطبة" المقدسي، صاحب "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم".
غريبٌ أمرُ هذا المستعرب، الباحث الدؤوب، ذي الانتاج الغزير، غريبٌ كم هو عاشق للثقافة والحضارة العربية والإسلامية. علاقته الوثيقة مع الكاتب الفذّ جمال الدين بن شيخ، تستحق وحدها تأمّلاً في معنى الشغف بالمعرفة والإخلاص.
كخزائن الكنوز والجواهر، ينفتح الحوار مع أندريه ميكيل، ليرسم صورة "عربية" ما أبعدنا عنها اليوم، ولعلّها من السوء حدّ أننا لن نجد ولا حتّى مرآة مكسورة مشظاة، تعكسها.
إلا أن الأمل واجب، يطلع فجأة من ثنيّات طريق الكلام، كذا يصير إذ يقول أندريه ميكيل: "في دمشق انتفض التاريخ بأكمله أمام عيني"، وكذا يصير إن قرأنا السيرة الذاتية للأمير السوري أسامة، سيرة عنوانها معبّر بصورة تفوق الوصف: كتاب الاعتبار.
أسامة الذي وُلد حين أطلق البابا أوربانوس في كليرمونت خطابه الذي قدح زناد "الغرباء" ليتجهوا صوب أرض العرب، توفي في دمشق بعد أقل من سنة على استرداد القدس من الصليبيين بيد صلاح الدين الأيوبي. كذا قُيض للرجل الذي عاش قرابة مئة عام، أن يرى "عدلاً" ولو قليلاً في حياته المنطبعة بالحروب الصليبية. في كتابه المذكور، انتقد الأمير السوري التفاوت "التقني" لو جاز التعبير، في أسلحة الحرب بين العرب والغرباء. وكتب عن طباع هؤلاء "الفرنجة"، هو الذي عاشرهم وعرفهم وأقام بينهم.
اقرأ أيضاً: المعهد الفرنسي بدمشق
ليس المقال في مديح الأمير السوري، وهو يستحق ما أعلى من المديح، بل في خيار المستعرب الفرنسي ميكيل، الذي أراد من خلال ترجمة "الاعتبار" إلى لغة موليير، وضع الرواية الموازية للمدونّة الصليبية الغربية الهائلة، التي برّرت باسم الدين المسيحي، غزوها للأرض العربية، وإقامتها خصوصاً عند الشاطئ النحيل للبحر الأبيض المتوسط، "مواقع صليبية".
للدين حال كان "كوضع السيف في موضع الندى"، ضررٌ لا يخفى، ربّما من أجل هذا كان الشعراء العرب إبّان الحروب الصليبية نبلاء في استعمالهم للمفردات، إذ كانوا واقعين في رهان عسير؛ الغزاة يحملون الصليب ويحتكرون الدين المسيحي، وأهل المكان طوروا هوية شعرية مقاوِمة، قامت على الإكثار حدّ الإفراط في استعمال المفردات الدالّة على الإسلام. شيءٌ كردّ فعل، شيءٌ تقوم به الجماعات الأضعف. لكن أهل المكان أدركوا واقعهم البشري المختلط أجناساً وأعراقاً وأديان. فحاذروا في شعرهم، المعبّر عن هويتهم، الإساءة إلى إخوانهم في المكان؛ المسيحيين العرب. النظر في تلك القصائد العربية إبّان الحروب الصليبية، ينمّ عن "كياسة بلاغية"، فهذا الشعر الحربي المقاوم، ميّز الغزاة بأسماء ابتدعها لهم ؛ الفرنجة، وبنو الأصفر، وربطهم بالصليب - مثلما شاؤوا - وبمفردات الكفر والشرك وغيرها، لكنه حفظ للمسيحيين العرب، الواقعين في مرمى "التخوين"، مفردات وقصائد تفصل المسيح عن الصليبيين، فنجده تحت اسمه العربي؛ عيسى. وفي غير ما قصيدة وُضع المسيح لصق النبي محمّد، وتم الإعلاء من شأن "معجزته" في إحياء الميت.
وليس الأمر فعلاً من قبيل "الكياسة البلاغية" وحدها، بل هو أيضاً وليد الوعي بتجنب استعمال ما يسيء للأخوة في المكان. وعيٌ نفتقده اليوم بالطبع وقد غزا "غرباء" من كلّ لون سورية، وصار من المقبول والمتعارف عليه استعمال مفردتي الطائفية والأقليّات في الإعلام. لفظان "حديثان" يفتقران إلى الكياسة والتهذيب، على أقلّ تقدير، فاللفظ العربي التراثي المستعمل في وصف جماعات متآلفة ضمن رقعة جغرافية محددة، هو البلدانيّات. أما مصطلحا "الجغرافيا البشرية" و"الجغرافيا الإقليمية"، فمصطلحان غربيان حديثان منبثقان عن تشعب مجالات علم الجغرافيا في القرن العشرين، والأوّل منهما هو الذي استعمله الفرنسي أندريه ميكيل عنواناً لأحد أهمّ كتبه: الجغرافيا البشرية في العالم الإسلامي حتّى القرن الحادي عشر؛ القرن الذي شهد قدوم الغزاة إلى أرضنا. وكان ميكيل وما زال مفتوناً بـ "أكبر جغرافي عرفته البشرية قاطبة" المقدسي، صاحب "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم".
غريبٌ أمرُ هذا المستعرب، الباحث الدؤوب، ذي الانتاج الغزير، غريبٌ كم هو عاشق للثقافة والحضارة العربية والإسلامية. علاقته الوثيقة مع الكاتب الفذّ جمال الدين بن شيخ، تستحق وحدها تأمّلاً في معنى الشغف بالمعرفة والإخلاص.
كخزائن الكنوز والجواهر، ينفتح الحوار مع أندريه ميكيل، ليرسم صورة "عربية" ما أبعدنا عنها اليوم، ولعلّها من السوء حدّ أننا لن نجد ولا حتّى مرآة مكسورة مشظاة، تعكسها.
إلا أن الأمل واجب، يطلع فجأة من ثنيّات طريق الكلام، كذا يصير إذ يقول أندريه ميكيل: "في دمشق انتفض التاريخ بأكمله أمام عيني"، وكذا يصير إن قرأنا السيرة الذاتية للأمير السوري أسامة، سيرة عنوانها معبّر بصورة تفوق الوصف: كتاب الاعتبار.