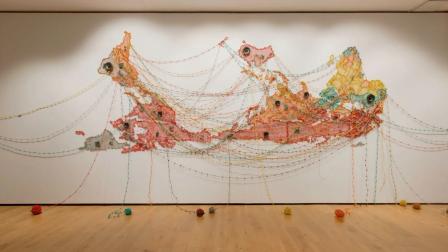لم تكن تجربة محاورة الشاعر الفرنسي كالفي (1980) ونقل بعض أشعاره إلى العربية، سوى محاولة ترجمة، لكنّ الجميل بيننا كصديقين جديدين، الكلمات، الترجمات، العبور بين ثقافتينا وحضارتينا، بين الشمال والجنوب، بين ضفّتي المتوسّط، كان عاديّا، بديهيّا، حميميّا، أخويّا، ضاربا في الإنسانيّة.
كان الحوار بيني وبين صاحب "من رماد وزبد، مدينة" (صدر في 2016، للاحتفاء بـ الثورات التي شهدها عدد من البلدان العربية في السنوات الأخيرة) يشبه طريقا ملكيّا والحال أنّ بيننا طرقا ومسالك وعبورا وجسورا وذلك منذ ألف عام ونيف، فبالرّغم من الحوارات والحروب والتّاريخ المشترك، بدا لنا أنّنا كتونسي وفرنسي نجهل كلّ شيء الواحد عن الآخر، والقليل الّذي نعرف يُفشل الحوار ولا يغذّيه.
كما أنّنا انتبهنا أنّي أنا كمُسْتَعْمَرْ قديم أعرف أكثر بكثير عن لغة وثقافة وتاريخ وجغرافيا مُستَعْمِرِي السابق، زيادة على أنّي أكتب بلغته وأترجم إليها. قلتُ لصديقي فنسان أنّي منذ وطئت أقدامي الأرض الفرنسيّة، انتبهتُ لهذه المعضلة التي تتمثّل في اعتبار أنّ كلّ ما يأتي من الخارج مصدر سوء.
كما لو أنّ ما عبّر عنه الإغريق القدامى بالـ"كسينوفوبيا" أو كره الأجانب/الغرباء لا يزال سائر الفعل، في حين نعلم جميعا أنّ فرنسا كدولة وكفكر وكثقافة وكتجسيد لفكر الأنوار وحقوق الإنسان، إلخ. ليست سوى تركيبة أو "كيمياء"، على حدّ قول رامبو، لعب فيها الوافدون إليها من الشّرق والغرب دورا مفصليّا لا غبار عليه. فما هي فرنسا بدون الرّوس والبولونيّين والإيطاليّين والبرتغاليّين والإسبان والآسيويين والأفارقة والعرب؟
■ تعرّفنا إليك وإلى تجربتك خلال مهرجان أصوات المتوسّط في مدينة سيت صائفة 2016، هل بإمكانك أن تحدّثنا عن هذه التّجربة؟
هي تجربة قويّة على كلّ المستويات. في البداية، من حسن حظّي أن أقرأ شعري في مهرجان دولي يُعتبر من أهمّ التظاهرات الأدبية في فرنسا. بقطع النظر عن الجانب النرجسي، كانت في نظري فرصةً لإجراء لقاءات رائعة مع شعراء موهوبين، ووُلدت صداقات عديدة ومتميّزة؛ مثل العراقي كاظم خنجر، والفلسطيني طارق العربي، والسورية هالا محمد، ومواطنتيَّ الفرنسيّتين ألبرتين بينيدتّو وإيمانويل غواتاري. وكذلك مع ناشرين. وُلدت إذن صداقات ومشاريع كتابة. أظنّ أنّ هذا المهرجان مكّنني من تجاوز مرحلةٍ في مشواري الأدبي وسيبقى تجربة راسخة في ذاكرتي.
■ في وقت وجيز تمكّنتَ من خلق صداقات مع الشّعراء العرب المشاركين في التظاهرة، وأهديت البعض منهم قصيدة "أنتم". ما سرّ هذا التعلّق بالعالم العربي، علما أنّك لا تتكلّم العربية؟
لا أتكلّمُ العربية، لكنني أهتمّ كثيراً بالشعر العربي. وبعد المهرجان، اهتممتُ به بطريقة أكبر. في البداية، تمكّنتُ من اقتناء كتب الشعراء الذين تعرّفتُ إليهم، ثمّ بتعميق معرفتي بهذا الشعر. أنا شغوف بالشعراء الملتزمين بقضايا فعلية وواقعية، كالقضية الفلسطينيّة أو الربيع العربي، أو ضدّ الإرهاب وداعش، والذين يتكبّدون عناءً حقيقياً في عالم تزداد خطورته يومياً. هذا يذكّرني بالتزام الفنّانين والأدباء الفرنسيّين خلال الحرب العالمية الثانية، وبطريقة أوسع خلال الفترة الحديثة، خاصّة السرياليّين الذين أكنّ لهم حباً كبيراً، لأنّهم قاوموا المنظومة البرجوازية والقمع الأيديولوجي والديني والسياسي. اليوم، في فرنسا، الشعراء "متبرجزون" و(يتمعّشون) من طاولة المؤسّسات والجامعات ودُور الشعر المزعومة. لا وجود لالتزام حقيقي، لا قضايا عاجلة للدفاع عنها. ولدينا ثوريّون مزعومون ليسوا بارعين إلّا في احتساء الكوكتيلات في باريس، بأجساد تنعم في الحرير وبأكواب شامبانيا في اليد... أرى أنّ لالتزام الشعراء معنى فعلياً في العالم العربي اليوم، وهو ليس كذلك في فرنسا.
■ لا تزال صغير السن نسبياً، لكنّك نشرت عشرات المنشورات بين كتب ومجموعات شعرية. متى شرعت في الكتابة؟ كيف تكتب وتشتغل؟ وكيف تنظر إلى الإبداع الشعري؟
أكتبُ منذ سن السابعة عشرة، لكني لم أنشر إلّا سنة 2006، أي في سن السادسة والعشرين. كان كتاب "وحدة الضفاف" عن "منشورات أونكر إي لوميار"، وهي دار نشر صغيرة في منطقة "الغار" جنوب فرنسا، يشرف عليها جون كلود برنار، وتحصّل هذا الكتاب على جائزة مدينة بيزيي.
تمكّنتُ منذ عشر سنوات من تطوير تجربتي ومن تكوين حلقة من العلاقات والصداقات. توجد دور نشر صغيرة وجدية تتعامل معي بانتظام. عموماً، أكتب على الكمبيوتر، لفترات قصيرة، خلال العطل المدرسية في غالب الأوقات، لأنّي أكتبُ بسرعة. أكتبُ في حالة من الحمّى الإبداعية، تحت إملاءات لا وعيي، ثمّ أترك النصّ جانباً. قليلا ما أُصلحُ نصّاً. أرفضُ فقدان اللون الأصلي. هذا ما يعطي طابعاً عفوياً لشعري.
لقد تأثّرتُ كثيراً بالسرياليّين وأتّفقُ مع نظرة بول فاليري التي مرّت إلى أندري بروتون فـ إيف بونفوا: "الصوت يسبق المعنى". هكذا أكتب: موسيقى صغيرة تشرع في التحرّك في رأسي وأُجبر نفسي على تتبّعها، كلمة أو اثنتان تفرض نفسها كنقطة بداية، وموسيقاها في لا وعيي تنادي صوراً، وهي كلمات جديدة، فأصوات أخرى وهكذا دواليك... هي ليست بالتحديد كتابة أوتوماتيكية بالمعنى الشائع للكلمة.
يجب الرجوع إلى "حوارات 1952" لـ بروتون لفهم ما أقول، وهو كتاب يُصلحُ فيه مجموعة من الأفكار الخاطئة عن السريالية؛ كالكتابة الأوتوماتيكية. هذا ما توصّل إليه بعد ذلك جاك درّيدا في "الكتابة والاختلاف". الكتابة الشعرية تجمع بين نوعَين من الفكر: الفكر المتقارب (وهو فرضي استنتاجي) والفكر المتباعد (المبني على المتشابه).
المبدأ هو التالي: التوفيق بين مراحل من "الإرخاء اللاّشعوري" حيث يتمكّن اللاّوعي من التعبير، وحالات من "السلطة الواعية" تعود فيها العقلانية للتحكّم في الكتابة. هذا يُشبهُ فارساً يمتطي جواداً، فهو أحياناً يطلقُ له العنان كي يجنّ جنونه، يُسرع، يطير، وأحياناً يُمسك بناصية الأمور كي يتحكّم في الوجهة والحركة والمسار. إذن نشرَعُ أحياناً في الإصغاء إلى اللاّوعي وأحيانا نغلقُ حرفيّاً الخطّ.
■ ما هي اختياراتك الجمالية والسياسيّة؟ هل للأحداث، للأخبار، لصوت وربّما صخب العالم صدى في كتاباتك؟
كما سبق وذكرت، تأثّرتُ كثيراً بالسرياليّين، خاصة بـ بروتون. لكن كلّ الطلائع الأدبية تعنيني، من الدادائية إلى شعراء الفكر الجديد مرورا بـ "الشعر الجديد". بخصوص الإبداع المعاصر، لا أودّ الارتباط بمدرسة أو بتيار محدّد. أقطع طريقي بمفردي. على الآخرين أن يضعوني في خانة ما. بما أنّي قريب من بول ساندا، يمكن اعتباري مما بعد السريالية. لم لا؟ في الحقيقة أكره الملصقات. أريد أن أكون دائماً حيث لا ينتظرونني. أرفض الركود.
في ما يخصّ أفكاري السياسية، تصعبُ عليّ إجابتك. أنتمي قطعاً إلى اليسار، لكن لا تعجبني أفكار وأفعال اليسار الرسمي، خاصّة "الحزب الاشتراكي الفرنسي". ربّما أكون قريباً من جان لوك ميلونشون دون الجانب المعادي للدين وللكنيسة. ربما أنا فوضويّ لا يرفض تماماً الدين والأخلاق. على طريقة ألبير كامو. مع شكل من الفوضويّة الفرديّة على طريقة ستيرنر. لكنّي لم أحدّد بطريقة دقيقة كلّ ذلك.
للرجوع إلى سؤالكم، نعم لأحداث الساعة حضور فعّال في أشعاري، خاصّة في كتابي الأخير "من رماد وزبد، مدينة"، الصادر في 2016. هذا أمر جديد بالنسبة إليّ. ما شغل بالي خاصّةً تدميرُ المدن بفعل الرأسمالية الجديدة المفرطة والمشطّة، وبسبب تفاقم التفاوت الاجتماعي والفقر في العالم، بسبب الإمبريالية الأميركية وسيطرتها المادية والعسكرية في مناطق عديدة من العالم. الوضع المزري في الشرق الأوسط، (خصوصاً الوضع الفلسطيني)، بسبب تطوّر التطرّف الديني والإرهاب.
للأسف، يبدو أنّ العالم يذهب من السيّئ إلى الأسوأ كما لو أنَّ منطقاً لما بعد الأسوأ كان حيّز التنفيذ. الشعر يُمثّل أملاً لي. وإن لم يتمكّن الشعر من إنقاذ العالم، فبإمكانه على الأقل أن يلعب دوراً ضدّ حالة الانحلال التي نعيش، حالة تفاقم الشرّ هذه.
■ من هم آباؤك في الشعر؟ هل لك مدرسة أو منهج معيّن؟ وهل يمكن أن نكون أحراراً ونتمكّن في الآن ذاته من فرض أنفسنا؟
كما قلت وسأعيد، السرياليّة عشقي. أنا قارئ محبّ لـ بروتون وكذلك لـ فاليري الذي علّم كلّ شيء لهذا الأخير. لستُ للأسف شغوفاً بـ بونفوا بسبب ثقافته المتزمّتة. لي ولع كبير بشعراء مدرسة "الفكر الجديد"، وهم ليسوا مشهورين كثيراً؛ مثل ليون بول فارغ، وماكس جاكوب، اللذين فتحا طرقاً حقيقية للحداثة.
لست أدري بعد إلى أيّة مدرسة أنتمي. هل هي مدرسة أم كاتدرائية أم معلّم؟ لست أدري. كلّ هذا يقلقني. يقعُ ربطي بما بعد السرياليّة بسبب علاقتي بـ بول ساندا، على طريقة ساران ألكسوندريان. لكن لستُ مثله مولعاً بالأمور الباطنية. في الحقيقة، أنا وفيّ لثقافتي الكاثوليكية. لا، نعم، لا أؤمنُ أنّه بإمكاننا أن نكون مستقلّين، أؤمن أن الصداقة أو الزمالة واجبة. في غالب الأمر، يقع ذلك حول دار نشر. دار "رافائيل دي سورتيس" و"لا رومير ليبر" تمكّناني مثلاً من أن أكون محاطاً بأناس يروقون لي، بأناس يشبهونني، وبالتّالي بأناس يثيرون إعجابي.
■ كلمة أخيرة؟
في جعبتي ثلاثة شواهد ستنال إعجابك. الأولى للفيلسوف الألماني إيمانويل كانط: "فلتفعل حسب حكمة إرادتك الشخصية حتّى تصير حكمة جماعية". الثانية للفيلسوف الفرنسي بول ريكور: "وجه الآخر صحراء سيناء تمنعُ قتل الآخر". والأخيرة وهي لمعلّمي أندري بروتون: "كما الحبُّ في الفراش الشعرُ".