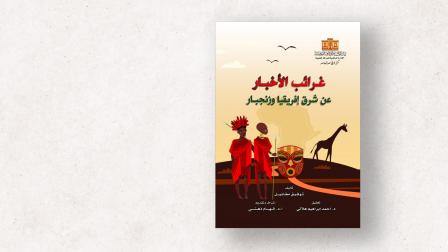كنتِ في السابعة من عمرك.
شجرة البرتقال في حديقة مقر المندوب السامي الفرنسي ـ وقد صار سفارة فرنسا بعد الاستقلال ـ تطلُّ بأغصانها الكثيفة على باحة دار أبيك المجاور. وها هي تحمل ثمراتها الشهية، تنعمين النظر فيها وتخفين في نفسكِ ما لا يمكن لكِ أن تبديه لأحدٍ من حولك، بانتظار اللحظة الملائمة.
ما أكثر ما أغرتكِ هذه الثمرات تتدلى وكأنها تناديكِ! وها أنتِ، باكراً ذات صباح، تتسلّقين الجدار الفاصل وقد زُيِّنَ لك أن الجميع نيام هنا وهناك. تودين أن تفاجئي أمك ببعض هذه الثمرات التي كانت تتمنى لو كانت في باحة دارها، وأن تقطفي بعضاً منها على حذر وفي غفلة من الجميع. وها هي يدك الصغيرة تمتدّ وقد تمكنتِ من أحد الأغصان القوية تقطفين أوّل برتقالة وتلقينَ بها إلى سلة وضعتِها أسفل الجدار. فجأة تشعرين بنفسك محمولة من خصرك بيد قوية. تلتفتين فلا ترين إلا عينيْن براقتين ووجهاً أسود البشرة وصوتاً يقول لك كلمتين ستحفظينهما طوال حياتك: جوتي آترابيه! (أمسكتُ بكِ) يكررها مراراً بينما تحاولين الخلاص من ذراعه عبثاً. لكنه يشجعك إذ يمدُّ لكِ بيده الأخرى برتقالة ثم اثنتين لكنك ترفضين أخذها منه. تحاولين الإفلات عبثاً من ذراعه مرة أخرى. ولا تستطيعين. كانت يدُ فرنسا كلها تمسكُ بكِ ولا تستطيعين فكاكاً منها. أهوَ فرنسيٌّ فعلاً؟ لكنه كان أسود البشرة! من يكون إذن؟ كان لسانك قد تحجّر في فمك. لا تستطيعين كلاماً أو صراخاً ولا حركة. لا لغة بينكما. لم تكن الخشية منه بل من أن تراك أمُّك بين يديه! ما الذي سيحدث لها لو رأتكِ. لكنه وقد فقد الأمل في طمأنتكِ، يحاول ثانية أن يضع يديك على غصن الشجرة والجدار كي تعودين أدراجك من حيث أتيتِ. سرعان ما أدركتِ مُرادَهُ فانزلقتِ نحو أسفل الجدار بينما كان يرمي إليك ببرتقالات ثلاث وهو يقهقه هذه المرّة بصوت سمعه الجميع، أخيراً.
قصصتِ عليَّ قصتك هذه مع فرنسا يوم قلتُ لك رغبتي في إتمام دراستي بباريس. كنت تخافينها خوفك من الجندي السنغالي الذي أمسك بكِ يومها وتجسَّدت لكِ فرنسا فيه. كنتِ تخافين. لكنه خوف الأم تتغلب عليه رغبتها في أن ترى ابنها يحقّق ما حلمت بتحقيقه يوماً، يومَ كنتِ لا تزالين تحاولين.
كنتُ في إجازة دمشقية صيف عام 1978 يوم طلبتِ إليّ أن أرافقك صحبة طريق بينما تقومين بأداء واحدة من الوظائف التي كانت تلقى إليك على غير انتظار. تفتحين خزانتك الخشبية وتتناولين منها لفافة قماشية سميكة تضعينها في كيس بلاستيكي ليسهل حملها. نسير على أقدامنا باتجاه حي العفيف. وتحدّثينني عن الفقراء الذين "يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف" والذين يمكن أن نعرفهم "بسيماهم" فهم "لا يسألونَ الناس إلحافا".
كنا نقف على منعطف شارع العفيف الصاعد باتجاه حي المهاجرين، والمنحدر نحو الجسر الأبيض. كانت سيارات التاكسي تتتالى. كنتِ كلما حاولتُ إيقاف أحدها تمسكين يدي: ليس هذا! أقول لكِ: إنها فارغة! لكنكِ تجيبينني باطمئنان عميق: انتظر. وتمرّ السيارات الصفراء كبيرة أو صغيرة، فارغة من الزبائن. أنظرُ إليكِ متسائلاً. فجأة تقولين لي: أوْقِفْ هذا. كانت سيارة أمريكية صفراء اللون تعود إلى بداية الخمسينات من القرن الماضي تسير ببطء وراء شاحنة متوسطة الحجم تنوء بما تحمله. أشيرُ إلى السائق بالتوقف فيقترب من مكاننا على الرصيف.
حين جلسنا في المقعد الخلفي، سأل السائق: إلى أين؟
أجبتِ: "ابني. ابدأ أولاً بجعلي أرى بحرات دمشق. سأدفعُ لكَ عن كل بحرة تجعلني أراها خمساً وعشرين ليرة!
سرعان ما أجاب السائق جذلاً، وقد حسبك تمزحين: إذن إلى السبع بحرات!
فأجبت بالسرعة نفسها: إذن صار لك بذمتي مائة وخمس وسبعون ليرة!
وراح السائق يتذكر أين توجد البحرات في دمشق. ويسرد أسماء الأحياء واحداً بعد آخر، كأنما يبغي مساعدة منكِ أو مني. لاذَ كلانا بالصمت، كما لو كنتِ تمتحنين معرفته بشوراع دمشق وساحاتها.
وكان المبلغ يزيد كلّما هتف: وهذه بحرة.
وفي إحدى المرات قلتِ له: هنا توجد بحرتان. إذن خمسون ليرة!
حين قال لك: لم أعد أعرف إن كان هناك بحرات أيضاً، مددتِ له يدكِ بثلاثمائة وخمس وسبعين ليرة، وقلتِ: هذا حسابك. الآن يبدأ حساب جديد من هنا إلى المهاجرين!
أخذ السائق الشاب يجهش بكاء وهو يوقف سيارته على زاوية من الطريق كي لا يعيق السير، وهو يردّد: كيف عرفتِ؟ من قال لكِ؟ كيف؟ كيف؟
حاولتِ تهدئته. عبثاً. نوبة بكاء استمرت دقائق وبدت لنا دهراً.
عندما هدأ، طفق يروي حكايته: "كنت أملك سيارة أنقل بها المسافرين بين بيروت ودمشق. وكان لي في بيروت صديق يستقبلني في شقته كلما اضطررتُ ـ ونادراً ما كنتُ أفعل ذلك ـ لقضاء الليلة في بيروت. قبل شهر صدمتني هنا في دمشق سيارة عسكرية تابعة لسرايا الدفاع. تحطّمت سيارتي كلياً. ورغم أن الصدام لم يكن نتيجة خطئي، نزل الجنود الثلاثة من الشاحنة وانهالوا عليّ ضرباً كيفما اتفق وهددوني بالقتل إن شكوتُ أو زعمتُ أن زميلهم هو المسؤول. هكذا فقدت أداة رزقي في اليوم الذي كان صديقي البيروتي يحضر إلى دمشق هارباً مما كان ينتظره ببيروت، بعد أن دمّرت مدافع الحرب الأهلية شقته في العمارة التي كان يسكنها. لم يكن بوسعي استقباله في بيت أهلي الذي يعيش فيه والداي وشقيقاتي التسع. حين علم أبي بالأمر، طلب إلي استئجار غرفة أسكن بها مع صديقي وأن أجعله يقضي الليلة في الفندق ريثما نعثر على غرفة للإيجار.
في اليوم التالي سكنّا الغرفة معاً. وخلال شهر صرفنا كلّ ما نملكه من نقود. ثم استهلكنا كل مشترياتنا من الغذاء والمعلبات، وكان آخر ما استهلكناه ظهر هذا اليوم، علبة فول مدمّس!
استلقى صديقي بعد وجبة الغذاء مستسلماً إلى قيلولة اعتاد عليها، بينما خرجتُ هائماً على وجهي لا أعرف ماذا ستكون عليه أمورنا هذا المساء.
على طريق الصالحية، سمعتُ أحداً يهتف باسمي صراخاً. ألتفتُ يمنة ويسرة باحثاً إلى أن تبيّنتُ أن المُنادي كان صديقي وكان يقود إحدى سيارات التكسي التي يملكها. تقدّم نحوي وهو يسألني: أين أنتَ يا رجل؟ حكيتُ له قصة سيارتي التي تحطّمت. فما كان منه إلا أن قال: هيا، خذ هذه السيارة واشتغل. كنتُ أقود السيارة لأحدهم لكنكَ أولى بالعمل عليها.
حللتُ مكانه وراء المقود، واتجهت بعد أن أوصلته إلى مكتبه، نحو حي المهاجرين بحثاً عن الرزق حين أوقفني ابنكِ. وها أنتِ أول زبونة لي"
ولا يكفّ وهو يعود بنا إلى حي المهاجرين عن سؤال كان ولا يزال أيضاً سؤالي: كيف عرفتِ، كيف عرفتِ؟
شجرة البرتقال في حديقة مقر المندوب السامي الفرنسي ـ وقد صار سفارة فرنسا بعد الاستقلال ـ تطلُّ بأغصانها الكثيفة على باحة دار أبيك المجاور. وها هي تحمل ثمراتها الشهية، تنعمين النظر فيها وتخفين في نفسكِ ما لا يمكن لكِ أن تبديه لأحدٍ من حولك، بانتظار اللحظة الملائمة.
ما أكثر ما أغرتكِ هذه الثمرات تتدلى وكأنها تناديكِ! وها أنتِ، باكراً ذات صباح، تتسلّقين الجدار الفاصل وقد زُيِّنَ لك أن الجميع نيام هنا وهناك. تودين أن تفاجئي أمك ببعض هذه الثمرات التي كانت تتمنى لو كانت في باحة دارها، وأن تقطفي بعضاً منها على حذر وفي غفلة من الجميع. وها هي يدك الصغيرة تمتدّ وقد تمكنتِ من أحد الأغصان القوية تقطفين أوّل برتقالة وتلقينَ بها إلى سلة وضعتِها أسفل الجدار. فجأة تشعرين بنفسك محمولة من خصرك بيد قوية. تلتفتين فلا ترين إلا عينيْن براقتين ووجهاً أسود البشرة وصوتاً يقول لك كلمتين ستحفظينهما طوال حياتك: جوتي آترابيه! (أمسكتُ بكِ) يكررها مراراً بينما تحاولين الخلاص من ذراعه عبثاً. لكنه يشجعك إذ يمدُّ لكِ بيده الأخرى برتقالة ثم اثنتين لكنك ترفضين أخذها منه. تحاولين الإفلات عبثاً من ذراعه مرة أخرى. ولا تستطيعين. كانت يدُ فرنسا كلها تمسكُ بكِ ولا تستطيعين فكاكاً منها. أهوَ فرنسيٌّ فعلاً؟ لكنه كان أسود البشرة! من يكون إذن؟ كان لسانك قد تحجّر في فمك. لا تستطيعين كلاماً أو صراخاً ولا حركة. لا لغة بينكما. لم تكن الخشية منه بل من أن تراك أمُّك بين يديه! ما الذي سيحدث لها لو رأتكِ. لكنه وقد فقد الأمل في طمأنتكِ، يحاول ثانية أن يضع يديك على غصن الشجرة والجدار كي تعودين أدراجك من حيث أتيتِ. سرعان ما أدركتِ مُرادَهُ فانزلقتِ نحو أسفل الجدار بينما كان يرمي إليك ببرتقالات ثلاث وهو يقهقه هذه المرّة بصوت سمعه الجميع، أخيراً.
قصصتِ عليَّ قصتك هذه مع فرنسا يوم قلتُ لك رغبتي في إتمام دراستي بباريس. كنت تخافينها خوفك من الجندي السنغالي الذي أمسك بكِ يومها وتجسَّدت لكِ فرنسا فيه. كنتِ تخافين. لكنه خوف الأم تتغلب عليه رغبتها في أن ترى ابنها يحقّق ما حلمت بتحقيقه يوماً، يومَ كنتِ لا تزالين تحاولين.
كنتُ في إجازة دمشقية صيف عام 1978 يوم طلبتِ إليّ أن أرافقك صحبة طريق بينما تقومين بأداء واحدة من الوظائف التي كانت تلقى إليك على غير انتظار. تفتحين خزانتك الخشبية وتتناولين منها لفافة قماشية سميكة تضعينها في كيس بلاستيكي ليسهل حملها. نسير على أقدامنا باتجاه حي العفيف. وتحدّثينني عن الفقراء الذين "يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف" والذين يمكن أن نعرفهم "بسيماهم" فهم "لا يسألونَ الناس إلحافا".
كنا نقف على منعطف شارع العفيف الصاعد باتجاه حي المهاجرين، والمنحدر نحو الجسر الأبيض. كانت سيارات التاكسي تتتالى. كنتِ كلما حاولتُ إيقاف أحدها تمسكين يدي: ليس هذا! أقول لكِ: إنها فارغة! لكنكِ تجيبينني باطمئنان عميق: انتظر. وتمرّ السيارات الصفراء كبيرة أو صغيرة، فارغة من الزبائن. أنظرُ إليكِ متسائلاً. فجأة تقولين لي: أوْقِفْ هذا. كانت سيارة أمريكية صفراء اللون تعود إلى بداية الخمسينات من القرن الماضي تسير ببطء وراء شاحنة متوسطة الحجم تنوء بما تحمله. أشيرُ إلى السائق بالتوقف فيقترب من مكاننا على الرصيف.
حين جلسنا في المقعد الخلفي، سأل السائق: إلى أين؟
أجبتِ: "ابني. ابدأ أولاً بجعلي أرى بحرات دمشق. سأدفعُ لكَ عن كل بحرة تجعلني أراها خمساً وعشرين ليرة!
سرعان ما أجاب السائق جذلاً، وقد حسبك تمزحين: إذن إلى السبع بحرات!
فأجبت بالسرعة نفسها: إذن صار لك بذمتي مائة وخمس وسبعون ليرة!
وراح السائق يتذكر أين توجد البحرات في دمشق. ويسرد أسماء الأحياء واحداً بعد آخر، كأنما يبغي مساعدة منكِ أو مني. لاذَ كلانا بالصمت، كما لو كنتِ تمتحنين معرفته بشوراع دمشق وساحاتها.
وكان المبلغ يزيد كلّما هتف: وهذه بحرة.
وفي إحدى المرات قلتِ له: هنا توجد بحرتان. إذن خمسون ليرة!
حين قال لك: لم أعد أعرف إن كان هناك بحرات أيضاً، مددتِ له يدكِ بثلاثمائة وخمس وسبعين ليرة، وقلتِ: هذا حسابك. الآن يبدأ حساب جديد من هنا إلى المهاجرين!
أخذ السائق الشاب يجهش بكاء وهو يوقف سيارته على زاوية من الطريق كي لا يعيق السير، وهو يردّد: كيف عرفتِ؟ من قال لكِ؟ كيف؟ كيف؟
حاولتِ تهدئته. عبثاً. نوبة بكاء استمرت دقائق وبدت لنا دهراً.
عندما هدأ، طفق يروي حكايته: "كنت أملك سيارة أنقل بها المسافرين بين بيروت ودمشق. وكان لي في بيروت صديق يستقبلني في شقته كلما اضطررتُ ـ ونادراً ما كنتُ أفعل ذلك ـ لقضاء الليلة في بيروت. قبل شهر صدمتني هنا في دمشق سيارة عسكرية تابعة لسرايا الدفاع. تحطّمت سيارتي كلياً. ورغم أن الصدام لم يكن نتيجة خطئي، نزل الجنود الثلاثة من الشاحنة وانهالوا عليّ ضرباً كيفما اتفق وهددوني بالقتل إن شكوتُ أو زعمتُ أن زميلهم هو المسؤول. هكذا فقدت أداة رزقي في اليوم الذي كان صديقي البيروتي يحضر إلى دمشق هارباً مما كان ينتظره ببيروت، بعد أن دمّرت مدافع الحرب الأهلية شقته في العمارة التي كان يسكنها. لم يكن بوسعي استقباله في بيت أهلي الذي يعيش فيه والداي وشقيقاتي التسع. حين علم أبي بالأمر، طلب إلي استئجار غرفة أسكن بها مع صديقي وأن أجعله يقضي الليلة في الفندق ريثما نعثر على غرفة للإيجار.
في اليوم التالي سكنّا الغرفة معاً. وخلال شهر صرفنا كلّ ما نملكه من نقود. ثم استهلكنا كل مشترياتنا من الغذاء والمعلبات، وكان آخر ما استهلكناه ظهر هذا اليوم، علبة فول مدمّس!
استلقى صديقي بعد وجبة الغذاء مستسلماً إلى قيلولة اعتاد عليها، بينما خرجتُ هائماً على وجهي لا أعرف ماذا ستكون عليه أمورنا هذا المساء.
على طريق الصالحية، سمعتُ أحداً يهتف باسمي صراخاً. ألتفتُ يمنة ويسرة باحثاً إلى أن تبيّنتُ أن المُنادي كان صديقي وكان يقود إحدى سيارات التكسي التي يملكها. تقدّم نحوي وهو يسألني: أين أنتَ يا رجل؟ حكيتُ له قصة سيارتي التي تحطّمت. فما كان منه إلا أن قال: هيا، خذ هذه السيارة واشتغل. كنتُ أقود السيارة لأحدهم لكنكَ أولى بالعمل عليها.
حللتُ مكانه وراء المقود، واتجهت بعد أن أوصلته إلى مكتبه، نحو حي المهاجرين بحثاً عن الرزق حين أوقفني ابنكِ. وها أنتِ أول زبونة لي"
ولا يكفّ وهو يعود بنا إلى حي المهاجرين عن سؤال كان ولا يزال أيضاً سؤالي: كيف عرفتِ، كيف عرفتِ؟