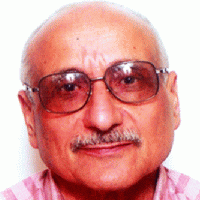عن ماكرون "المنقذ الضرورة"
ماكرون لدى وصوله إلى تكريم وطني لجنود فرنسيين قتلوا في مالي (2/12/2018/الأناضول)
عندما يدلهمّ الخطب، وتسوء الحال، وتضمحل جذوة الأمل، يفقد كثيرون ملكة القدرة على التمييز بين ما هو صواب وما هو خطيئة، ويصبح عندهم التشبث بالوهم أمرا مقبولا، حتى لو أغرقهم هذا الوهم في مصائب أدهى وأمرّ. وعندما يفتقد المواطن رجالا قمما يتطلع إليهم في أوقات الملمّات، على النحو الذي تحدّث عنه أندريه مالرو مرّة، يصبح كل شيء حتى القبول بمرجعية الأجنبي المستعمر مباحا، بل ومطلوبا!
هذا هو ما يمثل اليوم أمام عيوننا، فقد عشنا حتى وجدنا من يطلب من الأجنبي العودة لحكم البلاد، كي يصبح "المنقذ الضرورة". نريده حاكما يصلح أمورنا، ويفتح أمامنا أبواب الخلاص من حكّامنا الذين سامونا سوء العذاب، قتلوا أبناءنا، وانتهكوا حرماتنا، ونهبوا ثرواتنا، وكمّموا أفواهنا، وأحكموا الطوق من حولنا. لم نجد في هذا الزمن الرديء، أحدا يعيننا سوى الغريب البعيد الذي نرفع رؤوسنا نحوه اليوم، كي يمنحنا بعض بركاته، كي يجبر خواطرنا، ويضع الحلوى في أفواه أطفالنا، ويُعلمنا كي نكون بشرا نستحقّ الحياة، ونستحقه "منقذا ضرورة"، ونبايعه على الحلو والمرّ.
هل أصبح مطلوبا أن يشرع السادة الكبار في العالم في "عملية قيصرية" لدويلاتنا التي كانت "دولا" ذات هيبة وقرار، يوم بناها الآباء المؤسّسون؟
هذه الهمهمات المفعمة ببعض الأمل، وهذه الجرعة المرّة من الرومانسية الحالمة التي يُراد منها أن تغلف كل مشاهد السياسة في دويلاتنا التي عاشت على "نوستالجيا" الزمن الجميل الذي لم نعرف كيف نحافظ عليه. هذا كله لم يأت مصادفة، إنما هو جزء مكمل للحل المطروح لنا من خارج الحدود، وقد حلّت ساعة الحل، بعد أن استنفد أهلنا كل آمالهم في مشاريع، قيل إنها تنقذ الوطن والمواطن، وأصبح مطلوبا أن يشرع السادة الكبار في العالم في عملية إنقاذ، لنسمّها "عملية قيصرية" لدويلاتنا التي كانت "دولا" ذات هيبة وقرار، يوم بناها الآباء المؤسّسون. أما اليوم فقد انتزع قرارها وغابت هيبتها، ولم يبق لها غير البحث عن "منقذ ضرورة"، وليكن كائنا من كان.
ولكن، من غير أوروبا، وفرنسا بالذات، تكون الأجدر بقيادة عملية "الإنقاذ"، ونكء الجراح، نيابة عن تحالف الكبار، وهي التي تمتلك الأصابع الحريرية التي ترضي حتى المعارضين لتدخل الغرباء في شؤوننا من ذوي الياقات البيضاء والمحللين السياسيين وأساتذة معاهد السياسة، أقلها أن فرنسا أعطتنا، قبل أكثر من قرنين، الثورة التي وإن اصطبغت بالدم إلا أنها شرعنت حقوق البشر، ورسمت طريق دولةٍ تحترم مواطنها، وتعلمه احترام الآخر.
هل من"تسويات تاريخية" تعيد أوطاننا إلينا، تجذّر حلولا راسخة لأزماتنا، وتقضي على الأمراض التي تنخر في أجسادنا؟
ومن غير مانويل ماكرون يمكنه الإيفاء بمهمةٍ كهذه، وهو الرئيس الشاب الذي يحبنا حبا خالصا لوجه الله، أقله أنه غنّى مع فيروز في دارتها العتيقة "بحبك يا لبنان"، وشرب "القهوة العربية" في واحد من قصور صدّام حسين التاريخية. وعبر هاتين الالتفاتتيْن، نزل من علاه "منقذا ضرورة" ليحفّ ناس بيروت به، وليقف بينهم خطيبا، كما الوالد الذي يؤنّب أولاده القاصرين، متوعّدا بانهيار البيت الذي يؤويهم إذا لم ينصاعوا ويطيعوا، ثم يتركهم إلى بغداد ليكمل مهمته. وفي بغداد، يحتفي به أهل السلطة على نحو ملوكي، وهو يحمل بشرى دعمٍ غير محدود للعراقيين، في بحثهم عن السيادة الضائعة، لكنه يعود إلى بلاده، بعد أن يكتشف أن الأمر أصعب مما توقع وأراد، وأن لبنان لم يعد كما صنعته فرنسا قبل مائة عام، وأن عراق الأمس الذي يعرفه الأبعدون والأقربون هو الآخر قد تغير، ولا سبيل لتسوياتٍ عرجاء، كالتي حذّر منها ماكرون نفسه في كتابه "ثورة" الذي رسم فيه خريطة جديدة لفرنسا، وهو في بدء انغماسه في الهم السياسي، وفي حينه كان دعا للتغيير "عبر تحول ديمقراطي عميق يعتمد على وحدة الفرنسيين وشجاعتهم وإرادتهم المشتركة"، وقد أهلته هذه النظرة للوصول إلى قصر الإليزيه مبكرا.
ولكن هل تمنحنا رؤيته تلك الحق في "الثورة" في بلداننا كي يتم التغيير المطلوب على النحو الذي أراده لبلاده، وأن لا يجيء عبر "تسوياتٍ عرجاء"، إنما من خلال "تسويات تاريخية" تعيد أوطاننا إلينا، تجذّر حلولا راسخة لأزماتنا، تقضي على الأمراض التي تنخر في أجسادنا: الطائفية، والفقر، والفساد، والقمع المبرمج، وتمنحنا حياةً مثل البشر الآخرين: حرية ومساواة وعدالة، وحقوقا كاملة؟
وكما اكتشف ماكرون لدى شعبه "كنوزا من الطاقة لا يعرفها الذين يزعمون التحدّث باسمه"، فإن لدى شعوبنا، هي الأخرى، كنوزا من الطاقة لا يعرفها حكّامنا، وكل ما نتمنّاه أن يكون ماكرون قد فكّر في هذا كله، وهو يطرح نفسه "منقذا ضرورة" لنا!