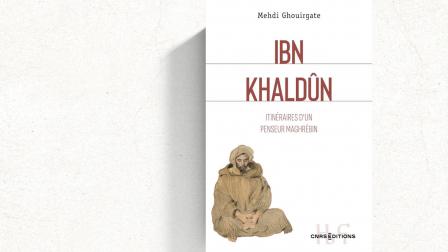لوحة للفنان الصيني شن لين كسين (Getty)
"متوحّداً، يجرّ القطار خلفه بخاره"
تريستان تزارا
إن للصور، المرافقة لنصوصٍ سردية أو شعرية، قوّة كبيرة في شحن مخيلة الأطفال بالأحلام. وليتيقّن الواحد منّا من هذا، فما عليه إلا أن ينقّب قليلاً في تجارب معيّنة من زمن طفولته. في ما يخصني، أذكر جيداً كيف أن الرغبة في السباحة في البحر، مثلاً، وفي السفر بالقطار، وفي الدخول إلى المسرح تولّدت لديّ، في البدء، نتيجة استغراق في تأمّل صور في كتب المطالعة - العربية أو الفرنسية - التي كانت معتمدة لتدريسنا في الابتدائي. أو، على الأقلّ، فإن تلك الرغبات تكون قد تبلورت لدي وتحددت وأصبحت شعورية نتيجة التأمل الشّغوف لتلك الصور.
ما سيحدث، لاحقاً، هو أني سأكتشف الشاطئ وأدلف إلى ماء البحر، المتاخم للرمال لا أبعد، بعد سفرة أولى في قطار. كان ذلك في صيف سنتي الثانية عشرة. ففي ذلك الفصل، جاء لزيارتنا بمدينة اليوسفية - التي يشتغل أغلب سكّانها في مناجم الفوسفات - ابن خالة لوالدي هو سيد أحمد - وهو أيضاً صهر عمّ لي ساكن بالرباط، وقال إنه سيقصد هذه المدينة في اليوم الموالي لزيارة ابنته وزوجها (عمّي الكبير) وأفراد آخرين من العائلة. كان سيد أحمد ذاك إنساناً مرحاً وطيباً، وسيعمّر طويلًا طويلاً، ويبقى صلب البنيان، وبحسّه المرح سيكرّر لسائليه، كلّما سألوه عن سنّه الحقيقية: "ممكن أبونا آدم يكون أكبر مني بشهرين أو ثلاثة!". المهم أنني، خلال ذلك الصيف المذكور، ركبت القطار أخيرًا من اليوسفية، متوجهًا إلى الرباط برفقة سيد أحمد، وفي الرباط كان الشاطئ بانتظاري، إضافة إلى كتب، ببيت عمّي الصغير، كانت تنقلني إلى عوالم فيها حروب وأبطال وسَحَرة وعيّارون وعشّاق، وربما جنّ أيضاً! لقد كانت تلك الكتب تحمل عناوين مثل: "سيف بن ذي يزن"، "سيرة الأميرة ذات الهِمّة"، "الزّير سالم".
ستتلو تلك المرة الأولى مرات ومرات. وقد تكوّنت لدي عادة القراءة في القطار. فقد قرأتُ - كلياً أو جزئيًا - العديد من الكتب على الإيقاع الرتيب، المعدني، لدوران عجلات الحديد على السكة. من بين تلك المقروءات، أذكر: "الدكتور جيفاغو"، "قلب الظّلام" لجوزيف كونراد، وبعض روايات جورج سيمنون، والعديد من الروايات التي تكون قطارات مسرحاً لأحداثها أو مذكورة في عناوينها (أذكر من بينها: "قطار الشرق السريع" لغراهام غرين، و"القطار الأزرق" لأغاثا كريستي)، من دون أنْ أنسى شعر بليز سَنْدرَارْ عن القطار عابرِ سيبيريا.
اقرأ أيضًا: وكانت قفزة العمة أسرع
أكثر من ذلك، فقد بدا لي، وأنا في بدايات الشباب، أني حقاً وجدت لرواية أغاثا كريستي "جريمة في قطار الشرق السّريع"، نكهة مختلفة حين قرأت منها قسماً كبيرًا في مقصورة بأحد القطارات. وبالفعل، ففيما كان القطار واقفاً بي في محطة الدار البيضاء وأنا أقرأ، كان هيركُولْ پْوَارُو، بطل التحريات لدى أغاثا كريستي، يتهيّأ للسفر من محطة حلب صوب إسطنبول، ثمّ يستقلّ القطار ليعود إلى لندن، وفي أثناء تلك العودة، تحدث الجريمة!
*******
لطالما أثارتني تسمية: "سريع الشرق" أو "إكسبريس الشرق"، وبدت لي موحية، في الآن نفسه، بعبق الشرق وسحره، من جهة، وبعالم الصناعات الغربي بأسراره التي لا يزال القسط الأوفر منها مستعصياً على عالمنا الثالث. ومن "أبحاثي" في هذا الشأن، علقت بذهني بضعة أمور، منها: أن "سريع الشرق" الأول أنشئ في 1883، وأنه، بعد أن انتهى زمن خدمة "سريع الشرق" الأول ذاك، أصبحت هنالك كوكبة من القطارات يشكّل تعبير "سريع الشرق" قسماً من اسم كل منها، مثلما ترسخت في ذاكرتي - وهل يمكن إلا أن تترسخ - هذه الحادثة المثيرة التي وقعت في يوم الخميس 6 سبتمبر/ أيلول 1984 بداخل قطار "فنيتسيا سِمْبلُونْ ـ سريع الشرق" (يا للاسم المعقد): فحين آنت لحظة إقلاع هذا القطار من محطة إنْسبورك (بالنمسا) حيث كان قد توقف، فوجئ الميكانيكيون بعدم تمكّنهم من جعل الكوابح تنفك، الأمر الذي بقي معه القطار جاثماً في مكانه! وبدأ المراقبون والميكانيكيون تحريّاتهم، وانتقلوا من عربة إلى أخرى، وفحصوا العجلات، وأخيراً، اكتشفوا لغز استماتة الكوابح في إيقاف القطار: فقد كان هنالك زوجان في آخر العربات، لم يستطيعا التحكم في صبوة ألمّت بهما، فأطلقا العنان لجسديهما اللذين اندمجا في نشاط غرامي لا هوادة فيه، الأمر الذي نتج عنه علوق مقبض جهاز الإنذار بإحدى قدمي السيدة، ما أدّى إلى تشغيل مكبح الإغاثة. وهكذا، سيصل الركاب إلى مقاصدهم متأخرين، ضاحكين، ومن فرط حس الفكاهة الذي استبدّ بهم أطلقوا على القطار، عوض "إكسبريس الشّرق"، تسمية: "سكس - بريس الشّرق"!
اقرأ أيضًا: فتيات نحيلات
*******
ذكرى: في صيف 2010، كنت من بين المدعوين إلى مهرجان "أصوات حية من متوسط إلى متوسط" الذي يقام بمدينة سِيتْ بالجنوب الفرنسي. ولأني كنت سأتوجه من مرسيليا إلى سِيتْ، فإن إدارة المهرجان حجزت لي مقعدًا في القطار إلى جانب مقعدي مشاركتين في الأنشطة الشعرية بالمهرجان المذكور، إحداهما شاعرة من الكيبيك، والأخرى فرنسية. وكنت أنا، قبل تسعة أيام تحديداً من يوم رحلتنا المشتركة تلك، قد توقفت عن التدخين، بعد أن أنذرني طبيب القلب والشرايين بوخيم العواقب إن لم أفعل. في طريقنا، كانت كل من السيدتين تتشكّى من التأثير الضار للتدخين على صحتها، وقالت الشاعرة الكيبيكية إنها تنوي تجريب السيجارة الإلكترونية، وتكلّمت أنا فقلت إنه ليس هنالك ما هو أسهل من الانقطاع عن تلك العادة، وأضفت أنني دخنت لما لا يقل عن خمس وثلاثين سنة، "وها أنا الآن، قلت بنبرة فيها بعض الزهو، قد انقطعت واسترحت!". وقالت السيدة الفرنسية: "سأقتدي بك وأشحذ عزيمتي". لكني ما إن وصلت إلى سِيتْ، والتقيت بمعارف وأصدقاء من الشعراء وغير الشعراء، حتى عدت إلى التدخين. وكثيرا ما كنت أجلس في رفقة الشاعر الإماراتي المرحوم أحمد راشد ثاني، وننصرف إلى التدخين وعبّ الفودكا! وهكذا، أصبحت تلك السيدة الفرنسية، كلما رأتني وأنا منصرف إلى نشاطي ذاك، تأتي وتسدي إلي النصائح، وتطلب مني أن أرعوي فأدخن إن شئت، ولكن من دون إفراط!
*******
وحتى اليوم، كثيراً ما أذكر، حين أمرّ أمام محطة قطار، قولة بول موران Paul Morand التالية: "الفوائد المرتجاة من ورقة يانصيب هي أقلّ من تلك المتوقعة من تذكرة قطار"!
تريستان تزارا
إن للصور، المرافقة لنصوصٍ سردية أو شعرية، قوّة كبيرة في شحن مخيلة الأطفال بالأحلام. وليتيقّن الواحد منّا من هذا، فما عليه إلا أن ينقّب قليلاً في تجارب معيّنة من زمن طفولته. في ما يخصني، أذكر جيداً كيف أن الرغبة في السباحة في البحر، مثلاً، وفي السفر بالقطار، وفي الدخول إلى المسرح تولّدت لديّ، في البدء، نتيجة استغراق في تأمّل صور في كتب المطالعة - العربية أو الفرنسية - التي كانت معتمدة لتدريسنا في الابتدائي. أو، على الأقلّ، فإن تلك الرغبات تكون قد تبلورت لدي وتحددت وأصبحت شعورية نتيجة التأمل الشّغوف لتلك الصور.
ما سيحدث، لاحقاً، هو أني سأكتشف الشاطئ وأدلف إلى ماء البحر، المتاخم للرمال لا أبعد، بعد سفرة أولى في قطار. كان ذلك في صيف سنتي الثانية عشرة. ففي ذلك الفصل، جاء لزيارتنا بمدينة اليوسفية - التي يشتغل أغلب سكّانها في مناجم الفوسفات - ابن خالة لوالدي هو سيد أحمد - وهو أيضاً صهر عمّ لي ساكن بالرباط، وقال إنه سيقصد هذه المدينة في اليوم الموالي لزيارة ابنته وزوجها (عمّي الكبير) وأفراد آخرين من العائلة. كان سيد أحمد ذاك إنساناً مرحاً وطيباً، وسيعمّر طويلًا طويلاً، ويبقى صلب البنيان، وبحسّه المرح سيكرّر لسائليه، كلّما سألوه عن سنّه الحقيقية: "ممكن أبونا آدم يكون أكبر مني بشهرين أو ثلاثة!". المهم أنني، خلال ذلك الصيف المذكور، ركبت القطار أخيرًا من اليوسفية، متوجهًا إلى الرباط برفقة سيد أحمد، وفي الرباط كان الشاطئ بانتظاري، إضافة إلى كتب، ببيت عمّي الصغير، كانت تنقلني إلى عوالم فيها حروب وأبطال وسَحَرة وعيّارون وعشّاق، وربما جنّ أيضاً! لقد كانت تلك الكتب تحمل عناوين مثل: "سيف بن ذي يزن"، "سيرة الأميرة ذات الهِمّة"، "الزّير سالم".
ستتلو تلك المرة الأولى مرات ومرات. وقد تكوّنت لدي عادة القراءة في القطار. فقد قرأتُ - كلياً أو جزئيًا - العديد من الكتب على الإيقاع الرتيب، المعدني، لدوران عجلات الحديد على السكة. من بين تلك المقروءات، أذكر: "الدكتور جيفاغو"، "قلب الظّلام" لجوزيف كونراد، وبعض روايات جورج سيمنون، والعديد من الروايات التي تكون قطارات مسرحاً لأحداثها أو مذكورة في عناوينها (أذكر من بينها: "قطار الشرق السريع" لغراهام غرين، و"القطار الأزرق" لأغاثا كريستي)، من دون أنْ أنسى شعر بليز سَنْدرَارْ عن القطار عابرِ سيبيريا.
اقرأ أيضًا: وكانت قفزة العمة أسرع
أكثر من ذلك، فقد بدا لي، وأنا في بدايات الشباب، أني حقاً وجدت لرواية أغاثا كريستي "جريمة في قطار الشرق السّريع"، نكهة مختلفة حين قرأت منها قسماً كبيرًا في مقصورة بأحد القطارات. وبالفعل، ففيما كان القطار واقفاً بي في محطة الدار البيضاء وأنا أقرأ، كان هيركُولْ پْوَارُو، بطل التحريات لدى أغاثا كريستي، يتهيّأ للسفر من محطة حلب صوب إسطنبول، ثمّ يستقلّ القطار ليعود إلى لندن، وفي أثناء تلك العودة، تحدث الجريمة!
*******
لطالما أثارتني تسمية: "سريع الشرق" أو "إكسبريس الشرق"، وبدت لي موحية، في الآن نفسه، بعبق الشرق وسحره، من جهة، وبعالم الصناعات الغربي بأسراره التي لا يزال القسط الأوفر منها مستعصياً على عالمنا الثالث. ومن "أبحاثي" في هذا الشأن، علقت بذهني بضعة أمور، منها: أن "سريع الشرق" الأول أنشئ في 1883، وأنه، بعد أن انتهى زمن خدمة "سريع الشرق" الأول ذاك، أصبحت هنالك كوكبة من القطارات يشكّل تعبير "سريع الشرق" قسماً من اسم كل منها، مثلما ترسخت في ذاكرتي - وهل يمكن إلا أن تترسخ - هذه الحادثة المثيرة التي وقعت في يوم الخميس 6 سبتمبر/ أيلول 1984 بداخل قطار "فنيتسيا سِمْبلُونْ ـ سريع الشرق" (يا للاسم المعقد): فحين آنت لحظة إقلاع هذا القطار من محطة إنْسبورك (بالنمسا) حيث كان قد توقف، فوجئ الميكانيكيون بعدم تمكّنهم من جعل الكوابح تنفك، الأمر الذي بقي معه القطار جاثماً في مكانه! وبدأ المراقبون والميكانيكيون تحريّاتهم، وانتقلوا من عربة إلى أخرى، وفحصوا العجلات، وأخيراً، اكتشفوا لغز استماتة الكوابح في إيقاف القطار: فقد كان هنالك زوجان في آخر العربات، لم يستطيعا التحكم في صبوة ألمّت بهما، فأطلقا العنان لجسديهما اللذين اندمجا في نشاط غرامي لا هوادة فيه، الأمر الذي نتج عنه علوق مقبض جهاز الإنذار بإحدى قدمي السيدة، ما أدّى إلى تشغيل مكبح الإغاثة. وهكذا، سيصل الركاب إلى مقاصدهم متأخرين، ضاحكين، ومن فرط حس الفكاهة الذي استبدّ بهم أطلقوا على القطار، عوض "إكسبريس الشّرق"، تسمية: "سكس - بريس الشّرق"!
اقرأ أيضًا: فتيات نحيلات
*******
ذكرى: في صيف 2010، كنت من بين المدعوين إلى مهرجان "أصوات حية من متوسط إلى متوسط" الذي يقام بمدينة سِيتْ بالجنوب الفرنسي. ولأني كنت سأتوجه من مرسيليا إلى سِيتْ، فإن إدارة المهرجان حجزت لي مقعدًا في القطار إلى جانب مقعدي مشاركتين في الأنشطة الشعرية بالمهرجان المذكور، إحداهما شاعرة من الكيبيك، والأخرى فرنسية. وكنت أنا، قبل تسعة أيام تحديداً من يوم رحلتنا المشتركة تلك، قد توقفت عن التدخين، بعد أن أنذرني طبيب القلب والشرايين بوخيم العواقب إن لم أفعل. في طريقنا، كانت كل من السيدتين تتشكّى من التأثير الضار للتدخين على صحتها، وقالت الشاعرة الكيبيكية إنها تنوي تجريب السيجارة الإلكترونية، وتكلّمت أنا فقلت إنه ليس هنالك ما هو أسهل من الانقطاع عن تلك العادة، وأضفت أنني دخنت لما لا يقل عن خمس وثلاثين سنة، "وها أنا الآن، قلت بنبرة فيها بعض الزهو، قد انقطعت واسترحت!". وقالت السيدة الفرنسية: "سأقتدي بك وأشحذ عزيمتي". لكني ما إن وصلت إلى سِيتْ، والتقيت بمعارف وأصدقاء من الشعراء وغير الشعراء، حتى عدت إلى التدخين. وكثيرا ما كنت أجلس في رفقة الشاعر الإماراتي المرحوم أحمد راشد ثاني، وننصرف إلى التدخين وعبّ الفودكا! وهكذا، أصبحت تلك السيدة الفرنسية، كلما رأتني وأنا منصرف إلى نشاطي ذاك، تأتي وتسدي إلي النصائح، وتطلب مني أن أرعوي فأدخن إن شئت، ولكن من دون إفراط!
*******
وحتى اليوم، كثيراً ما أذكر، حين أمرّ أمام محطة قطار، قولة بول موران Paul Morand التالية: "الفوائد المرتجاة من ورقة يانصيب هي أقلّ من تلك المتوقعة من تذكرة قطار"!