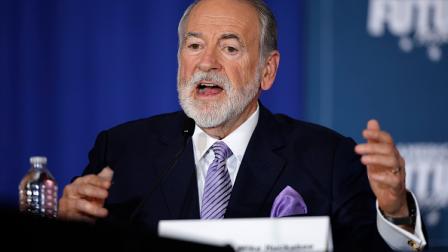أول صورة تتداعى إلى الذاكرة من سجن تدمر هي قصة الرجل الذي ألقموه فأراً، التي رواها الشاعر فرج بيرقدار عن تجربة اعتقاله، وكذلك قوقعة مصطفى خليفة، ومعها تجربة محمد سليم حماد "تدمر.. شاهد ومشهود" وعشرات الصور الأخرى من سجون سورية، كتجربة عماد شيحة، وهو المراهق الذي اشترك بتفجير فندق سميراميس أواخر سبعينيات القرن الماضي مع المنظمة الشيوعية العربية ونجا من الإعدام الذي طاول رفاقه، وانتهاء بآخر رواية تروي جانبا من حياة السجن ويومياته وهي رواية "ما وراء هذه الجدران" لراتب شعبو.
كثيرة هي القصص التي كتبت عن سجن تدمر والسجون السورية الأخرى، أهمها كتبه معتقلون سابقون، بعثيون وشيوعيون وإسلاميون، سوريون ولبنانيون وفلسطينيون وأردنيون.
فقد مدت فظاعات سجن تدمر وغيره من المعتقلات الأدب السوري بعشرات الروايات والمجموعات القصصية ودواوين الشعر، فضلاً عن كتب السيرة الشخصية ولقد أحصيت أكثر من عشرين تجربة كتبها أصحابها عن معاناتهم ومشاهداتهم من داخل سجن تدمر وبقية السجون السورية.
قصة محمد برو واحدة من تلك القصص الكثيرة التي يتغير فيها مصير أفرادها من دون ذنب ارتكبوه.
كان الفتى محمد برو يحضّر لامتحانات الشهادة الثانوية في مدينته حلب، ولم يبق إلا شهر واحد يفصله عن اجتياز هذه المرحلة إلى الجامعة، ولكن الأمن السوري دهم بيته في حي الميدان، الساعة الثالثة فجراً بخمس سيارات ليعتقلوا فتى أعزل لم يبلغ 17 عاماً بجريمة قراءة نشرة النذير التي كانت توزع خلسة من قبل الطليعة المقاتلة، وهو تنظيم انشق عن الأخوان المسلمين وبدأ بالخروج المسلح على النظام، وارتكب ما يعرف بمجزرة المدفعية. كان هذا في الأول من أيار، عيد العمال، من عام 1980.
نقل الفتى من سجن حلب المركزي إلى سجن تدمر الرهيب ونجا من الموت، لأن رئيس فرع الأمن غازي كنعان الذي كان يترأس المحكمة العسكرية لم "يتجاهل صغر سني ولم يتركني أعدم شأني شأن أصدقائي السبعة الذين يكبرونني بستة أشهر، أمسك بي من أذني وسحبني قائلا هذا ابن القحـ.... لا يعدم، لم يبلغ الثامنة عشرة بعد. خفف حكمي إلى عشر سنوات، ولكنني بقيت 12 سنة وخرجت في الشهر الأول من عام 1993".
هنا جزء من ذاكرة سجين قضى اثني عشر عاماً بتهمة قراءة منشور لجماعة، كل من يعرفهم أعدموا، ونجا من الإعدام، لأنه كان تحت 18.
هنا جزء من سيرة طويلة للمعتقل محمد برو:
تتعالى الصيحات في ردهات السجن المركزي في حلب، والسجن بأروقته الأسمنتية الصماء يردد الصدى قبيحاً مرعباً كصوت غراب ينذر بكل قميء وسيئ.
يتقافز الحراس مع آمر السجن يفتحون الأبواب الحديدية لأسيادهم القادمين (عناصر الأمن وسرايا الدفاع وضباط من القصر الجمهوري): استيقظوا أيها الحقراء، أيها المجرمون، اليوم، سنسوقكم إلى الذبح. 
تدخل عناصر السرايا وهي تضرب الأبواب الحديدية السوداء بأخمص البنادق وصوت الأحذية العسكرية يختلط بأصوات أصحابها وعشرات الكابلات الرباعية والجنازير تخلق حالة من الهلع والرعب وتستدعي إلى الذاكرة الرطبة قصصاً كنا نتداولها همساً عن مصير سجناء تدمر، الذين نفذت فيهم أبشع مجزرة في تاريخ سورية، عندما دخلت قوات من سرايا الدفاع بتكليف من رفعت الأسد وقتلت كل من كان في سجن تدمر. يبدأ السجانون بقراءة أسماء من سيخرج هذه الليلة من هذا السجن إلى مصير مجهول وسط سيل هادر من الشتائم والركلات والضرب المبرح. 
نساق إلى الساحة الداخلية، حيث يتم تقييدنا بحبل متين من القنب الخشن الذي يدمي المعصمين بسبب الضغط بالحبال إلى أقصى درجة، يحتبس الدم في الكفين اللتين ما تلبثان أن تتورما ثم تبدآن بالتشقق ويصبح التحام الأظافر بالأصابع واهياً ونازفاً.
وبعد تقييدنا، اليدين إلى خلف الظهر، يتم ربط كل اثنين معاً فيصبحا زوجاً من الحمولة الجاهزة للشحن من دون أن يكون لديهما أدنى هامش للحركة، فهو قيد إلى قيد إلى قيد ثالث يثبتهما معاً في مقعدهما من الحافلة العسكرية التي ستكون ضمن قافلة طويلة وبطيئة تسير بهم من حلب إلى صحراء تدمر في رحلة ستمتد من الثانية بعد منتصف الليل إلى الساعة الثامنة صباحاً تتخللها موجات غير منتظمة من التعذيب المزاجي.
تتعالى، فجأة، أصوات متوترة خائفة، الحراس يجرون في كل اتجاه، لقد استطاع أحمد حباب، معتقل حلبي في العشرين من العمر، ضرب عنصر السرايا الذي ينهال عليه ضرباً وخطف سلاحه الخالي من الذخيرة الحية، فر الجميع أمامه وتركوه كنمر نازف في الرواق المقفل إلى حين استعادوا صوابهم وذخروا أسلحتهم وأردوه برشقة من الرصاص ونقل ميتاً إلى مشفى الرازي بوسط مدينة حلب.
انتهوا من تقييدنا وكان عددنا قرابة مائة وخمس وأربعين معتقلاً بين طفل في السادسة عشرة وطاعن في السن قارب السبعين.
كانت القافلة مكونة من ثلاثة باصات ومجموعة من سيارات الحماية المرافقة وقد وضع في مؤخرة كل باص صفيحة من الوقود وصندوق من أصابع الديناميت وكانت الأوامر للجنود عند سماع أي طلقة تسكبون البنزين عليهم، وتنشرون أصابع الديناميت وتشعلون الباص بمن فيه وتخرجون بسرعة.
اقرأ أيضاً: "داعش" يطمس جرائم النظام السوري بتفجير سجن تدمر
تدمر يا تدمر
أخيراً دخلنا مدينة صغيرة لمحنا ونحن مقبلون إليها بعضاً من أشجار النخل وأبنية عتيقة ترابية اللون وشمساً تغرق المدينة في ضوئها الصباحي. كانت الساعة الثامنة صباحاً وصوت مكبس قرميد ينتهك صمت المدينة الغافية. سيبقى هذا الصوت مصاحباً لنا طيلة السنوات التي سنمضيها في هذا المعتقل، نسمعه من الصباح إلى المساء، وكان صمته إعلاناً عن انتهاء النهار، حاملاً معه بعضاً من الأمان، حين ينتهي الجلادون من مهامهم اليومية في التعذيب.
لكن هذا الأمان نادراً ما كان يكتمل إلى الصباح إذ إن المشرفين على تعذيبنا كثيراً ما يفاجئوننا بحفلات ليلية من التعذيب.
توقفت الحافلات أمام باب ضيق لا يتعدى عرضه متراً واحداً يقف أمامه صفان من الجلادين يرتدون بزة الشرطة العسكرية وهي الجهة المخولة بالإشراف على السجون، وهم يتبعون للعقيد شمس مدير السجون في سورية، صفان من الجلادين ضخام البنية قسماتهم قُدّت من بازلت أسود يحملون بأيديهم الكابلات والكرابيج الغليظة اصطفوا مع قائدهم العقيد فيصل غانم وشقيقه تميم، ليستقبلوا هذا الجمع الغفير من المعتقلين الذين سيكونون في ضيافتهم لأعوام، لا أحد، يعرف متى تنتهي.
من بين تلك الوجوه اللئيمة، لست أنسى ذلك الوجه الحزين الذي كان ينظر إلينا بأسى ونحن نساق إلى هذا النفق الرهيب، كان عنصرا من سرايا الدفاع، عرفت أن اسمه أحمد حبيب، ولاحقا أعدم لتعاطفه مع المسجونين.
كغيري، جريت مع صاحبي محاولاً تفادي ما أمكن من الضربات التي تنهال علينا إلى أن وصلنا الجدار الذي اصطف عليه من سبقنا في النزول ورائحة الدم من أنوفنا وأسناننا تفوح، مع ذلك يتقدم الجلادون ليفكوا قيودنا ويأمروننا بخلع ملابسنا وينهالون بالضرب العشوائي وإيقاظ من يغمى عليهم بجرادل الماء أو بمزيد من الركلات.
كان على يميني صديقي عيسى الذي أعدم بعد شهرين لكتمه معلومات عن شقيقه صلاح الذي أعدم أيضاً، وطالما كنا نحسده على هذا الخلاص العاجل مما هو شر من ألف ميتة، وعلى شمالي صديقي خلدون وهو شاب لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر، وكان رياضي البنية، الأمر الذي أغضب جلاديه، فأسرفوا في ضربه وتعذيبه وتكرر إغماؤه وتكرر إيقاظه من الإغماء، إلا أنهم في المرة الخامسة لم ينجحوا في إيقاظه، الأمر الذي استدعى حضور الطبيب الموجود في ساحة التعذيب، وتم فحصه، فوجده قد مات.
أشار العقيد فيصل غانم إلى أن يتم تنظيم ضبط بالوفاة ويتم دفنه في حفرة قريبة، وقبل أن يغادر، وكأنما هناك إجراء بروتوكولي سقط سهوا، صرخ من قتله؟ تقدم أحد العرفاء، صرخ العقيد بغضب مصطنع "قسماً بشرفي إذا عدت لمثل هذه البياخة سأحلق لك شعرك! انقلع".
بعدها بدأت حفلة الدواليب، حيث يجتمع ثمانية جلادين حول كل دولاب فيحشر أحدنا في الدولاب ويطوى جسده، فيصبح رأسه ملاصقا لركبتيه، وتمتد يداه لتلامس ظاهر قدميه وتنهال عليه السياط والكابلات، ويعلو صراخه ممزقاً هدوء المدينة التي كانت تتعذب بصراخنا كل صباح وكل مساء، كما سيحدثنا أحد سكان مدينة تدمر. 
وأخيراً، نؤمر بالولوج إلى غرفة إسمنتية رمادية، جدرانها فيها بقع حفرتها الطلقات والقنابل التي قتل فيها أسلافنا منذ أسابيع فقط، وما زالت دمائهم تصبغ جدران المهجع وأسقف حجراته.
في نهاية المهجع، هناك حجيرتا خلاء من دون باب، وفي ركن إحداهما صحن بلاستيكي فيه لتر من الماء القذر القديم تلقفها أحدنا وشرب قليلا، وناولني ففعلت مثله، وناولتها لمن خلفي إلى أن انتهت، وإلى اليوم لا أستطيع الجزم بحقيقة ما شربت، فهو مزيج هلامي من مخلفات معدنية ونباتية وإنسانية أيضاً.
نمنا تلك الليلة من دون أن يحضروا لنا طعاما أو ماء أو حتى فراشا فقد نمنا من سطوة الألم وذهول الأرواح. دخل أحد الرقباء برفقة مجموعة من الجلادين ووجه كلامه إلى الحاضرين: "ولا حقراء مين منكم كان بيخدم عسكرية؟".
تقدم عدنان وكان رقيباً في الخدمة الإلزامية وله لحية، أبلغه الرقيب بعد أن صفعه أنه سيكون رئيسا للمهجع، وأن عليه حلق لحيته اليوم، ثم أمر بإدخال الطعام، وهو عبارة عن وعاءين كبيرين تسبح في أحدهما بضعة لترات من الشاي الموشح بالدسم، كل عشرة أشخاص ينالون نصف كوب، وفي الآخر حفنة من حبات الزيتون حصة كل واحد سبع حبات منها، ولم يكن هناك خبز. 
وخرجنا للتنفس، الواحد آثر الاخر، نعرج على أقدام مسلوخة، بقي من أظافر قدميّ ظفر الإبهام في اليسرى، وسرعان ما التهب وأصبح ألمه يمنعني النوم لليال عدة، أما باقي الأظفار فقد آثرت البقاء في ساحة التعذيب الأولى.
كنت أجلس إلى مجموعة تصدرها رجل طويل القامة، هادئ، عركته السنون، إنه فاضل معقدة عالم الجيولوجيا الذي أعدموه، لأنهم وجدوا اسمه في قوائم "الأخوان" في مطلع الستينيات عندما كانت "الأخوان" جزءاً من البرلمان السوري، ثم سافر إلى التشيك ليتم أبحاثه في الجيولوجيا، وعزف عن كل ما يمت للسياسة بصلة.
اقرأ أيضاً: "داعش" يفجّر سجن تدمر أبرز معالم وحشية نظام الأسد